كان طالب العلم في الزمن الأول يختار شيوخه في كل علم، ينتقي أعلمهم، وأشهرهم فيه، ليضرب أكباد الإبل راكبا إليه، أو يمشي على قدميه راحلا إلى بلده، ليأخذ عنه، وينهل من معينه، وهو لا يكتفي بشيخ واحد في كل علم، بل يجتهد أن يأخذ عن أكثر من شيخ، يأخذ من كل أفضل ما عنده. ويباهي كل واحد منهم بكثرة شيوخه من جهة الكم، وبفضلهم وامتيازهم من جهة الكيف.
وحين نقرأ ترجمة واحد منهم في كتب الطبقات والتراجم، نعجب لهذا العدد من الشيوخ الذين تلقى عنهم من أكثر من بلد، وفي أكثر من زمن، وفي أكثر من فن، وأكثرهم من العلماء الأفذاذ، والأئمة النابغين في فنونهم. ذاك زمان مضى، أما زماننا فلم يعد الطالب هو الذي يختار شيخه في أي علم من العلوم أو فن من الفنون. فالإدارة المسؤولة هي التي توزع الأساتذة والمعلمين المعينين عندها على فصول الطلاب، وكل طالب وحظه.
كما أن النوعية المتفوقة والرفيعة المستوى التي بلغت الإمامة في تخصصها، لم يعد لها وجود اليوم، بعد تراجع الحضارة الإسلامية، وإغلاق باب الاجتهاد في الفقه، والإبداع في الأدب، والتجديد في الدين، وبعد أن أصبح المثل السائر: ما ترك الأول للآخر شيئا، وليس في الإمكان أبدع مما كان. ومن وجد من شيوخ العلم الذين يلمعون في سماء العلم، كما يلمع سنا البرق الذي يأخذ بالأبصار، فهذا ليس هو القاعدة، بل الشذوذ الذي يثبت القاعدة.
لذا كان معظم أساتذتي في المرحلة الثانوية رجالا فضلاء طيبين تقليديين، لم يستطع أكثرهم أن يترك في نفسي أثرا ملموسا، أو موقفا علميا أو عمليا أذكره به، ولا غرو أن نسيت أسماءهم إلا القليل، رحم الله الجميع وغفر لهم.
وقد كان كثير منهم يصرح بأن أكبر همه هو الراتب، وأذكر أن واحدا منهم كان مغضوبا عليه، وقد نقل من القاهرة إلى طنطا، فسألناه: ألا يغضبك هذا؟ فقال بصراحة: أنا لا يهمني إلا راتبي، لو نقصوني جنيها واحدا أو أقل، لقاتلت شيخ الأزهر من أجله.
وكانت هذه الروح المادية والنفعية من آفات التعليم الحديث، أن غدا أستاذ الأزهر يعمل بروح الموظف الذي ينتظر الراتب ويعمل بقدره، لا بروح صاحب الدعوة، الذي يحتسب عمله لله، وينتظر الأجر من الله، ويعتبر أن عمله قربة إلى الله وأنه عبادة وجهاد في سبيل الله.
وكان يدرسني في السنة الخامسة الفقه الحنفي مدرس كفء وإن كان مكفوف البصر، هو الشيخ محمود الدفتار، وهو من آل الدفتار، وهم أسرة معروفة بالانتساب إلى المذهب الحنفي، والاعتزاز به، فأحدهم يقال له: أبو حنيفة، والثاني: أبو يوسف، والثالث: محمد.
كما كان لهم نزعة صوفية ظاهرة تتمثل في الاعتقاد في الأولياء، والمبالغة في إثبات كراماتهم وخوارقهم، وقد كان الذي يدرسنا مادة (العروض والقافية) في السنة الأولى الثانوية، هو الشيخ أمين الدفتار، وكان يختار أمثلته من شعر الصوفية الذي ينزع هذا المنزع، فهو يمثل لنا عن بحر (الكامل) بقول الشاعر:
لذ بالمقام الأحمدي وقل: مدد ** يا سيد الأقطاب يا نعم السند!
وكان لا يقبل أي مناقشة حول هذه القضية، وكان يذهب كل ليلة ليجلس في مقام السيد ما بين المغرب والعشاء، لا يكاد ينقطع عن ذلك إلا لسبب.
وكذلك كان الشيخ محمود من أحباب السيد البدوي والمدافعين عنه، وقد اجترأت مرة فناقشته في أن الأضرحة التي تقام للأولياء ويدفنون فيها، ليست على منهج السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، والصلاة عليها، كما نهى عن إضاءتها وإيقاد السرج عليها، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ودخلت مع الشيخ في مناقشة، وقال لي: أيهما أولى: أن تصلي قرب الميضأة أم تصلي بجوار الضريح؟ قلت له بصريح العبارة: أن أصلي قرب الميضأة. فنهرني بشدة، وقال: أنت وهابي تبغض الأولياء. قلت له: أنا أقول ما درسته في هذا المعهد في (صفوة صحيح البخاري). فأسكتني وأغلق المناقشة.
وفي مرة أخرى، كان الشيخ يشرح لنا (باب الأضحية) في الفقه، وما لها من فضل أغفله أكثر الناس، أو قلت قدرتهم عن القيام به. وهنا تدخلت وقلت له: يا فضيلة الشيخ، إن كثيرا من الناس يذبحون بالفعل، ولكنهم يذبحون للبدعة، ولا يذبحون للسنة. قال لي: كيف يذبحون للبدعة؟ قلت: عندنا في قريتنا وفي غيرها من القرى أناس كثيرون ينذرون خرافهم لتذبح في مولد السيد، وهذه بدعة، ولا يذبحون يوم عيد الأضحى، وهي سنة، ولو أن العلماء قاموا بواجبهم، ونبهوا الناس على ذلك، لأحيينا السنة وأمتنا البدعة. فغضب الشيخ، وقال لي: اخرج من الفصل.
وحاولت بعدها أن أعتذر إلى الشيخ ليرضى عني ويدخلني الحصة، وقد كان، وإن لم يطل الأمر كثيرا، فقد وقع حل جماعة الإخوان في 8 ديسمبر 1949 وبعدها توترت الأوضاع، وحمي الوطيس، وقبض عليّ، ورحلت إلى الطور، في قصة طويلة، سأعرض لها في موضعها. وقد أراح القدر الشيخ الدفتار من هذا الطالب المشاكس الذي لا يكف عن المناقشة والسؤال.
الشيخ الشعراوي درسني.. في البدء التحدي ثم الصداقة والاحترام
وأهم من درسني في المرحلة الثانوية، هو: الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقد كان في تلك الفترة من حياته معروفا بالشعر والأدب، ولم يكن معروفا بالدعوة الدينية. وكان للشعراء مجال يبرزون فيه ويتنافسون، ويظهر كل منهم أنفس ما عنده من جواهر، وذلك في مناسبة الاحتفال بالهجرة النبوية أول محرم من كل عام. ويتبارى فيه الخطباء والشعراء من الأساتذة ومن الطلاب.
وكان نجم الشعر المتألق في معهد طنطا هو الشيخ إبراهيم بديوي، الذي سمي (شاعر المعهد) والذي كان له في كل مناسبة قصيدة جديدة. ولكن في سنتين ظهر في كل منهما نجم آخر، غطى على نجومية البديوي. أحدهما كان الشيخ محمد خليفة الذي كانت له قصيدة سحرت الجمهور، وأخذت بلبه، وكانت مكونة من مائة بيت من بحر المتقارب، كل عشرة من قافيتين، وعندما ينتهي الأبيات العشرة في نفس واحد، يمتلئ السرادق بالتصفيق والإعجاب، وأذكر من هذه القصيدة مناجاة الشاعر لهلال المحرم، والحرب العالمية الثانية على أشدها مستعرة الأوار:
هلال المحرم هل من نبا؟ ** وهل شمت في الجو طيف السلام
ومنها:
وجـود تفرق أيدي سبا ** وفوضى تحير عنها النظام
إذا صاح بالسم داع أبى ** إذن يا سلام عـليك السلام
وفي موسم آخر ظهرن نجم آخر، هو نجم الشيخ الشعراوي، الذي ألقى قصيدة رائية من بحر الخفيف، شدت إليها الحاضرين، واستحوذت على قلوبهم، وتجاوب معها الشيوخ والطلاب. نسيت مطلعها، ولكن مما جاء فيها عن سيدنا أبي بكر:
وكفاه على الفخار دليلا (ثاني اثنين إذ هما في الغار)
وختمها الشاعر ببيت من عيون الحكمة، يقول:
كل دنيا تبنى على غير دين فبناء على شفير هار!
جاء الشيخ الشعراوي إلى معهد طنطا الثانوي، وأنا في القسم الابتدائي، واستمر يدرس فيه (علم البلاغة) لطلاب الثانوي، إلى أن وصلت إلى السنة الرابعة الثانوية، التي يدرس فيها الشيخ البلاغة من كتاب (تهذيب السعد) قسم (علم المعاني).
وكان الشيخ الشعراوي مدرسا ناجحا تماما، متمكنا من مادته، حسن التعبير عن مراده، محترما من الطلاب، قادرا على ضبط الفصل، يتحرك يمنة ويسرة أثناء شرحه، أشبه ما يكون بطريقته في دروس التفسير التي شهدها الناس منه في حلقات (التلفزة). ولم يكن الشيخ الشعراوي قد عرف بالدعوة الدينية في ذلك الوقت، كل ما عرف به هو الشعر.
وكان الشيخ الشعراوي من الناحية السياسية محسوبا على حزب الوفد، ومعدودا من رجاله، ولكنه ـ والحق يقال ـ لم يكن من الحزبيين المتفلتين، فقد كان رجلا ملتزما بشعائر الدين، محافظا على الصلوات في أوقاتها، هو وزميله وصديقه الذي كان يدرسنا (تاريخ الأدب العربي) الشيخ المنوفي.
وكان حزب الوفد في هذه المرحلة في تنافس شديد، وصراع حار، مع جماعة الإخوان، فكلاهما يريد أن يكسب الشارع المصري إلى صفه، وبعد أن كان الوفد هو المسيطر على الشارع وهو الذي يحرك الرأي العام إذا أراد، أصبح له في الميدان منافس قوي شديد البأس، يقود الجماهير باسم الإسلام، ويكسب كل يوم منه أرضا جديدة، ويخسر الوفد جزءا من جمهوره التقليدي.
وهذا الصراع انعكس على طلاب الوفد وطلاب الإخوان في المعاهد والمدارس والجامعات، وكان الإخوان أقوى صوتا، وأشد تأثيرا، بمن لهم من ممثلين أقوياء، مثل مصطفى مؤمن زعيم طلاب جامعة القاهرة، أو قل: زعيم طلبة مصر كلها، والخطيب السياسي الجماهيري الذي يسحر الألباب.
ويبدو من سياق الأحداث أن الشيخ الشعراوي قد شحن من قبل بعض المشايخ والطلبة الوفديين في المعهد، ضد طلاب الإخوان، وأنهم حذروه منهم، وأنهم قد يشغبون عليه في درسه أو نحو ذلك.
ومن دلائل ذلك: أني سألت الشيخ أثناء درسه في البلاغة سؤالا علميا بريئا، كما أفعل مع كل أساتذتي، فأنا بطبيعتي أحب أن أفهم، وأحب أن أناقش، ولا آخذ كل شيء قضية مسلَّمة، ولكن الشيخ الشعراوي اعتبر السؤال تحديا له، واستشاط غضبا، ظهر على صفحات وجهه، وقال لي يرد علي التحدي ـ في نظره ـ بتحد مثله أو أقوى منه: اسمع يا يوسف، إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا!! فقلت له: والله ما قصدت غير السؤال العلمي البحت، ولم يتجه تفكيري إلى ما فهمته قط.
وكان هو السؤال الأول والأخير، فلم أحاول أن أسأله بعد ذلك، حتى لا يسيء فهمي. ومضت السنة الدراسية، وجاء الامتحان، وكان من نزاهة الشعراوي أن منحني أعلى درجة في الفصل.
وفي السنة التالية ـ الخامسة الثانوية ـ كان حل الإخوان، واعتقالي، ثم ذهابي إلى كلية أصول الدين، ولم ألق الشيخ الشعراوي وجها لوجه إلا بعد سنين، بعد أن أعرت إلى قطر، ولقيت الشيخ مصادفة، فقد ذهبت إلى موقف طنطا لأركب الأوتوبيس الذاهب إلى زفتى، فإذا الشيخ ينزل من نفس الأوتوبيس، فتلاقينا، وبادرني بالمصافحة والعناق بحرارة، وقال: أنا متتبع أخبارك، ومسرور بنشاطك العلمي والدعوي، وسألني عن زميلي: أحمد العسال، ودعا لنا بخير.
ثم تلاقينا بعد ذلك في مناسبات شتى، قد يأتي الحديث عن بعضها، آخرها حين اختارت لجنة دبي الدولية للقرآن الكريم الشيخ الشعراوي أول شخصية إسلامية تكرمها، وكلمني رئيس الجائزة وعدد من أعضائها يدعونني لحضور حفل تكريم الشيخ بصفته شخصية سنة 1418هـ ـ 1997م، فرحبت بالدعوة، وقلت لهم: إن للشيخ الشعراوي حقا عليّ، ويسرني أن أسهم في تكريمه.
والحق أن الشيخ رحمه الله سُرَّ سرورا بالغا بحضوري ومشاركتي، وذكرته بقصيدته القديمة التي ألقاها في حفل المعهد بمناسبة الهجرة النبوية، والتي ختمها ببيته الشهير: كل دنيا تبنى على غير دين ** فبناء على شفير هار!
فقال لي: إن الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله ـ العالم المحقق المعروف ـ قال لي: إن هذا البيت، هو بيت القصيد في هذه القصيدة. وذكر لي ما فهمت منه أن بعض شيوخ الوفد الأزهريين كانوا قد حذروه من طلبة الإخوان، ولكنه وجدهم على غير ما ظنوه.
وقد كانت مناسبة لأتحدث عن فضل الشيخ الشعراوي ودوره في تفسير القرآن، وفي تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة، وفي الوقوف في وجه التيارات الهدامة، وإن لم يكن معصوما، فكل بشر يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم.



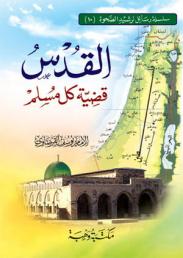 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






