أمنية لم تتحقق لزيارة باكستان الشرقية:
لم يقدر لي أن أزور «بنجلاديش» حينما كانت تمثل جزءًا من جمهورية باكستان الإسلامية الكبرى، وكان اسمها في ذلك الوقت «باكستان الشرقية». وباكستان القائمة اليوم، كان اسمها باكستان الغربية.
وحين زرت باكستان لأول مرة سنة 1969م، أقمت نحو ثلاثة أسابيع في مدينة لاهور، التي يعدونها العاصمة الثقافية لباكستان، كما أن كراتشي العاصمة التجارية.
وكان الإمام المودودي لا يزال حيًا - وإن كان قد ترك إمارة الجماعة الإسلامية لرفيقه الأستاذ طفيل محمد - يود لو زرت في ذلك الوقت مدينة «دكا» عاصمة باكستان الشرقية، فقد بدت بوادر الانشقاق، ونذر التذمر والرغبة في الانفصال لدى كثيرين من أبناء البنغال أهل باكستان الشرقية، واستغل ذلك الزعماء الطامعون في الرياسة، مثل مجيب الرحمن رئيس حزب الشعب وغيره.
وكانت حجة الانفصاليين: أن الذي يحكم باكستان هم أهل باكستان الغربية، وبخاصة العنصر البنجابي، وأن باكستان الشرقية مهمشة.
وكان بعض ما يقولونه حقًا، ولا يمكن أن تستمر وحدة بين بلدين أو إقليمين، يشعر أحدهما بأنه مظلوم، وأن شريكه ظالمه، وأن للظالم التمر، وله النوى! إن إقامة العدل هي الكفيلة بمقاومة النَّزعات الإقليمية والانفصالية، التي عانت منها الدولة الإسلامية الكبرى ما عانت، وكانت سبب ضعفها، واستيلاء الآخرين من الصليبيين والتتار عليها.
كان بعض البنغاليين يقولون إنه ليس بيننا وبين باكستان الغربية إلا أمران: شهادة أن لا إله إلا الله، وخطوط الطيران الباكستاني! وكان بعض الظلم الذي وقع على أهل البنغال قديمًا من زمن الاستعمار البريطاني، وورثته باكستان في عهد الاستقلال، ولكن كان عليها أن تبذل جهدًا أكبر في النهوض بالإقليم الشرقي من البلاد، وأن تتعهده بالتنمية والتطوير، حتى يتساوى مع الإقليم الآخر، أو على الأقل يقترب منه، ولا يظل في غاية التخلف.
على كل حال، لم تتحقق أمنية الأستاذ المودودي في زيارتي لباكستان الشرقية، ولكنه شوَّقني إليها حينما قال لي: إنها جنة الله في أرضه، وإن أنهارها كأنها بحار.
دعوة من الشيخ محمد يونس:
ثم شاء الله أن يعقد المؤتمر العالمي الثالث للسنة والسيرة في قطر، ويحضره وفود وممثلون من العلماء من أقطار شتى، وكان من هؤلاء: الشيخ الفاضل محمد يونس عبد الجبار رئيس جامعة «فُتيا» الإسلامية، في شيتا غونغ بجمهورية بنجلاديش.
وقد تعرف الشيخ علي، وتعرفت عليه في المؤتمر، ورجاني أن أزور جامعتهم، وألتقي شيوخها وطلابها، ففيها أكثر من ألفي طالب، وهي جامعة دينية تدرس العلوم الشرعية، واللغة العربية، على طريقة علماء ديوبند، وستسرّ بزيارتها، كما ستسرّ أسرة الجامعة شيوخًا وتلاميذ بزيارتك.
قلت للشيخ يونس: إني ليسرني زيارتكم في بنجلاديش، فهذا حقكم علي، وقد زرت بلادًا كثيرة، ولكن لم يقدّر لي أن أزور بلدكم العزيز الشقيق، وعسى أن يتحقق ذلك في أقرب فرصة بتوفيق الله.
قال الشيخ: سنوجه لك دعوة، لتحضر احتفالنا السنوي بتخريج بعض الطلاب.
قلت: على بركة الله.
وبعد فترة قليلة من عودة الشيخ يونس إلى وطنه: جاءتني دعوة لزيارة جامعة فُتيا، في موعد الاحتفال السنوي بتخريج فوج جديد من أبناء الجامعة.
أذكر أن سفري كان عن طريق الهند، ومنها إلى «دكا» عاصمة بنجلاديش، وقد بقيت في دكا يومين، زرت فيها بعض المعاهد الإسلامية، وبعض المدارس الدينية التي تشبه الكتاتيب في بلادنا، وإن وجدتهم يجلسون على الحصير، وقد كنا في الكتاب نجلس على «دكك» خشبية، وقد قدموا إلي صبيًا صغيرًا لم يكد يتم التاسعة من عمره يحفظ القرآن كله حفظًا جيدًا، وقد امتحنته في عدد من المواضع في القرآن الكريم، فوجدته لا يسقط منه حرفًا، وإن كان لا يعرف العربية، وهذا من معجزات هذا الكتاب.
وكان ممن عرف بزيارتي وهرع للقائي: الدكتور فؤاد عبد الحميد الخطيب سفير المملكة العربية السعودية، والحق أنه كان سفير الإسلام في تلك الدولة، وكان في خدمة كل عالم أو داعية يزور بنجلاديش، وقد ظلَّ معي في زياراتي المختلفة، وصحبني بعد ذلك إلى شيتا غونغ، ليسهم في تنظيم محاضرة عامة دعي إليها المثقفون ورجال الصحافة وكل الشخصيات المهمة في الدولة، ثم أقام حفلًا كبيرًا بعد عودتي إلى «دكا» في طريق رجوعي إلى الدوحة: دعا فيه عددًا كبيرًا من الشخصيات البنغالية، ومن السفراء العرب والمسلمين، ومن أساتذة الجامعات، وكبار العلماء، رحمه الله وجزاه خيرًا.
المهم أني بعد إقامتي السريعة في «دكا» حجز الأخوة مندوبو جامعة فُتيا لي للسفر إلى شيتا غونغ على الطيران الداخلي، وفي المطار كان الشيخ يونس وإخوانه مفتي عبد الرحمن وغيره في انتظاري.
كلمة عن بنجلاديش:
كانت هذه أول زيارة لهذا البلد الإسلامي الذي يعدُّ ثالث بلد من ناحية كثرة السكان، بعد إندونيسيا وباكستان، والذي يتميز بكثافة سكانية تعد من أعلى الكثافات السكانية في العالم. فالذي ينظر إلى الخريطة يجد رقعة بنجلاديش؛ رقعة صغيرة ضيقة المساحة، ولكن فيها نحو مائة وعشرين مليونًا وأكثر في ذلك الوقت.
كما أن البلد يعيش أهله - أساسًا - على الزراعة، وكثيرًا ما تصيبهم الفيضانات الهائلة والمتكررة فتتلف محصولاتهم، وكثيرًا ما تهدم عليهم مساكنهم الضعيفة، وهم في حاجة إلى إقامة سدود كبيرة تحجز المياه، وهذه تحتاج إلى مئات الملايين، وهم لا يملكونها فالفقر يؤدي إلى مزيد من الفقر.
ولا يكاد يوجد فيها مصانع إلا مصانع «الجوت» التي زرتها، وهذا الإهمال للصناعة فيها من عهد الإنجليز. وأهل البلد يبدو عليهم الفقر والأمية، وإن كانت بلادًا جميلة جدًا، كما قال الأستاذ المودودي، فهي بساط من الخضرة نسجته يد القدرة الإلهية، وفيها أشجار جوز الهند «النرجيلة» وأشجار الباباي، وغيرها.
ولا تزال هذه البلاد في حاجة إلى مساندة من هيئة الأمم المتحدة، ومن مؤسساتها المتفرعة عنها، ومن الدول الغنية: دول الشمال، والدول الصناعية الكبرى، ومن منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية، وخصوصًا دول الخليج حتى تلتحق - بالتدريج - بركب العالم المتطور.
وقد استغل دعاة التنصير ما يعانيه أهل البلاد من فقر وجهل ومرض، فأنشئوا مؤسساتهم التي تستغل وضعهم المأساوي، لتفتنهم عن دينهم، كما هو شأنهم أبدًا؛ لذا كان من الواجب على الجمعيات والهيئات الخيرية والدعوية الإسلامية أن يهبوا ليقوموا بمهمتهم في الأخذ بيد إخوانهم في بنجلاديش، وإنقاذهم من برائن المنصِّرين.
جامعة فُتيا:
وجامعة فُتيا تقع في قرية من قرى شيتا غونغ، تقع بين المزارع والأرض الخضراء، ولكن لا يوجد فيها فنادق، ولا أماكن صالحة لراحة الضيوف؛ ولذلك أنزلني الأخوة في فندق بعيد نسبيًا عن مكانة الجامعة، وهو فندق متواضع، ولكنه صالح لأن ينام الإنسان فيه في الليل، فأنا طوال النهار في الجامعة، وأنا في هذه الأسفار لا أطلب الرفاهية، بل أطلب الحد الأدنى من مطالب الحياة الأساسية، وهذا يكفيني.
وأنا بحمد الله لست من الذين نشأوا وفي فمهم ملعقة من ذهب، بل نشأت في القرية وتعودت على حياتها الخشنة نسبيًا كما دربت على حياة المعتقلات والسجون، فلا غرو أن أرضى بالفندق الذي أنزلوني فيه، فهو خير قطعًا من السجن الحربي!
وجدت هذه الجامعة تعج بالطلاب الذين يعيش جلهم في مساكنها الداخلية، وهي توفر لهم الطعام والشراب والمسكن والكتب، ومواردها من تبرعات المسلمين، وأحسب أن ثمة أوقافًا وقفت عليها. التقيت شيوخ الجامعة وحدثتهم عن واجبهم العلمي والتربوي، ولا سيما في هذا العصر، الذي وجدتهم في عزلة تامة عنه، فهم يعيشون في الكتب القديمة وحدها لم تهب عليهم نسمة من نسمات زماننا هذا وما فيه من عجائب، وما أثار من مشكلات.
وكذلك حين التقيت الطلاب وجدتهم غائبين تمامًا عن دنيا الناس، لا يعرفون شيئًا عن علوم العصر، وثقافة العصر، وتيارات العصر، ومشكلات العصر؛ ولذلك هم في عزلة كاملة عن المثقفين في أمتهم من خريجي المدارس والجامعات العصرية، وإنما يتعاملون مع العوام والأميين فحسب.
سألت أحد الطلاب: هل تعرفون شيئًا عن جمال الدين الأفغاني؟ فهزّ رأسه بأنه لم يسمع عن هذا الاسم، ولم يقرأه في أي كتاب من كتب الفقه أو الحديث أو التفسير. ومثله الإمام محمد عبده، والعلامة رشيد رضا، والشيخ حسن البنا، والشهيد سيد قطب، والشيخ محمد الغزالي. ولكن حين سألتهم عن المودودي، هاج هائجهم، وقالوا: منحرف محرف!!
هذا هو المناخ الذي يعيش فيه طلاب الجامعة... إنهم لا يعرفون كثيرًا ولا قليلًا عما سمّي في الأزهر: العلوم الحديثة: الفيزياء والكيمياء والحيوان والنبات والرياضيات، والجغرافيا والتاريخ، ناهيك بعلم النفس، أو علوم التربية أو الاجتماع والفلسفة. وجدت نفسي أمام ظاهرة تحتاج إلى التعامل بالرفق والحكمة والتدرج، ولم أرد أن أصدمهم، فيرفضوا نصحيتي بالكلية، ويسدوا آذانهم عني.
حضرت بعض دروسهم، وشاركت بالأسئلة أوجهها إلى الطلاب في العلوم الشرعية والعربية. وطلبوا مني أن ألقي درسًا في الحديث، فألقيت درسًا في الحديث الأول في «صحيح البخاري»: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...»(1). رويته لهم بسنده من حفظي، وقلت لهم: إنه من أحاديث الآحاد، وإنه تواتر بعد ذلك من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، وشرط التواتر أن يبدأ من الصحابة.
وبينت لهم أهمية الحديث عند العلماء، وأهمية النية في الإسلام، وما ورد فيها من أحاديث ذكرها الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»... كما بينت المواطن التي تؤثر فيها النية والتي لا تؤثر فيها. وهذا الحديث قد قرأت شرحه في «فتح الباري» وغيره من شروح البخاري، كما قرأت شرحه في «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم» لابن رجب الحنبلي.
وكان المشايخ والطلاب مبهورين - وأنا أشرح الحديث - من غزارة المادة عندي، ومزجي الحديث بالتفسير والفقه والعقيدة واللغة. وطلبوا أيضًا درسًا في التفسير، فاستجبت لهم، وأظن أنه كان في تفسير سورة الفاتحة.
وحضرت بعض دروس الفقه وسألتهم في الدرس، وقلت لهم: أنا درست المذهب الحنفي في الأزهر، وهو مذهبي الرسمي، درست «نور الإيضاح» وشرحه «مراقي الفلاح»، ودرست كتاب «القدوري» وشرحه «اللباب على الكتاب» الشهير بشرح «الميداني على القودري». ودرست «الاختيار في شرح المختار» لابن مودود الحنفي، هذه الكتب درستها في المرحلتين الابتدائية والثانوية من معاهد الأزهر.
ثم قرأت كثيرًا - في اطلاعاتي الخاصة - في «الهداية» وشرحها للعلامة ابن الهمام، كما قرأت في «البدائع» للكاساني، و«البحر الرائق» لابن نجيم، و«رد المحتار على الدر المختار» المعروف بـ «حاشية ابن عابدين». ودخلت في بعض دروس النحو، وسألتهم أسئلة عرفوا بها تمكني في علوم العربية. كما قرأت عليهم بعض الأبيات في درسهم من «ألفية ابن مالك» الشهيرة.
وقال الشيخ محمد يونس رئيس الجامعة لإخوانه من شيوخ الجامعة: هذا الرجل آية من آيات الله، كنا نظنه داعية عصريًّا قليل البضاعة من العلوم الأصلية، فإذا هو بحر ثجاج جمع بين القديم والحديث، وما رأيت مثله! ولم يكن هذا إلا فضلًا من الله تعالى عليَّ: أن زيَّنني في أعينهم، وستر عيوبي عنهم... وقد قال ابن عطاء الله في حكمه: إذا أثنى عليك أحد فذلك من فضل الله عليك، فالفضل لمن أكرمك وسترك، لا لمن مدحك وشكرك.
ولقد أنس بي الشيوخ والطلاب في الجامعة، وكانوا يجلسون إليّ طويلًا يستمعون عن الإسلام ودعوته وأمته وقضاياه:ما لم يكن يومًا مما يفكرون فيه أو يدخل في دائرة اهتمامهم. ولعل أهم ما استفادوا من زيارتي: أنهم علموا أن العلم ليس في الكتب وحدها، وأن هناك كتبًا غير الكتب التي يدرسونها، وهناك علماء ملئوا الدنيا علمًا وفكرًا غير الشيوخ الذين درسوا عليهم، وأن العلم بحر لا ساحل له، وأن علينا أن نطلب من علم الدنيا ما يساعدنا على فهم الدين.
وقد طلبت منهم أن يدخلوا بعض الكتب إلى مكتبة الجامعة، مثل «تفسير المنار»، و «تفسير الشيخ جمال الدين القاسمي»، وبعض الكتب التي تيسر تعليم النحو والبلاغة، مثل كتاب «النحو الواضح» بأجزائه لعلي الجارم ومصطفى أمين، ومثله «البلاغة الواضحة». وأن يسمحوا بدخول بعض المجلات الإسلامية، مثل مجلة «الأمة» القطرية، ومجلة «الوعي الإسلامي» الكويتية، ومجلة «منار الإسلام» الإماراتية.
وكان مجرد سماعهم مثل هذا الكلام في جوّهم المغلق: فتحًا مبينًا، ولعلهم لم ينفذوا منه حرفًا، ولكن كان من المهم أن يطرق هذا سمع طلابهم، وأن يدركوا أن هناك عالمًا غير جامعتهم، وأن هناك خصومًا يكيدون للإسلام كيدًا، على المستوى الديني من المنصّرين، الذين يرون بعضهم في بلدهم، وعلى المستوى الفكري من المستشرقين المغرضين، وأخطر منهم تلاميذهم من العلمانيين والمتغربين، ولا بد أن يعدوا أنفسهم لمواجهة هذا الكيد بالعلم النافع، والفكر الثاقب، والثقافة المتفتحة.
ولم يكن هذا الانغلاق من طابع جامعة «فتيا» وحدها، بل هو طابع الجامعات والمدارس الدينية في بنجلاديش بصفة عامة. وقد زرت عددًا منها، مثل جامعة «حضاري» أو الحضارة، وغيرها، ووجدت الطابع نفسه، وإن اختلفت الدرجة بين جامعة وأخرى.
وقد كان الأزهر قديمًا يشبه هذه الجامعات إلى حد كبير، ولكنه استجاب لدعوة الإصلاح، وأدخل العلوم الحديثة إلى مناهجه، من العلوم الطبيعية والرياضية والاجتماعية، وهي في حقيقة الأمر ليس حديثة، بل هي علومنا، كنا أساتذة العالم فيها لعدة قرون، وقد اقتبسها الغرب منا، ثم عدنا نأخذها منه، فهي بضاعتنا ترد إلينا.
وقد انتهز الإخوة في «فتيا» وجودي، فافتتحوا أكثر من مشروع، وضعت الحجر الأساسي فيها بيدي، ووضع اسمي عليها، وأتمنى أن تكون قد قامت وأدت رسالتها.
وفي فترة وجودي في شيتا غونغ زرت عددًا من المدارس الدينية الصغيرة الفقيرة، التي تحتاج إلى معونة مادية، لتقف على قدميها، وكان بعض الإخوة الخيّرون من أهل قطر، قد حملوني بعض المبالغ من زكواتهم أو صدقاتهم، وفوّضوا إليَّ أن أدفعها حيث أرى، فرأيت أولى الناس بها أصحاب هذه المدارس، وكانوا يفرحون بأي مبلغ يُعطى لهم، فهم بقناعتهم يكفيهم القليل، ويبارك الله في القليل، فينتج كثيرًا.
ثم ختمت أيامي في هذه المدينة الكيبرة التي تعدُّ المدينة الثانية في بنجلاديش بمحاضرة عامة، كما أشرت من قبل، ثم بمؤتمر صحفي أجبت فيه عن أسئلة الصحفيين حول الإسلام ورسالته وحضارته، ومشكلات أمته. ثم ودَّعت الإخوة في «فُتيا» أو في «شيتا غونغ عمومًا» ممتطيًا الطائرة إلى «دكا»، ومع بعض الرفقاء من الجامعة. وقد هيأ الإخوة في دكا لي أن أخطب الجمعة في الجامع الكبير في وسط دكا، وقام بعض علمائهم بترجمة الخطبة بعد الصلاة.
كما أتيح لي أن أزور دار «الجماعة الإسلامية»، وألقيت فيها محاضرة، ثم التقيت بهم لقاء خاصًا، لأجيب عن استفساراتهم، واطلعتهم على أهم أحوال إخوانهم في البلاد العربية. وكان البروفيسور غلام أعظم: الرجل الأول في الجماعة، لم يؤذن له بعد بدخول البلاد؛ لأنه كان ضد انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الغربية، فأسقطوا جنسيته وهو ابن البلد الأصيل!
وبعد هذه الإقامة الحافلة، كان لا بد من العودة إلى الدوحة عن طريق الطائرة البنغالية التي تصل من دكا إلى الدوحة مباشرة في نحو خمس ساعات. والحمد لله رب العالمين.
.....
(1) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (1)، ومسلم في الإمارة (1907) عن عمر بن الخطاب.



 الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟ 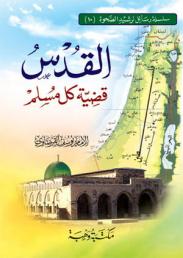 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم 






