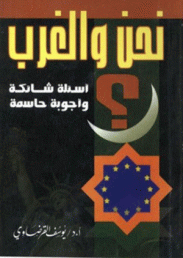
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين، وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه مجموعة من الحوارات بيننا وبين الغرب، ظهرت في صورة أسئلة محرجة، أو شائكة، رددت عليها بأجوبة بينة، بل حاسمة، سميناها: «نحن والغرب»، ولا بد لنا أن نحدد: من نحن؟ أو: ما نحن؟ ومن الغرب؟ أو: ما الغرب الذي يحاورنا ونحاوره؟
و«الغرب» في اللغة هو: الجهة التي تغرب فيها الشمس، والبلاد الواقعة فيها، مقابل «الشرق» وهو الجهة التي تشرق منها الشمس، والبلاد الواقعة فيها، وقد يعبر عنهما بـ «المشرق» و«المغرب»، وفي القرآن: {رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلٗا} [المزمل: 9].
والغرب والشرق أمر نسبي، فكل بلد وكل مكان له غربه وشرقه. ووطننا العربي مقسم إلى: شرق وغرب، وقد اصطلح على أن الغرب يبدأ من ليبيا إلى موريتانيا مرورًا بتونس والجزائر والمغرب الأقصى، وحين قسم الناس الكرة والأرضية إلى شرق وغرب، اضطروا أن يقسموا الشرق إلى أقسام بحسب موقعه، فهناك شرق أقصى، وهناك شرق أوسط، وهناك شرق أدنى.
وقد اصطلح الناس على أن الغرب هو أوروبا وأمريكا، أما آسيا وإفريقيا فهما شرق، وإن كان من أهل إفريقيا من يريد أن يلحق نفسه بالغرب، كما ذكر د. طه حسين، في كتابه «مستقبل الثقافة»: أن مصر إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا أقرب منها إلى الهند والصين واليابان، وكما ينادي بذلك كثيرون في شمال إفريقيا من دعاة الفرانكفونية ومن دار في فلكهم.
هذا إذا نظرنا إلى الشرق والغرب من الناحية الجغرافية، ولكن الأهم والأخطر من ذلك: هو الشرق والغرب من الناحية الثقافية والحضارية، وهي الناحية التي لأجلها حدث الصراع، ووقعت الحروب طوال التاريخ، وإن كان أغلب ما دارت رحى الصراع كان بين الغرب والشرق الأوسط «الكبير» كما يسمونه اليوم.
كانت قيادة عجلة الحضارة لقرون طويلة في يد الشرق، حين ظهور الحضارات الشرقية القديمة العريقة: الفينيقية والفرعونية والآشورية البابلية والفارسية والهندية والصينية... وكان الشرق هو مصدر المعرفة والمدنية والصناعة والرقي، ثم انتقلت العجلة إلى الغرب لعدة قرون، حين ظهرت فلسفة اليونان، ومدينة الرومان، وبرزت الدولة الرومانية، وغزت أقطارًا كثيرة من الشرق، وتركت آثارها في بلاد شتى.
ثم عادت عجلة القيادة الحضارية إلى الشرق مرة أخرى على يد الحضارة العربية الإسلامية، التي قادت الدنيا بزمام الدين، وأقامت مدينة العلم والإيمان، وأنشأت حضارة ربانية إنسانية أخلاقية عالمية، ظل العالم يتعلم منها، ويأخذ عنها حوالي ثمانية قرون، وقد ظهر لها فرع في الغرب في الأندلس أضاء نوره في أوروبا واقتبس منه كثيرون من أبنائها.
ونام المسلمون وتخلفوا، واستيقظ الغربيون وتقدموا، وكان لا بد لمن جد أن يجد، ولمن زرع أن يحصد، وأن يقبض الغرب على زمام الحضارة، ويهيمن على العالم، بخبرته العلمية، وبقدرته الاقتصادية، وبقوته العسكرية، وبقينا نحن معدودين في «العالم الثالث» أو في «البلاد النامية» أو في بلاد «الجنوب» العاجز المتخلف الفقير.
ومنذ ظهر الإسلام قدر له أن يصطدم بالغرب الذي كان يمثله هرقل إمبراطور الدولة الرومانية «البيزنطية»، والذي أرسل إليه الرسول الكريم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، وختمها بالآية الكريمة: {يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ} [آل عمران: 64].
ولم يستجب هرقل للدعوة، رغم إيمانه في قرارة نفسه بأحقيتها وصدق صاحبها، وصمم على المواجهة، وبدأ أتباعه بقتل بعض الدعاة، وكان لا بد من الصدام، وإن كانت القوى العسكرية غير متكافئة، فكانت سرية مؤتة، وكانت غزوة تبوك في العهد النبوي.
وفي عهد أبي بكر استمرت المواجهة، وكانت موقعة «اليرموك» الشهيرة، وفتح بلاد الشام وفلسطين، ثم مصر وشمال أفريقية، وهذه الفتوح والانتصارات كلها على حساب إمبراطورية الروم البيزنطية، وقد أصبحت هذه البلاد جزءًا أصيلًا وعزيزًا من قلب ديار الإسلام، وقد كانت من قبل نصرانية الديانة. وكثيرًا ما مرت فترات طويلة من السلام والسكون والمهادنة بين الطرفين، لا يعكرها إلا بعض المناوشات على الحدود.
ولكن الحدث الكبير الذي حرك السواكن، وهيج الكوامن، وأثار الشجون، هو الحروب التي بدأها الغرب بحملات متتالية للهجوم على الشرق الإسلامي، مستغلين ما أصاب أهله من فرقة وتشرذم، نتيجة لما أصابهم من جهل وغفلة، ومن انحراف ديني، وفساد أخلاقي، فكانت الحروب الشهيرة التي عرفت عند مؤرخي المسلمين باسم «حروب الفرنجة» وعند الغربيين باسم «الحروب الصليبية»!
وقد وقع من الغربيين في هذه الحروب من سفك الدماء، وهتك الاعراض، واستباحة المقدسات والمحرمات، ما يندى له الجبين، وما تقشعر من ذكره الجلود، ولا سيما في معركة الاستيلاء على بيت المقدس، التي جرت فيها الدماء للركب حقيقة لا مجازًا!!
وانتهت هذه الحروب المؤسفة بانتصار المسلمين في النهاية، واستردادهم بلادهم، ورد الغزاة الطغاة على أعقابهم، بعد معارك حاسمة في حطين وفتح بيت المقدس ودمياط والمنصورة، وغيرها. وقد بقيت في النفوس مرارات لا تزول بسهولة.
ثم جاء عصر الاستعمار، ودخل الغرب بلاد الإسلام مرة أخرى، أخذًا بثأره من نكسة الحروب الصليبية القديمة، فقال قائدهم الإنجليزي «اللنبي» الذي دخل القدس سنة 1917م: اليوم انتهت الحروب الصليبية! وقال القائد الفرنسي «غورو» أمام قبر صلاح الدين في دمشق: ها قد عدنا يا صلاح الدين!
وبدخول عصر الاستعمار، عاد الصراع إلى أشده، فإن بلاد الإسلام رفضت الاستعمار، وقاومته شعوبه كل بمفرده، وكان هذا سر ضعفها، فلم تقابله كتلة واحدة، بل فرادي مبعثرين، مع حالة الضعف والعجز والخلل والتخلف التي كانت عليها الأمة، وأعتقد أن حالة الضعف والعجز والخلل والتخلف هذه هي التي سماها مالك بن نبي «القابلية للاستعمار»، وإن كان في النفس من هذه التسمية شيء؛ لأنها توحي بقبول الاستعمار والرضا عنه، والتهيؤ له، ولا أحسب هذا مقبولًا ولا صحيحًا بحال، وإنما هو الفساد والاختلال الذي يمهد للغزو والاحتلال، كما أشارت إلى ذلك أوائل سورة الإسراء، حين أفسد بنو إسرائيل في الأرض، فسلط الله عليهم من يجوس خلال ديارهم، ويتبرون ما علوا تتبيرًا.
لقد قاومت بلاد الإسلام الاستعمار، لما يفرضه عليها دينها - فرض عين - من مقاومة الغزاة المحتلين بكل ما لديهم من قوة، ولكن الاستعمار كان له الغلبة وفق سنن الله: أن ينتصر العلم على الجهل، والنظام على الفوضى، والقدرة على العجز، والاتحاد على التفرق، والتقدم على التخلف، والقوة على الضعف.
ولكن الهزيمة الأولى لم تكسر الإرادة نهائيًا، فظلت الأمة تتربص وتنتهز الفرصة، وظل الرواد والأبطال يوقظونها، ويعدونها لليوم الموعود، حتى تحررت من الاستعمار، وكان آخرها الجزائر التي ظلت تحت الاستعمار الفرنسي الاستيطاني قرنًا وثلثًا من الزمان، ثم عزمت على أن تتحرر، ودفعت الثمن غاليًا: مليونًا أو أكثر من الشهداء. وعادت الجزائر عربية مسلمة، بعد أن أرادوا أن يفقدوها هويتها بالفرنسة، حتى تنسى دينها ولغتها، حتى كانت الأنشودة الجزائرية الشعبية بعد التحرير: يا محمد مبروك عليك! الجزائر رجعت إليك!
ولكن الاستعمار قبل أن يرحل عن بلاد المسلمين، لم يتركها سالمة، بل إنه زرع فيها أمرين خطيرين:
الأول: أنه زرع فيها شجرة شيطانية، لا تزال تنبت الشر والفساد، ألا وهي إسرائيل، التي انتزعت من بين ضلوعنا قطعة من لحمنا ودمنا، وغرست في صدورنا خنجرًا لا زال جرحه يدمي، وأدخلت ضمن وطننا العربي المسلم، عدوًا يتربص بنا الدوائر، ويكيد لنا المكايد، ولا يبنى نفسه إلا على أنقاضنا، ولا يحيا إلا بموتنا، ولا ينتصر إلا بهزيمتنا، ولا تقر له عين إلا بتركيعنا وتطويعنا و«تطبيعنا»!
والثاني: أنه حين دخل بلادنا لم يكن همه الاستعمار العسكري وحده، كما فعل الصليبيون، بل خطط لانتصار ثقافي وتعليمي وتشريعي واجتماعي، يغير به البلاد من داخلها، ونجح في ذلك إلى حد كبير، ووجد من أبناء المسلمين دعاة صرحاء إلى تغريب أمتهم، والسير وراء الغرب شبرًا بشبر، وذراعًا ذراع. اطمأن الغرب عامة إلى أن غرسه لم يذهب سدى.
وفي وقت من الأوقات، ظن كثيرون أن رياح الأطماع قد سكنتن وأن نيران الأحقاد قد خمدت، وأن موجات المخاوف قد ركدت، وأن العلاقات يمكن أن تتوطد؛ فلا أطماع ولا مخاوف ولا أحقاد، وخصوصًا بعد أن ولي عصر الاستعمار، ولا سيما أن الغرب احتاج إلى أبناء المسامين ليعملوا عنده، ففتح باب الهجرة إليه، فجاهرت ملايين من أبناء الشمال الأفريقي، وخصوصًا إلى فرنسا، ومن أبناء تركيا، وخصوصًا إلى ألمانيا، ومن أبناء الهند وباكستان، وخصوصًا إلى بريطانيا.
كما احتاج المسلمون إلى الغرب ليأخذوا منه العلم في مختلف ميادينه، فأرسلوا الألوف، بل عشرات الألوف من أبنائهم في كل اختصاص، ورأى الغرب أن يستفيد من ذلك فاجتذب إليه من هؤلاء أذكاهم وأنبغهم، فاستبقاهم عنده، وحرمت منهم ديارهم الأصلية.
وشاء الله أن تقوم في بلاد الإسلام صحوة إسلامية هائلة، لم يحسب أحد لها حسابًا، وهذا من عجائب هذا الدين، وقد أشار إلى ذلك «جب» في بعض كتبه بأنها تشبه «الانفجار» الذي لم يتوقعه أحد، قامت بعد أن ضربت الحركات الإسلامية ضربات وحشية موجعة، بل حسبها بعضهم قاتلة، ولكن رب ضارة نافعة، فقد نبهت هذه المحن الغافلين، وأيقظت النائمين، وحركت الساكنين، وظهرت في كل بلاد العرب والمسلمين صحوة شاملة، كانت صحوة عقول وأفكار، وكانت صحوة قلوب ومشاعر، وكانت صحوة إرادات وعزائم، وكانت صحوة التزام وسلوك، وكانت صحوة أخلاق وفضائل، وكانت صحوة نشاط وإبداع، وكانت صحوة دعوة وجهاد.
برزت هذه الصحوة في بلاد العرب، وفي العالم الإسلامي، وفي خارج العالم الإسلامي حيث يعيش المسلمون أقليات بين ظهراني مجتمعات غير مسلمة، وتجلى أثر هذه الصحوة في كل صعيد؛ الصعيد الثقافي «المكتبة الإسلامية»، والصعيد الاجتماعي «الحجاب»، والصعيد الاقتصادي «البنوك الإسلامية»، والصعيد الجهادي «أفغانستان وفلسطين»، والصعيد السياسي «التنادي بتطبيق الشريعة» والتنادي بـ «التضامن الإسلامي» طريقًا إلى الوحدة الإسلامية.
وأزعجت هذه الصحوة الغرب عامة، وأمريكا خاصة، فرصدت مئات الملايين، وجندت رجالها المدربين، واستعانت بالعملاء من بيننا والخائنين، لمحاصرة هذه الظاهرة الإسلامية التي فاجأت الجميع، بعد دراستها والإحاطة بأسبابها ومحركاتها وغاياتها، وعوامل قوتها وعوامل ضعفها.
وفي هذه الفترة سقط أحد القطبين العظيمين المتنافسين على سيادة العالم: الاتحاد السوفيتي؛ وكان من أسباب سقوطه حرب أفغانستان؛ التي ساهم المسلمون فيها بالنصيب الأكبر، فقدموا خدمة مجانية للغرب، لم يقابلها بالاعتراف والشكران، بل قابلها بترشيح «الإسلام عدوًا بديلًا» للاتحاد السوفيتي.
وكتب المفكرون الاستراتيجيون مثل: فوكاياما وهانتنجتون وغيرهما، محذرين من خطر الحضارة الإسلامية «الناشزة» التي يصعب تطويعها، ولا سيما إذا اتفقت وتقاربت مع الحضارة الكونفوشيوسية «الصينية»، وبدأ التحذير من «الخطر الأخضر» يعنون «الخطر الإسلامي» الذي بالغوا في تضخيمه وتهديده للعالم، بعد أن تقاربوا مع «الخطر الأصفر» أي الخطر الصيني، وبعد سقوط الخطر الأحمر «الروسي».
ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض الأكاديميين المنصفين، رفضوا هذا التهويل، وأثبتوا أن الإسلام ليس خطرًا مخوفًا كما يقال، ومن هؤلاء البرفسور اسبوزيتو المعروف الذي كتب في ذلك كتابًا «الخطر الإسلامي: حقيقة أم أسطورة؟!».
وكانت أمريكا تعد العدة لتقوم بأدوار جديدة في الشرق الأوسط، أو قل بصريح العبارة: في بلاد الإسلام؛ فكانت حرب الخليج الأولى، التي دفعت بها «صدامًا» للاعتداء على إيران، ثم كانت حرب الخليج الثانية، التي دفعت فيها «صدامًا» أيضًا بطريق خفي إلى غزو الكويت.
وكان ذلك كله مقدمة لغزو العراق، والدخول العسكري إلى المنطقة، والتحكم فيها بيد من حديد، ومحاولة تغييرها من داخلها تغييرًا جذريًا، تغييرًا يشمل التعليم والثقافة والإعلام، بحيث تتدخل أمريكا في كل شيء، جهرة جينًا، ومن وراء ستار أحيانًا، ولم تعد تحتاج إلى لبس الأقنعة التي تخفي وجوهها، بل رأيناها بأعين رؤوسنا تعمل على المكشوف، وتدس أصابعها في كل شيء، حتى في تعليم الدين، تعليم العقائد والفقه والتفسير والحديث وغيرها.
وكانت أحداث 11 سبتمبر 2001م من أبرز الأسباب التي أعطت أمريكا المبرر لهذا التدخل السافر، وإن كان العارفون يعلمون أن هذه السياسة قد رسمت من قبل، وأن هناك وثائق وتقارير معروفة قد دلت على ذلك بوضوح. شنت أمريكا حربًا كونية كبرى على «الإرهاب» فيما زعمت، ولكن الدلائل كلها تنطق بأن هذه الحرب إنما هي على الإسلام وأمته وأوطانه، بهدف الاستيلاء على كل مقدرات هذه الأمة، والتمكن منها، والدخول إلى أعماقها، والتحكم في مسيرتها، حتى تملي عليها كيف تفكر إذا فكرت، وكيف تتكلم إذا تكلمت، وكيف تعمل إذا عملت. فهي ترسم لها طريق التفكير، وطريق التدبير، وطريقة التنفيذ، بل تعلمها كيف تتدين، وكيف تفهم دينها، وكيف تمارس الدين في حياتها، بل أعلنوا بصراحة أنهم يريدون أن يصوغوا للمسلمين دينهم من جديد، أي صناعة «إسلام أمريكاني» بدل «الإسلام القرآني» أو «المحمدي».
ولقد قال بوش في أول الأمر: إن هذه الحرب حرب صليبية طويلة الأمد، ونبهه خبراؤه إلى خطورة هذه الكلمة، ومدى أثرها على عقول المسلمين ونفوسهم، وما لها من إيحاءات تاريخية، فاعتذر عنها، وقال من قال: إنها زلة لسان، وزلات اللسان إنما تعبر عن مكنون نفس الإنسان. ولقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: غش القلوب يظهر على صفحات الوجوه، وفلتات الألسن! ثم تلا قول الله تعالى: {وَلَوۡ نَشَآءُ لَأَرَيۡنَٰكَهُمۡ فَلَعَرَفۡتَهُم بِسِيمَٰهُمۡۚ وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ} [محمد: 30].
بعد الحادي عشر من سبتمبر شنت حملة إعلامية ضخمة على الإسلام، بجوار الحملة العسكرية، واعتبر الإسلام مصدر الإرهاب والعنف في العالم، وأصبح المسلمون يواجهون أسئلة شتى من الغربيين في كل مكان، تكيل التهم للإسلام ولكتابه ونبيه وشريعته وحضارته وتاريخه وأمته، كيلا جزافًا.
ووجهت إلي - بصفة خاصة - عشرات من هذه الأسئلة من هنا وهناك، من المخلصين من المسلمين يطلبون الإجابة عنها، بدل أن يرد على هذه الأسئلة العاجزون الذين يسيئون بإجابتهم أكثر مما يحسنون. جاءتني أسئلة من رئيس البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد محمد علي، أرسلها إليه عدد من الإخوة العاملين في مجال العمل الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية وجاءتني أسئلة من بعض الإخوة الذي يعيشون في الغرب، منهم أخونا ثابت عيد في سويسرا، ومنهم إخواننا في «ائتلاف الخير» في لندن وجاءتني أسئلة من بعض الصحف العربية، وحاورت بعض الصحفيين من أمريكا وإنجلترا وألمانيا.
ورأيت أن أجمع ذلك كله بعضه إلى بعض لأقدمه للقارئ الكريم، ليعرف عن بينة: موقفنا من الغرب وموقف الغرب منا، على ضوء هدى القرآن، وهدى السنة، وتوجهات هذا الدين العظيم، {لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٖ} [الأنفال: 42]. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
الدوحة في: 15 جمادى الأولى 1426هـ - 2/6/2005م
الفقير إلى عفو ربه
يوسف القرضاوي


 فقه الصيام
فقه الصيام  موجبات تغير الفتوى في عصرنا
موجبات تغير الفتوى في عصرنا  ثقافة الداعية
ثقافة الداعية  تاريخنا المفترى عليه
تاريخنا المفترى عليه 






