د. يوسف القرضاوي
من الشرائط المهمة: ما نبه عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي في "موافقاته" وهو: العلم بمقاصد الشريعة، التي لأجلها أنزل الله الكتاب، وبعث الرسول وفصل الأحكام. فالشريعة إنما جاءت برعاية مصالح البشر المادية والمعنوية، الفردية والاجتماعية، رعاية قائمة على العدل والتوازن، بلا طغيان ولا إخسار.
وهذه الرعاية تشمل المصالح في رتبها الثلاث: "الضروريات، والحاجيات، والتحسينات"، وما يكملها وما يتبعها من درء المفاسد والمضار بكل مراتبها.
وقد بين الله تعالى المقصد الأسمى لرسالة رسوله فقال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (الأنبياء:107) هكذا بصيغة الحصر، وقال: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ" (النحل:89).
ولهذا قال الإمام ابن القيم في فصل "تغير الفتوى" من "أعلامه":
"إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والميعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل".
لهذا كان العلم بمقاصد الشريعة في غاية الأهمية حتى لا يغلط عليها الغالطون ويجروا وراء الأحكام الجزئية مهملين المقاصد الكلية، فيخلطون ويخبطون.
ولقد اهتم الشاطبي رحمه الله بهذا الشرط ونوه به، حتى جعله هو سبب الاجتهاد، لا مجرد شرط، فقد جعل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وأنها مبنية على اعتبار المصالح برتبها الثلاث، يقول: إذا بلغ الإنسان مبلغا فهم فيه عن الشارع مقصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في نزوله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا، والحكم بما أراه الله.
الوصف الثاني: هو التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها.. وذلك بواسطة معرفة العربية، ومعرفة أحكام القرآن والسنة والإجماع..الخ. فإن هذه أدوات الاستنباط، والشاطبي جعل الثاني كالخادم للأول، لأن الأول هو المقصود والثاني وسيلة.
والشاطبي محق في الاعتداد بهذا الأمر، واعتبار الجزئيات بالكليات، من غير إهمال الجزئيات أيضا. وقد منح رحمه الله هذا الموضوع اهتماما بالغا في كتابه الفريد "الموافقات"، حيث شغل الأصوليون قبله بالمباحث اللفظية، ولم يعطوا هذا الأمر ما يستحق، كما شغل علماء الفقه بالأحكام الجزئية، وغفلوا عن المقاصد، وترتب على ذلك ظهور فن "الحيل الفقهية" التي يضاد معظمها مقاصد الشريعة، وهذا ما عني بإبطاله العلامة ابن القيم، وقبله شيخه الإمام ابن تيمية.
وربما قيل: إن أحدا من الأصوليين لم يذكر هذا الشرط الذي عول عليه الشاطبي للاجتهاد! والجواب من وجهين:
أحدهما: أنهم لعلهم اكتفوا بما ذكروه من وجوب الرسوخ في معرفة القرآن والسنة، فهذا يؤدي بدوره إلى معرفة مقاصد الشريعة، لأنها إنما تعرف منهما أولا وبالذات لمن أحسن فهمهما.
والثاني: أنهم أشاروا إلى أهمية معرفة القواعد الكلية، وإن لم يفردوها بالذكر كما ذكر الغزالي نقلا عن الشافعي فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله، قال: ويلاحظ القواعد الكلية أولا، ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالقتل، فتقدم قاعدة الدرع على مراعاة الاسم، فإن عدم قاعدة الكلية، نظر في النصوص ومواقع الإجماع.
بل إن الإمام السبكي جعل الإحاطة بمعظم قواعد الشرع شرطا مستقلا، بحيث يكتسب بها قوة يفهم مقصود الشارع.
وذلك مثل قواعد: "الضرر يزال"، "ارتكاب أخف الضررين"، "الضروريات تبيح المحظورات"، "المشقة تجلب التيسير"، وغيرها مما ألفت فيه كتب "القواعد" و"الأشباه" و"الفروق"، على أن هذا مما يمكن أن يدخل تحت "مقاصد الشريعة"، والناظر في فقه الصحابة رضي الله عنهم يجد أنهم أولوا هذا الأمر عنايتهم، ونظروا إلى مقاصد الشريعة في فتواهم، مع نظرهم إلى النصوص الجزئية.
وهذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يتوقف أول الأمر في قسمة سواد العراق على الفاتحين، ولم يأخذ بالنص الجزئي في قوله تعالى: "وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.." (الأنفال:41) وما ذلك إلا لأنه وجد توزيع مثل هذه المساحات الهائلة على عدد محدود من الأفراد، يترتب عليه مفاسد تأباها الشريعة التي جاءت تقيم العدل والتكافل بين المسلمين بعضهم وبعض، على اتساع المكان، وامتداد الزمان، فهو تكافل بين الأقطار الإسلامية، وتكافل بين الأجيال الإسلامية؛ ولذا قال لهم عمر: "تريدون أن يأتي آخر الناس وليس لهم شيء؟" وقال: "إني رأيت أمرا يسع أول الناس وآخرهم.." وساعده على هذا الفهم ما شرح الله له صدره من تدبر آيات سورة الحشر في قسمة الفيء.
وهذا ما جعل معاذ بن جبل يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميص أو لبيس (نوع من المنسوجات اليمنية) آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وأنفع للمسلمين بالمدينة" فأجاز أخذ القيمة في الزكاة وغيرها، لما ذكره من المصلحة، وهو ما ذكره البخاري في صحيحه ومال إليه، ووافق فيه الحنفية على كثرة مخالفته لهم، كما ساقه إلى ذلك الدليل البين.
ونظرتهم إلى المقاصد هي التي جعلتهم يفعلون أشياء لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا فيها مصلحة الأمة، مثل جمع المصحف في عهد أبي بكر، وجمع الناس على المصحف الإمام في عهد عثمان، وتضمين علي للصناع.. وغير ذلك..
والذي يبدو لي أن هذا الشرط ـ رغم أهميته ـ ليس شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد بل هو شرط لصحة الاجتهاد، واستقامته، كما قاله شيخنا الأكبر محمد الخضر حسين رحمه الله في شرط معرفة "مواقع الإجماع"، وذلك أن هذا مبني على أن أحكام الشريعة معللة، وهو ما تشهد به مئات النصوص من القرآن والسنة، وجرى عليه الفقهاء من عهد الصحابة فمن بعدهم، ومن أجل هذا كان القياس أحد مصادر الشريعة عند جمهور الأمة.
وإذا كان الظاهرية وبعض الشيعة والمعتزلة ينكرون تعليل الأحكام والقياس، وهم مع هذا مجتهدون على الصحيح، كان هذا دليلا على أن الإنسان يمكن أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، وإن لم يراع المقاصد، ولكن اجتهاده فيما يحتاج إلى رعاية المقاصد لا يكون صحيحا، ويغلب عليه الخطأ، وإن كان صاحبه معذورا، بل مأجورا، مثل الذين صلوا العصر في بني قريظة بعد المغرب، أخذا بحرفية النص دون مقصوده.
أضرب لذلك مثلا بما ذهب إليه ابن حزم ومن وافقه أن عروض التجارة لا زكاة فيها، وإن بلغت قيمتها الألوف وألوف الألوف! وذلك لأنه لم يثبت لديه نص خاص في زكاة التجارة، ولم يلتفت إلى النصوص العامة، ولا إلى مقصد الشارع من إيجاب الزكاة على الأغنياء، فأعفى بذلك ملايين الريالات والدنانير والجنيهات من الزكاة الواجبة، إلا إذا تحولت العروض إلى مال سائل من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول، وهذا قلما يحدث في عصرنا إلا في نسبة ضئيلة من مال التجارة.
ومما يؤسف له أن بعض المشتغلين بالحديث في عصرنا يتبنى رأي ابن حزم ويفتي به التجار، الذين قد يعتمدون على فتواه، ولا يخرجون من أموالهم هذا الحق المعلوم! كأن التجار وحدهم ـ دون سائر أصحاب الأموال ـ في غير حاجة إلى تزكية أنفسهم وتطهير أموالهم، وشكر نعمة ربهم، والإسهام في كفالة ذوي العوز في مجتمعهم، وفي حماية المصالح العامة لملتهم!
ومثل ذلك رفض ابن حزم لإخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر، وإن دعت إلى ذلك الحاجة، واقتضته المصلحة، وهو ما نرى اليوم بعض العلماء الجامدين على النصوص يفتون به الجماهير في زكاة الفطر، ويمنعون منعا باتا إخراج القيمة، ويأبون إلا الحبوب، وغالب قوت البلد من القمح أو الشعير ونحوهما، وهو ما لم يعد يجده ـ بسهولة ـ غني أو ينتفع به فقير، في المدن الإسلامية، التي أصبحت تشتري الخبر جاهزا، ولا تحتاج إلى الحبوب.
وكل من وقف عند ظواهر النصوص الجزئية، وأهمل المقاصد الكلية، يتعرض للخطأ في اجتهاده، وقد شاهدنا من ذلك في زمننا صورا متعددة وصارخة. من ذلك ما ارتآه بعض المعاصرين في شأن النقود الورقية التي يجرى بها التعامل بين الناس في شتى الأقطار، فقد ذهب هؤلاء إلى أن هذه النقود ليست هي النقود الشرعية التي جاءت بها النصوص، ورتبت عليها الأحكام في الزكاة والربا وغيرهما.. وانتهى هؤلاء الحرفيون إلى أن هذه النقود لا يجري فيها الربا المحرم، ولا تجب فيها الزكاة المفروضة.
وقد بينت خطأ هؤلاء في "فقه الزكاة".
................
* من كتاب "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية" لفضيلة الشيخ.



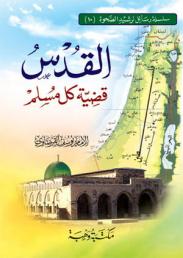 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






