السؤال: قرأت لكم في أكثر من كتاب، وسمعتكم في أكثر من محاضرة تدعون إلى القاعدة التي تقول: "نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه".
فمن الذي وضع هذه القاعدة في صيغتها هذه؟ وهل لها دليل من الشرع؟ وكيف نتعاون مع المبتدعين والمنحرفين؟ وكيف نعذر من يخالفنا إذا كان هو مخالفًا للنصوص من الكتاب والسنة؟
أليس مطلوبًا منا أن ننكر عليه ونهجره، بدل أن نسامحه ونعذره؟ أليس القرآن الكريم يقول: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (النساء:59)؟ فلماذا لا نرد هذا المخالف إلى الكتاب والسنة، وهو المراد بالرد إلى الله والرسول، بدل أن نلتمس له العذر، وأي عذر له في مخالفة النص؟
أصارحكم أن الأمر قد التبس علينا، وغدونا في حاجة إلى توضيح معالمه وإقامة الأدلة عليه، وأنتم لذلك أهل بما أفاء الله عليكم، فلا تضنوا على إخوانكم وأبنائكم بذلك، ولكم منا الشكر، ومن الله الأجر.
جواب سماحة الشيخ القرضاوي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:
الذي وضع القاعدة المذكورة: "نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" في هذا الصيغة هو العلامة السيد رشيد رضا -رحمه الله- زعيم المدرسة السلفية الحديثة، وصاحب "مجلة المنار" الإسلامية الشهيرة، وصاحب "التفسير" و"الفتاوى" والرسائل والكتب التي كان لها تأثيرها في العالم الإسلامي كله، وقد أطلق عليها: "قاعدة المنار الذهبية"، والمقصود منها: "تعاون أهل القبلة" جميعًا ضد أعداء الإسلام.
ولم يضع السيد رشيد هذه القاعدة من فراغ، بل الذي يظهر للمتأمل أنه إنما استنبطها من هداية الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، وإملاء الواقع وظروفه وضروراته، وحاجة الأمة الإسلامية إلى التلاحم والتساند في مواجهة أعدائهم الكثيرين، الذين يختلفون فيما بينهم على أمور كثيرة، ولكنهم يتفقون على المسلمين وهو ما حذر منه القرآن أبلغ التحذير: أن يوالي أهل الكفر بعضهم بعضًا، ولا يوالي أهل الإسلام بعضهم بعضًا، يقول تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} (الأنفال:73).
ومعنى "إلا تفعلوه": أي إن لم يوال بعضكم بعضًا ويساند بعضكم بعضًا كما يفعل أهل الكتاب في جانبهم، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؛ لوجود التماسك والتلاحم والموالاة بين الكفار، في مقابلة التفرق والتخاذل بين المسلمين.
فلا يسع أي مصلح إسلامي إلا أن يدعو أمة الإسلام إلى الاتحاد والتعاون، في مواجهة القوى المعادية لهم، المتعاونة عليهم، وهي قوى عاتية جبارة، وأن ينسوا خلافاتهم الجزئية، من أجل القضايا المصيرية، والأهداف الكلية.
وهل يملك عالم مسلم يرى تعاون اليهودية العالمية، والصليبية الغربية، والشيوعية الدولية، والوثنية الشرقية، خارج العالم الإسلامي -إلى جوار الفرق التي انشقت عن الأمة ومرقت عن الإسلام، داخل العالم الإسلامي- إلا أن يدعوا أهل القبلة الذين التقوا على الحد الأدنى من الإسلام، ليقفوا صفًا واحدًا في وجه هذه القوى الجهنمية التي تملك السيف والذهب، وتملك قبلهما المكر والدهاء والتخطيط، لتدمير هذه الأمة ماديًا ومعنويًا؟!
ولهذا رحب المصلحون بهذه القاعدة، وحرصوا على تطبيقها بالفعل، وأبرز من رأيناه احتفل بها الإمام الشهيد حسن البنا، حتى ظن كثير من الإخوان أنه هو واضعها.
أما كيف نتعاون مع المبتدعين والمنحرفين، فالمعروف أن البدع أنواع ومراتب. فهناك البدع المغلظة، والبدع المخففة، وهناك البدع المكفرة، والبدع التي لا تخرج صاحبها عن الملة، وإن حكمنا عليه بالابتداع والانحراف.
ولا مانع أن نتعاون مع بعض المبتدعين فيما نتفق عليه من أصول الدين ومصالح الدنيا، ضد من هم أغلظ منهم في الابتداع، أو أرسخ في الضلال والانحراف، وفقًا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين.
والكفر نفسه درجات، فكفر دون كفر، كما ورد عن الصحابة والتابعين. ولا مانع من التعاون مع أهل الكفر الأصغر، لدرء خطر الكفر الأكبر. بل قد نتعاون مع بعض الكفار والمشركين -وإن كان كفرهم وشركهم صريحًا مقطوعًا به- دفعا لكفر أشد منه عداوة أو خطرًا على المسلمين.
وفي أوائل سورة الروم، وما عرف من سبب نزولها: ما يشير إلى أن القرآن اعتبر النصارى -وإن كانوا كفارًا في نظره- أقرب إلى المسلمين من المجوس عبدة النار، ولهذا حزن المسلمون لانتصار الفرس المجوس أولاً على الروم من نصارى بيزنطة، على حين كان موقف المشركين بالعكس؛ لأنهم يرون المجوس أقرب إلى عقيدتهم الوثنية.
فنزل القرآن يبشر المسلمين أن هذا الوضع سيتغير، وتتجه الريح لصالح الروم في بضع سنين، {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ} (الروم:4-5). يقول القرآن: {الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} (الروم:1-5).
وقد استعان النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد فتح مكة ببعض مشركي قريش في مواجهة مشركي هوازن، وإن كان شركهما في درجة واحدة، لما لمشركي قريش من الصلة النسبية الخالصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحميتهم له من ناحية العصبية، حتى قال صفوان بن أمية قبل أن يسلم: لأن يربني -أي يسودني- رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن!
وأهل السنة -رغم تبديعهم للمعتزلة- لم يمنعهم ذلك أن يستفيدوا من إنتاجهم العلمي والفكري، في المواضع المتفق عليها، كما لم يمنعهم ذلك أن يردوا عليهم فيما يرونهم خالفوا فيه الصواب، وحادوا عن السنة.
وأبرز مثل لذلك كتاب "الكشاف" في التفسير للعلامة الزمخشري، وهو معتزلي معروف، ولكن لا نجد عالمًا من بعده ممن له اهتمام بالقرآن وتفسيره إلا أخذ منه وأحال عليه، كما هو واضح في تفاسير الرازي والنسفي والنيسابوري وي وأبي السعود والألوسي وغيرهم. ولأهميته عندهم نجد رجلاً كالحافظ ابن حجر يخرج أحاديثه في كتاب سماه "الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف"، ونجد العلامة ابن المنيّر يؤلف كتابًا في التعقيب عليه، خصوصًا في مواضع الخلاف يسميه "الانتصاف من الكشاف".
والإمام أبو حامد الغزالي حين رد على الفلاسفة، الذين كانت أقوالهم فتنة لكثير من الناس، حتى غدت أصلاً تحاكم إليه نصوص القرآن والسنة، فإن وافقته فبها، وإلا أعمل فيها مشرط التأويل، مهما تكن قاطعة الدلالة. أقول: حين قام بهذه المهمة استعان عليها بكل الفرق الإسلامية التي لم تبلغ درجة الكفر، ولهذا لم يجد حرجًا أن يأخذ من المعتزلة وأمثالهم ما ينقض به قول الفلاسفة، وقال في ذلك في مقدمة "التهافت": "ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة، وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض، ببيان وجوه تهافتهم، فلذلك أنا لا أدخل عليهم إلا دخول مطالب منكر، لا مدع مثبت، فأكدر عليهم ما اعتقدوه، مقطوعًا بإلزامات مختلفة، فألزمهم تارة مذهب المعتزلة، وأخرى مذهب الكرامية، وطورًا مذهب الواقفية، ولا أنتهض ذابًا عن مذهب مخصوص، بل أجعل جميع الفرق إلبًا واحدًا عليهم، فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين، فلنتظاهر عليهم، فعند الشدائد تذهب الأحقاد" (من المقدمة الثالثة للتهافت).
والأخ الذي يقول: كيف نعذر من يخالفنا إذا كان هو مخالفًا للنص القرآني أو النبوي، والله تعالى يقول: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (النساء:59)؟ هذا الأخ غاب عنه أمر مهم، هو: أن النصوص تختلف في ثبوتها ودلالتها اختلافًا كبيرًا من حيث القطعية والظنية.
فمن النصوص ما هو قطعي الثبوت كالقرآن الكريم، والأحاديث المتواترة ،وهي قليلة، وألحق بعض العلماء بها أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول، واحتفت بها القرائن المتنوعة، حتى أصبحت تفيد العلم اليقيني، ونازعهم في هذا آخرون، ولكل أدلته. ومنها ما هو ظني الثبوت، وهو جمهرة الأحاديث من الصحاح والحسان التي رويت في كتب السنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات المختلفة.
وفي دائرة الظنية تتفاوت درجات الحديث ما بين الصحة والحسن، بالذات أو بالغير، تبعًا لتفاوت الأئمة في شروط التوثيق والتصحيح للحديث، من حيث السند أو المتن، أو كلاهما، فقد يقبل أحدهم المرسل ويحتج به، وقد يقبله آخر بشروط، وقد يرفضه غيره بإطلاق. وقد يوثق أحدهم راويًا، هو عند غيره ضعيف.
وقد يشترط بعضهم شروطًا خاصة في موضوعات معينة تتوافر الدواعي على نقلها، فلا يكفي فيها نقل فرد، وهذا ما جعل بعض الأئمة يقبل بعض الأحاديث، ويستنبط منها أحكامًا، في حين يردها إمام آخر لأنها لم تثبت لديه، ولم تستوف الشروط التي بها يغدو الحديث عنده صحيحًا، أو عارضها عنده معارض أقوى منها، كأن يكون العمل على خلافها.
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر، يعرفها الدارسون لأحاديث الأحكام، وللفقه المقارن، وللفقه المذهبي في كتبه التي تعنى بالتدليل للمذهب والرد على المخالفين.
وكما تختلف النصوص في ثبوتها، تختلف أكثر وأكثر في دلالتها، فمن النصوص ما هو قطعي الدلالة على الحكم، بحيث لا يحتمل النص وجهًا آخر للفهم والتفسير، كدلالة النصوص الآمرة بالصلاة والزكاة والصيام والحج على فرضيتها، ودلالة النصوص الناهية عن الزنا والربا وشرب الخمر ونحوها على حرمتها، ودلالة معظم النصوص القرآنية التي وردت في تقسيم المواريث.
وهذا النوع من النصوص قليل جدًا.
ومن النصوص ما هو ظني الدلالة، على معنى أنها تحتمل أكثر من وجه في فهمها وتفسيرها.
فقد يفهمه بعض العلماء على أنه عام وهو عند غيره مخصوص.
أو على أنه مطلق، وهو في نظر الآخرين مقيد.
أو على أنه حقيقة وغيره يراه من باب المجاز.
أو على أنه محكم وهو في رأي آخر منسوخ.
أو على أنه يفيد الوجوب وسواه لا يجاوز به الاستحباب.
أو على أنه يدل على الحرمة، والآخر لا يرى في دلالته أكثر من الكراهية.
والقواعد الأصولية التي قد يظن البعض أنها كافيه ليرجع الجميع إليها، فيحسم الخلاف، وينقطع النزاع، هذه القواعد ذاتها هي موضع خلاف في كثير من جوانبها، ما بين مثبت وناف، ومطلق ومقيد.
خذ مثلاً: دلالة الأمر، هل تفيد صيغة الأمر الوجوب؟ أو الاستحباب؟ أو ما هو مشترك بينهما؟ أو لا تفيد شيئًا إلا بقرينة؟ أم يختلف أمر القرآن عن أمر السنة؟ الخ. سبعة أقوال ذكرها الأصوليون في دلالة الأمر، ولكل قول دليله ووجهته.
فإذا جاء حديث مثل: "أحفوا الشوارب، ووفروا اللحى"، أو حديث: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"، أو حديث: "من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له"، أو حديث: "سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك".
فهل هذه الأوامر تفيد الوجوب أو الاستحباب أو الإرشاد؟ أو كل أمر منها له حكمه الخاص بدلالة السياق والقرائن؟
ومثل ذلك يقال في دلالة النهي: هل تفيد بصيغته التحريم أو الكراهية أو ما هو مشترك بينهما أم لا تفيد شيئًا إلا بقرينة خاصة أو يختلف النهي في القرآن عن النهي في السنة؟
سبعة أقوال أيضًا حفلت بها كتب الأصول.
وهناك الاختلاف في العام والخاص والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمنسوخ.. إلخ.
وحتى ما اتفق عليه من ناحية المبدأ، قد يختلف عليه من جهة التطبيق، فقد يتفق الطرفان على جواز النسخ ووقوعه، ولكنهما يختلفان في نص معين: هل هو منسوخ أم لا؟ كما في حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم "، وحديث وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة فقط في عهد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر، وصدر خلافة عمر.
وقد يتفق الطرفان على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصدر عنه بعض الأقوال والتصرفات بصفة الإمامة والرياسة للأمة، وهذه لا تكون من التشريع العام الدائم للأمة ولكنهما يختلفان في قول معين أو تصرف معين أهو من هذا الباب أم لا؟
وذلك مثل ما ذكره الإمام القرافي في كتابيه: "الفروق " و"الأحكام" من التمثيل بقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل قتيلاً فله سلبه"، وقوله: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له": أَصَدر عنه هذا بصفة التبليغ عن اللّه، فيعتبر هذا من التشريع العام الدائم؟ أم صدر عنه بصفته إمام المسلمين ورئيس دولتهم، وقائدهم الأعلى في معاركهم فلا ينفذ حكمها إلا إذا صدر عن القائد أو الإمام؟
اختلف الفقهاء في تكييف ذلك، فاختلفت لذلك أحكامهم.
وقد يتفقان على أن من أقواله وتصرفاته -صلى الله عليه وسلم- ما ليس من باب التشريع الديني المتعبد به، بل هو من أمر الدنيا الموكول إلى تقدير البشر واجتهادهم، كما قال في الصحيح: " أنتم أعلم بأمر دنياكم " ولكنهما يختلفان في قول أو تصرف معين: أهو من أمر الدنيا الذي لا نلزم باتباعه، أم من أمر الدين الذي لا يجوز لنا الخروج عنه؟
ومن ذلك الوصفات الطبية التي جاءت في عدد من الأحاديث، واعتبرها الإمام الدهلوي من أمر الدنيا، على حين بالغ آخرون فاعتبروها دينًا وشرعًا مطاعًا.
وهناك سبب من أهم الأسباب للخلاف في تفسير النصوص وفهمها، وهو الخلاف ما بين مدرسة "الظواهر" ومدرسة " المقاصد "، أعني المدرسة التي تقف عنـد ظواهر الألفاظ، وتتقيد بحرفية النص في فهمها، وفي مقابلها المدرسة التي تهتم بالفحوى، وبروح النص ومقصده، فقد تخرج عن ظاهر النص وحرفيته، تحقيقًا لما ترى أنه مقصد النص وهدفه.
وهاتان المدرستان موجودتان في الحياة في كل الأمور، وفي القوانين الوضعية أيضًا نجد الشراح يختلفون كذلك ما بين مدرسة اللفظ ومدرسة الفحوى، أو بين المضيقين والموسعين.
والإسلام لأنه دين واقعي وسع المدرستين جميعًا، ولم يعتبر إحداهما خارجة عن الإسلام، وإن كانت مدرسة " المقاصد " في رأينا هي المعبرة عن حقيقة الإسلام، بشرط ألا تهمل النصوص الجزئية إهمالاً كليًا.
وفي سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما يؤيد قبول هذا النوع من الاختلاف، وذلك في الواقعة الشهيرة، وهي واقعة صلاة العصر في بني قريظة، بعد غزوة الأحزاب.
روى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعنف واحدًا منهم (رواه البخاري في: "كتاب المغازي" باب "مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة"، (4119) الفتح، ورواه مسلم أيضًا في: الجهاد (1770) وجعل الصلاة هي الظهر، وقد روي الحديث من طريق كعب بن مالك وعائشة وفيه: أن الصلاة العصر. كما في الفتح 7/408،409).
قال العلامة ابن القيم في "زاد المعاد":
(واختلف الفقهاء: أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالاً لأمره، وتركًا للتأويل المخالف للظاهر.
وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد، وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها، والمبادرة إليها، والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وُتِر أهله وماله، أو قد حبط عمله (أخرجه البخاري 2/26،53 من حديث بريدة بلفظ: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، وأخرجه مسلم (626) من حديث ابن عمر بلفظ: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله" وهو في البخاري 4/24)، فالذي جـاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها، وأما المؤخرون لها، فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرًا واحدًا، لتمسكهم بظاهر النص، وقصدهم امتثال الأمر، وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئًا، فحاشا وكلا، والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين، فلهم أجران، والآخرون مأجـورون أيضًا رضي اللّه عنهم) (زاد المعاد 3/131).
والمقصــود بعد هذا كله أن نقول: إن من خالفنـا في نص قطعي الثبـوت والدلالـة لا يستحق منا أن نعذره بحال، لأن القطعيات لا مجـال فيها للاجتهاد، وإنما مجـاله الظنيات، وفتح باب الاجتهاد في القطعيات إنما هو فتح لباب شر وفتنة على الأمة لا يعلم عواقبها إلا اللّه تعالى؛ لأن القطعيات هي التي يرد إليها عند التنازع، وهي التي تحكَّم عند الاختلاف، فإذا أصبحت هي موضع تنازع واختلاف، لم يبق في أيدينا شيء نحتكم إليه، ونعول عليه!
وقد نبهت في أكثر من كتاب لي إلى أن من أشد الفتن والمؤامرات الفكرية خطرًا على حياتنا الدينية والثقافية، تحويل القطعيات إلى ظنيات، والمحكمات إلى متشابهات.
بل قد تكون المخالفة في بعض القطعيات من الكفر البواح، وذلك ما بلغ منها المرتبة التي يسميها علماؤنا «المعلوم من الدين بالضرورة» وهو ما اتفقت الأمة على حكمه، وتساوى في معرفته الخاص والعام، مثل فرضية الزكاة والصيام، وحرمة الربا وشرب الخمر، ونحوها من ضروريات دين الإسلام.
أما من خالفنا في نص ظني، لسبب من الأسباب التي ذكرناها أو ما شابهها مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"، وقد ذكر فيه عشرة أسباب أو أعذار، تجعل الإمام من الأئمة لا يأخذ بنص أو بحديث معين، وهذا من عظيم فقهه وإنصافه -رضي اللّه عنه- فهذا نعذره وإن لم نوافقه على رأيه.
فهكذا ينبغي أن يكون موقفنا، وهو موقف التسامح مع المخالفين ما دام لهم مستند، يعتمدون عليه، ويطمئنون إليه، وإن خالفناهم نحن في ترجيح ما رجحوه.
فكم من قول اعتبر في وقت من الأوقات ضعيفًا أو مهجورًا، أو شاذًا، ثم هيأ اللّه له من ينصره ويقويه ويشهره، كما رأينا ذلك بجلاء في أقوال الإمام ابن تيمية، ومدرسته السلفية، وخصوصًا في مسائل الطلاق وما يتعلق بها، فقد ارتضاها الكثيرون من علماء المسلمين ولجان فتاواهم، وأصبحت هي عمدتهم، وأنقذ اللّه بها الأسرة المسلمة من الدمار والانهيار، وكانت إلى عهد قريب مثالاً للشذوذ والشرود عن الصواب، حتى في داخل المملكة العربية السعودية.
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين.



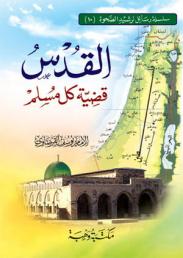 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






