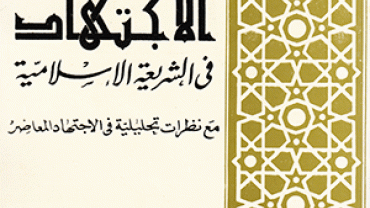الحقيقة أن سيد قطب وتنظيمه لم يحاكما من أجل "الأعمال الخطيرة" التي ارتكبها؛ ولكن حوكم كلاهما من أجل "الأفكار الخطيرة" التي اعتنقها أو دعا الناس إليها. ولو أنصفوا وامتلكوا الشجاعة لقالوا: إننا حاكمنا الرجل -بل حكمنا عليه بالإعدام- من أجل أفكاره لا من أجل أعماله.
والعجيب أن الذي كان يحاكم أفكار سيد قطب ضابط محدود الثقافة، قليل البضاعة من العلم والفكر، وإن كان لواء في الجيش، فإن كان لابد من محاكمة فكر سيد قطب فلتُكوَّن له لجنة من كبار العلماء والمفكرين، تناقشه فيما ذهب إليه.
لقد أخطأ عبد الناصر ورجال أجهزته من شمس بدران ووزارة الدفاع، وأجهزة المخابرات العامة، والمخابرات العسكرية وغيرهم؛ حين ظنوا أن "الأفكار" تُحارب بالاعتقال والسجن والتعذيب والإعدام. إنما تحارب الفكرة بالفكرة، والحجة بالحجة، واللسان باللسان، والقلم بالقلم، ولا تحارب الفكرة بالقوة، ولا الحجة بالسجن، ولا اللسان بالسنان، ولا القلم بالسيف.
لقد حوكم سيد قطب على أخطر كتاب ألفه، وهو كتاب "معالم في الطريق"؛ فهو الذي تتركز فيه أفكاره الأساسية في التغيير الذي ينشده، وإن كان أصله مأخوذًا من تفسيره "في ظلال القرآن" في طبعته الثانية، وفي أجزائه الأخيرة من طبعته الأولى. كان الكتاب قد طبع منه عدد محدود في طبعته الأولى التي نشرتها "مكتبة وهبة"، ولكن بعد أن حُكم بإعدام سيد قطب، وبعد أن كتبت له الشهادة؛ أصبح الكتاب يُطبع في العالم كله بعشرات الآلاف.
وصدق ما قاله عليه رحمة الله: "ستظل كلماتنا عرائس من الشمع لا روح فيها ولا حياة، حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح، وكُتبت لها الحياة!"، فهم في الحقيقة لم يقاوموا أفكار سيد قطب، بل ساهموا مساهمة فعالة في إذاعتها ونشرها!
الحكم بالإعدام
حوكم سيد قطب أمام "محكمة عسكرية" تتكون من ضباط كبار، والأصل في المحاكم العسكرية أن تحاكم العسكريين من الضباط والجنود فيما خالفوا فيه النظام والقوانين العسكرية، وهذا طبيعي ومنطقي أن يحاكم العسكريون عسكريين مثلهم، وهم أولى بهم. ولكن المشكلة تكمن حين يحاكم العسكريون المدنيين في تهم لا تتعلق بالجانب العسكري؛ فهذا ما تلجأ إليه الأنظمة الديكتاتورية تحت شعار الأحكام العرفية أو أحكام الطوارئ؛ ليحكموا على خصومهم السياسيين أو العقائديين بما لا ترضاه المحاكم المدنية.
وأكثر من ذلك أن يحاكم العسكريون كبار رجال العلم والفكر والقانون، كما رأينا قائد الجناح جمال سالم يحاكم أمثال: حسن الهضيبي، وعبد القادر عودة، ومحمد فرغلي.
ورأينا اللواء فؤاد الدجوي يحاكم سيد قطب؛ فإن من العجب حقًا أن يحاكم رجل عسكري -مهما تكن خبرته ومعرفته- رجلًا في حجم سيد قطب الأديب الناقد العالم المفكر!!
وفي نهاية المحاكمة التي راقبها الكثيرون في كل مكان؛ فوجئ الناس بالحكم على ثلاثة من المتهمين بالإعدام، وعلى آخرين بأحكام متفاوتة. وقد قوبل الحكم بالإعدام على سيد قطب وصاحبيه بالدهشة والاستغراب والإنكار، بل الرفض والاحتجاج من أنحاء العالم العربي والإسلامي، وقامت مظاهرات، وأرسلت برقيات، وحدثت وساطات لدى عبد الناصر، وكان الكثيرون يتوقعون أن يستجيب لها؛ فلم يفعل، وسد أذنًا من طين، وأذنًا من عجين، كما يقول المثل.
لقد شنق ستة من قادة الإخوان سنة 1954م من أجل تهمة شروع في قتل عبد الناصر في ميدان المنشية، وإن كنا أثبتنا بالأدلة القاطعة براءة جماعة الإخوان من هذه التهمة، وقول الكثيرين: إن هذه "تمثيلية" وليست حقيقة، إلى آخر ما ذكرناه في الجزء الماضي.
ولكن هناك في الظاهر تهمة شروع في قتل رأس النظام. أما هنا فلم يحدث قتل، ولا شروع في قتل، فعلام يُعدَم هؤلاء؟ وبأي جريمة تُقطَع رقابهم؟! وقد ذكروا هنا أمرًا عجيبًا ينبغي أن نسجله؛ ذلك أن شمس بدران وحسين خليل مدير المباحث الجنائية عرضا على عبد الناصر خلال محاكمة الشهيد سيد قطب الأحكام التي سيصدرها الدجوي، ومن بينها حكم الإعدام على سيد قطب، واتفقوا مع عبد الناصر على تخفيف حكم الإعدام عليه إلى السجن، أو العفو مع تحديد إقامته أو نحو ذلك؛ لينال عبد الناصر كسبًا شعبيًا يغطي كل ما قيل عن التعذيب، وما سيُقال عن العقوبات التي ستفرض على الآخرين. ولكنهم فوجئوا بعبد الناصر يصدق على حكم الإعدام وينفذه!(1).
إن دم سيد قطب ورفيقيه سيظل لعنة على من سفكوه بغير حق، وسيظل يطاردهم، حتى يثأر له القدر من الطغاة الظالمين، ويستجيب لدعاء المظلومين الذي يرفعه الله فوق الغمام، ويفتح له أبوب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
سِهام الليل لا تُخطِي ولكن لها أَمَدٌ وللأمد انقضاء
فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء
مَن المسئول عن هذه الدماء؟
كان المسئول الأول عن دماء الإخوان في المرات السابقة، وعن محنتهم بصفة عامة وزارة الداخلية المصرية، وأجهزة الأمن فيها، وبخاصة "المباحث العامة" التي سُميت فيما بعد "مباحث أمن الدولة". كانت هي التي تعتقل، وهي التي تتهم، وهي التي تحقق، وإن شاركتها وزارة الحربية ببعض الأشياء، مثل السجن الحربي بزنازينه وزبانيته وقائده المتجبر حمزة البسيوني.
أما المسئول الأول عن دماء الإخوان ومحنتهم في هذه المرة؛ فهو "وزارة الحربية" ووزيرها: شمس بدران، وإن شاركتها الداخلية بالمساعدة في القبض والاعتقال وغيرها. ولكن ما مدى مسئولية جمال عبد الناصر في هذه المحنة وتبعاتها؟
لقد حاول بعض الناصريين أن يقلل من مسئوليته ويخفف منها؛ لأنه في هذه الفترة من الزمن لم يكن هو الذي يحكم مصر في الحقيقة والواقع، إنما كان الحاكم الحقيقي لمصر هو المشير عبد الحكيم عامر الذي جمع السلطات كلها في يديه: العسكرية والمدنية، وأصبح لا يُبرَم أمر من الأمور إلا بعد أن يمر على عامر، وبات عبد الناصر بمثابة الملك الذي يملك ولا يحكم..
وكان عامر يفعل ذلك بحكم نفوذه في القوات المسلحة، حتى قالوا: إن عبد الناصر عرض عليه مرة أن يعينه نائبًا لرئيس الجمهورية، ويدع الجيش والقوات المسلحة، ولكنه رفض؛ ليقينه أن من يملك القوات المسلحة يملك البلد كله. وهذا الذي قاله الكثيرون؛ أكده السيد حسين الشافعي عضو مجلس قيادة الثورة في أحاديثه مع أحمد منصور في برنامج "شاهد على العصر" الذي تقدمه قناة الجزيرة.
ومع تصديقي بهذه المقولة لا أعفي عبد الناصر من مسئوليته التاريخية عن هذه المأساة؛ فهو الذي أعلن عنها من "موسكو"، وذكر في خطابه الشهير هناك قائلًا: إننا سنضرب بيد من حديد، وإننا لن نرحم هذه المرة، كأنه قد رحم في المرة السابقة!
وقد أكد الكثيرون من المعتقلين -الذين كانت السياط تشوي جلودهم في زنازين التعذيب- أنهم رأوا بأعينهم عبد الناصر يحضر مشاهد التعذيب مع رجاله، ومن ذلك ما ذكرته الأخت المؤمنة الصابرة المحتسبة الحاجة زينب الغزالي التي ذكرت في كتابها "أيام من حياتي" ما لاقت من الأهوال، التي لا تكاد تُصدق من بشاعتها، وقالت: إنها رأت جمال عبد الناصر في إحدى مرات التعذيب.
وهو -على كل حال- الرئيس المسئول دستوريًا وقانونيًا عما تفعله حكومته، وهو الذي صدَّق على حكم إعدام سيد قطب، وهو الذي رفض أية شفاعة فيه، وأصم أذنيه عن استغاثات العرب والمسلمين أن لا ينفذ حكم الإعدام، وأصر على أن ينفذ في الرجل الأديب العالم المفكر الداعية الكبير حكم الإعدام. فمهما يحاول محامو الناصرية أن يبرئوا الرجل عن التبعة؛ فإن الثابت بيقين أنه مسئول عنها أمام الله سبحانه، وأمام الشعب، وأمام التاريخ.
على أنّا سنثبت عند حديثنا عن "النكسة" أن المسئول عن كل تجاوزات عامر وانحرافاته هو عبد الناصر!
وقفة مع الشهيد سيد قطب
لا يشك دارس منصف ولا راصد عدل في أن سيد قطب مسلم عظيم، وداعية كبير، وكاتب قدير، ومفكر متميز، وأنه رجل تجرد لدينه من كل شائبة، وأسلم وجهه لله وحده، وجعل صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له.
ولا شك في إخلاص سيد قطب لفكرته التي آمن بها، ولا يُشَك في حماسه لها، وفنائه فيها، وأنه وضع رأسه على كفه، وقدم روحه رخيصة من أجلها، ولا ريب أنه قضى سنوات عمره الأخيرة وهو في السجن يجلي الفكرة، ويشرحها بقلمه المبدع، وبيانه العذب، وأسلوبه الأخاذ، كما لا ريب أن كتبه تعطي قارئها شحنة روحية وعاطفية دافقة ودافئة ودافعة، توقظه من رقود، وتحركه من سكون؛ لما فيها من حرارة وإخلاص.
وهذه الفكرة هي التي انتهى إليها تطوره الفكري والعلمي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، في مجال الأدب والنقد، وفي مجال الدعوة والفكر، ولابد لمن يريد أن يفهم سيد قطب أن يحيط بمراحل حياته وتطوره فيها؛ حتى يعرف حقيقة موقفه الذي انتهى إليه.
مرحلة الأدب والنقد
أول ما ظهر سيد قطب ظهر أديبًا شاعرًا، ثم ناقدًا أدبيًا. كان شاعرًا رقيقًا مرهف الحس، دافق العاطفة، يحسبه الناقدون على "الاتجاه الرومانسي" في الشعر، وعده د. محمد مندور في جماعة "أبولو" ذات الاتجاهات الرومانسية المعروفة.
ومِن المعروف أنه كان في أدبه النثري محسوبًا على "مدرسة العقاد"، وكان العقاد يمثل "المدرسة الليبرالية" والفكر الحر، ولم يكن قد ظهر توجهه الإسلامي الذي اتضح في كتاباته الأخيرة.
وكان الذي يمثل "المدرسة الإسلامية" في الأدب هو مصطفى صادق الرافعي. وكان بين الاتجاهين أو المدرستين صراع دامٍ؛ سلاحه القلم، وميدانه المجلات الأدبية كالرسالة والثقافة وغيرهما، والكتب الأدبية، وقد هاجم الرافعي العقاد في مقالات نُشرت بعد ذلك في كتاب سماه "على السَّفود". لم يكن سيد قطب في هذه المرحلة قد عُرف بتوجه إسلامي واضح، رغم أنه خريج "دار العلوم" وقد عاصر حسن البنا، وإن لم يتعرف عليه وعلى دعوته إلا بعد استشهاده.
وقد ذكر الأستاذ محمود عبد الحليم في كتابه "الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ"(2) واقعة عن سيد قطب في هذه المرحلة، ما زلت في شك من أمرها، وهي: أنه كتب مقالة في الأهرام تدافع عن "العرْي" وأنه من الحرية الشخصية للإنسان، على غرار ما يكتبه دعاة الإباحية، وهذا غريب على مسيرة سيد قطب؛ فلم يكن الرجل -على ما أعلم- في أي فترة من حياته من دعاة التحلل. وأرجو من إخواننا من شباب الباحثين أن يحققوا ويبحثوا في مدى صدق هذه الواقعة.
وقد توج هذه المرحلة من مراحل مسيرته عملان كبيران من الأعمال الأدبية الأصيلة التي لم يقلد سيد قطب فيها أحدًا، بل كان فيها نسيج وحده. أولهما: كتابه عن "أصول النقد الأدبي"، وهو -باعتراف مؤرخي الأدب العربي- عمل متميز، وإن لم يأخذ حقه من الظهور، ربما كان سبب ذلك هو تحول صاحبه إلى الدعوة الإسلامية، وأمسى محسوبًا على عالم الدعاة، لا على عالم الأدباء والنقاد.
وثانيهما: عمله الأصيل المتميز في خدمة القرآن، وإعجازه البياني، بمنهج لم يسبق له نظير، وهذا العمل يتمثل في كتابيه الرائعين:
أ- التصوير الفني في القرآن.
ب- مشاهد القيامة في القرآن.
والكتاب الأول يجسد النظرية، والثاني بمثابة التطبيق لها.
وهذان الكتابان يمثلان تمهيدًا أو همزة وصل للمرحلة القادمة؛ مرحلة الدعوة إلى الإسلام.

مرحلة الدعوة الإسلامية
والمرحلة الثانية في حياة سيد قطب هي مرحلة الدعوة إلى الإسلام؛ بوصفه عقيدة ونظامًا للحياة يقيم العدالة الاجتماعية في الأرض، ويرفع التظالم بين الناس، ويرعى حقوق الفقراء والمستضعفين بوسيلتين أساسيتين، هما: التشريع القانوني، والتوجيه الأخلاقي.
وكان هذا التطور له مقدمات وعلامات، منها: اهتمامه بقضية المظالم الاجتماعية في مصر، وسيطرة الإقطاع المتجبر في الأرياف، والرأسمالية الاحتكارية المستغلة في المدن على الاقتصاد المصري، وضياع الفلاحين والعمال -وهم جل المصريين- بين تجبر أولئك وتسلط هؤلاء.
وقد بدا هذا التوجه واضحًا في مشاركته في مجلة "الفكر الجديد" التي كانت تعنى بهذا الجانب الاجتماعي، والتي لم تدم طويلًا، وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الثاني من هذه المسيرة، ولعل كتابيه السالفين في خدمة البيان القرآني قد مهدا له الطريق؛ ليطل على "المضامين" الإصلاحية العظيمة التي اشتمل عليها القرآن، وإن كانت دراسته أساسًا تهتم بالشكل والأسلوب.
ظهر أول كتاب له في هذه المرحلة، وهو: كتاب "العدالة الاجتماعية في الإسلام" الذي عرض الموضوع بطريقة منهجية، بيَّن فيه أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام، وإن كان الشيخ الغزالي رحمه الله له فضل السبق بتناول هذه الموضوعات في مقالاته التي كان ينشرها في مجلة "الإخوان المسلمون"، ثم جمعها في كتبه: "الإسلام والأوضاع الاقتصادية"، "الإسلام والمناهج الاشتراكية"، "الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين"، ولكن هذه الكتب لم تُكتب بالطريقة المنهجية التي كتب بها سيد قطب؛ لأنها في الأصل مقالات، تجلي جوانب مهمة في هذا الجانب الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام.
ولا شك أن الشهيد سيد قطب قد استفاد من كتب الغزالي، وإن لم ينقل منها بالحرف، وإنما اقتبس كثيرًا من الأفكار؛ ولهذا جعل من مصادره في الطبعة الأولى للكتاب: "الإسلام والأوضاع الاقتصادية" و"الإسلام والمناهج الاشتراكية"، ثم حُذفا بعد ذلك مع قائمة المصادر كلها.
استقبلت الأوساط الإسلامية كتاب "العدالة" بالحفاوة والترحيب؛ باعتباره أول مولود لسيد قطب في عهده الجديد، واستبشروا بأن التيار الإسلامي قد كسب كاتبًا له وزنه الأدبي، وقلمه البليغ؛ فهو يعتبر إضافة لها قيمتها إلى هذا التيار، تعوض الخسارة التي لحقت به بانضمام الشيخ خالد محمد خالد إلى التيار العلماني؛ فكأن عدالة الأقدار عوضت عن خالد بسيد، وعن كتاب "مِن هنا نبدأ" بكتاب "العدالة الاجتماعية في الإسلام".
وغمرت الإخوان خاصة فرحة بهذا القلم الجديد الذي انضم إلى القافلة الإسلامية، وكأنه كان مكافأة لهم بعد خروجهم من معتقلات الطور و"هايكستب" وسقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي قاتلة حسن البنا، وصاحب التاريخ الأسود، والعسكري الأسود!
ولم يكتفِ سيد قطب بهذا الكتاب بل أتبعه بكتب أخرى: "معركة الإسلام والرأسمالية" و"السلام العالمي والإسلام"، ومقالات عدة كتبها في مجلة "الدعوة" التي يصدرها الإخوان، ومجلة "الاشتراكية" التي يصدرها حزب العمل، ومجلة "اللواء" التي يصدرها الحزب الوطني، ولكن هذه المقالات كانت كلها "تحت راية الإسلام". وهي التي جُمعت بعد ذلك تحت عنوان "دراسات إسلامية"، ومنها مقال عن "حسن البنا وعبقرية البناء"، نقلت خلاصته في كتابي "الإخوان المسلمون.. سبعون عامًا في الدعوة والتربية والجهاد".
وفي هذه الفترة بدأ يكتب تفسيره الشهير الذي لم يسمه تفسيرًا، ولكنه رضي أن يسميه "في ظلال القرآن" وصدق في تسميته، فلم يكن في طبعته الأولى يحمل الطابع الرسمي للتفسير، ولكنها وقفات عقل متدبر، وقلب حي، ووجدان مرهف أمام القرآن، يلتمس عظاته، ويجلي إعجازه، ويُبيِّن حقائقه، ويُنبِّه على مقاصده، وإن تغير ذلك في الأجزاء الأخيرة، وفي الطبعة الثانية للأجزاء الأولى، فقد بدأ يهتم بالجانب التفسيري، حتى أحسب أنه أفرغ خلاصة تفسير ابن كثير في "ظلاله".
وفي هذه الفترة بدأ سيد قطب يقترب من الإخوان، ويرى بعينيه نشاطهم والتزامهم، وما بينهم من رباط وثيق، وإخاء عميق، وما يتميز به كثير منهم من وعي دقيق، وشعور رقيق، وكان المرشد العام الأستاذ حسن الهضيبي يصطحبه معه في رحلاته، ليرى بعينيه، ويسمع بأذنيه، ويحكم بعد ذلك بعقله، ويختار لنفسه.
وقد اختار بملء إرادته الانضمام إلى دعوة الإخوان، ولا سيما بعد أن خاب ظنه في رجال الثورة، الذين علق عليهم في أول الأمر آمالًا وأحلامًا، فتبخرت وضاعت، كما تبخرت أحلام الشاعر العاشق الذي قال: كأني من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع
وأحيل القارئ إلى ما ذكرته في الجزء السابق عن سيد قطب وانضمامه إلى الإخوان، وتسلمه رئاسة قسم نشر الدعوة في الجماعة، ورئاسة تحرير مجلتهم، إلى أن دخل معهم في محاكمات "محكمة الشعب" وحكم عليه بعشر سنوات.
مرحلة الثورة الإسلامية
وهذه مرحلة جديدة تطور إليها فكر سيد قطب، يمكن أن نسميها "مرحلة الثورة الإسلامية"، الثورة على كل "الحكومات الإسلامية"، أو التي تدعي أنها إسلامية، والثورة على كل "المجتمعات الإسلامية" أو التي تدعي أنها إسلامية، فالحقيقة في نظر سيد قطب أن كل المجتمعات القائمة في الأرض أصبحت مجتمعات جاهلية.
تكوَّن هذا الفكر الثوري الرافض لكل من حوله وما حوله، والذي ينضح بتكفير المجتمع، وتكفير الناس عامة؛ لأنهم "أسقطوا حاكمية الله تعالى" ورضوا بغيره حكمًا، واحتكموا إلى أنظمة بشرية، وقوانين وضعية، وقيم أرضية، واستوردوا الفلسفات والمناهج التربوية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية وغيرها من غير المصادر الإسلامية، ومن خارج مجتمعات الإسلام.. فبماذا يوصف هؤلاء إلا بالردة عن دين الإسلام؟!
بل الواقع عنده أنهم لم يدخلوا الإسلام قط حتى يحكم عليهم بالردة، إن دخول الإسلام إنما هو النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وهم لم يفهموا معنى هذه الشهادة، لم يفهموا أن "لا إله إلا الله" منهج حياة للمسلم، تميزه عن غيره من أصحاب الجاهليات المختلفة، ممن يعتبرهم الناس أهل العلم والحضارة.
أقول: تكوَّن هذا الفكر الثوري الرافض، داخل السجن، وخصوصًا بعد أن أعلنت مصر وزعيمها عبد الناصر، عن ضرورة التحول الاشتراكي، وحتمية الحل الاشتراكي، وصدر "الميثاق" الذي سماه بعضهم "قرآن الثورة"! وبعد الاقتراب المصري السوفيتي، ومصالحة الشيوعيين، ووثوبهم على أجهزة الإعلام والثقافة والأدب والفكر، ومحاولتهم تغيير وجه مصر الإسلامي التاريخي.
هنالك رأى سيد قطب أن الكفر قد كشف اللثام عن نفسه، وأنه لم يعد في حاجة إلى أن يخفيه بأغطية وشعارات لإسكات الجماهير، وتضليل العوام.
هنالك رأى أن يخوض المعركة وحده، راكبًا أو راجلًا، حاملًا سيفه "ولا سيف له غير القلم" لقتال خصومه، وما أكثرهم. سيقاتل الملاحدة الجاحدين، ويقاتل المشركين الوثنيين، ويقاتل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويقاتل المسلمين أيضًا، الذين اغتالتهم الجاهلية، فعاشوا مسلمين بلا إسلام!
وأنا برغم إعجابي بذكاء سيد قطب ونبوغه وتفوقه، وبرغم حبي وتقديري الكبيرين له، وبرغم إيماني بإخلاصه وتجرده فيما وصل إليه من فكر، نتيجة اجتهاد وإعمال فكر؛ أخالفه في جملة توجهاته الفكرية الجديدة، التي خالف فيها سيد قطب الجديد سيد قطب القديم.. وعارض فيها سيد قطب الثائر الرافض سيد قطب الداعية المسالم، أو سيد قطب صاحب "العدالة" سيد قطب صاحب "المعالم".
ولقد ناقشت المفكر الشهيد في بعض كتبي في بعض أفكاره الأساسية، وإن لامني بعض الإخوة على ذلك، ولكني في الواقع، كتبت ما كتبت وناقشت ما ناقشت، من باب النصيحة في الدين، والإعذار إلى الله، وبيان ما أعتقد أنه الحق، وإلا كنت ممن كتم العلم، أو جامل في الحق، أو داهن في الدين، أو آثر رضا الأشخاص على رضا الله تبارك وتعالى.
ونحن نؤمن بأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أحد غيره يؤخذ من كلامه ويُردُّ عليه، وأن ليس في العلم كبير، وأن خطأ العالم لا ينقص من قدره، إذا توافرت النية الصالحة، والاجتهاد من أهله، وأن المجتهد المخطئ معذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، كما في الحديث الشريف، سواء كان خطؤه في المسائل العلمية أو العملية، الأصولية أم الفروعية، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وغيرهما.
وأخطر ما تحتويه التوجهات الجديدة في هذه المرحلة لسيد قطب؛ هو ركونه إلى فكرة "التكفير" والتوسع فيه، بحيث يفهم قارئه من ظاهر كلامه في مواضع كثيرة ومتفرقة من "الظلال" ومما أفرغه في كتابه "معالم في الطريق"؛ أن المجتمعات كلها قد أصبحت "جاهلية".
وهو لا يقصد بـ "الجاهلية" جاهلية العمل والسلوك فقط، بل "جاهلية العقيدة"، إنها الشرك والكفر بالله، حيث لم ترضَ بحاكميته تعالى، وأشركت معه آلهة أخرى، استوردت من عندهم الأنظمة والقوانين، والقيم والموازين، والأفكار والمفاهيم، واستبدلوا بها شريعة الله، وأحكام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا، ليس الناس في حاجة إلى أن نعرض عليهم نظام الإسلام الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي، أو القانوني، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأنظمة إنما ينتفع بها المؤمنون بها، وبأنها من عند الله. أما من لا يؤمن بها، فيجب أن نعرض عليه "العقيدة أولًا" حتى يؤمن بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، وبالشريعة حاكمة. وهذا ما أشار إليه في كتابه "المعالم" وفصّله في كتاب "الإسلام ومشكلات الحضارة".
وشبه مجتمعاتنا اليوم بمجتمع مكة في عهد الرسالة، وأن الرسول لم يعرض عليه النظام والتشريع، بل عرض عليه العقيدة والتوحيد، كما رأى عليه رحمة الله أن لا معنى لما يحاوله المحاولون من علماء العصر لما سموه "تطوير" الفقه الإسلامي أو "تجديده" أو "إحياء الاجتهاد" فيه؛ إذ لا فائدة من ذلك كله ما دام المجتمع المسلم غائبًا، يجب أن يقوم المجتمع المسلم أولًا، ثم نجتهد له في حل مشكلاته في ضوء واقعنا الإسلامي.
وقد ناقشت أفكاره عن "الاجتهاد" وعدم حاجتنا إليه قبل أن يقوم المجتمع الإسلامي؛ في كتابي "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية" وبينت بالأدلة خطأ فكرته هذه.
وكما ناقشت الشهيد سيد قطب في رأيه حول قضية "الاجتهاد"؛ ناقشته في رأيه في "الجهاد" وقد تبنّى أضيق الآراء وأشدها في الفقه الإسلامي، مخالفًا اتجاه كبار الفقهاء والدعاة المعاصرين، داعيًا إلى أن على المسلمين أن يعدوا أنفسهم لقتال العالم كله، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون!
وحجته في ذلك آيات سورة التوبة، وما سماه بعضهم "آية السيف"، ولم يبال بمخالفة آيات كثيرة تدعو إلى السلم، وقصر القتال على من يقاتلنا، وكف أيدينا عمن اعتزلنا ولم يقاتلنا، ومد يده لمسالمتنا، ودعوتنا إلى البر والقسط مع المخالفين لنا إذا سالمونا، فلم يقاتلونا في الدين، ولم يخرجونا من ديارنا، ولم يظاهروا على إخراجنا.
هذا ما تدل عليه الآيات الكثيرة من كتاب الله مثل قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} (البقرة: 191،190}، {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} (النساء:90).
{فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا} (النساء:91)، {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} (الأنفال:61)، {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الممتحنة:8).
والأستاذ سيد رحمه الله يتخلص من هذه الآيات وأمثالها بكلمة في غاية السهولة؛ أن هذه كان معمولًا بها في مرحلة، ثم توقف العمل بها، والعبرة بالموقف الأخير، وهو ما يعبر عنه الأقدمون بالنسخ، وقولهم في هذه الآيات: نسختها آية السيف.
ولا أدري كيف هان على سيد قطب -وهو رجل القرآن الذي عاش في ظلاله سنين عددًا يتأمله ويتدبره ويفسره- أن يعطل هذه الآيات الكريمة كلها، وأكثر منها في القرآن، بآية زعموها آية السيف؟! وما معنى بقائها في القرآن إذا بقي لفظها وألغي معناها، وبطل مفعولها وحكمها؟! ويقول الشهيد رحمه الله: إننا لا نفرض على الناس عقيدتنا، إذ لا إكراه في الدين، وإنما نفرض عليهم نظامنا وشريعتنا، ليعيشوا في ظله، وينعموا بعدله.
ولكن بماذا نجيب الناس إذا قالوا لنا: إننا أحرار في اختيار النظام الذي نرضاه لأنفسنا، فلماذا تفرضون علينا نظامكم بالقوة؟ إن كل شيء يجرعه الإنسان تجريعًا رغم أنفه يكرهه وينفر منه، ولو كان هو السكر المذاب، أو العسل المصفى! وما الحكم إذا كنا نحن -اليهود أو النصارى أو الوثنيين- أصحاب القوة والمنعة، وأنتم الضعفاء في العدة أو الأقلون في العدد؟ هل تقبلون أن نفرض عليكم نظامنا ومنهج حياتنا؟ كما هو شأن أمريكا اليوم، وتطلعاتها للهيمنة على العالم؟
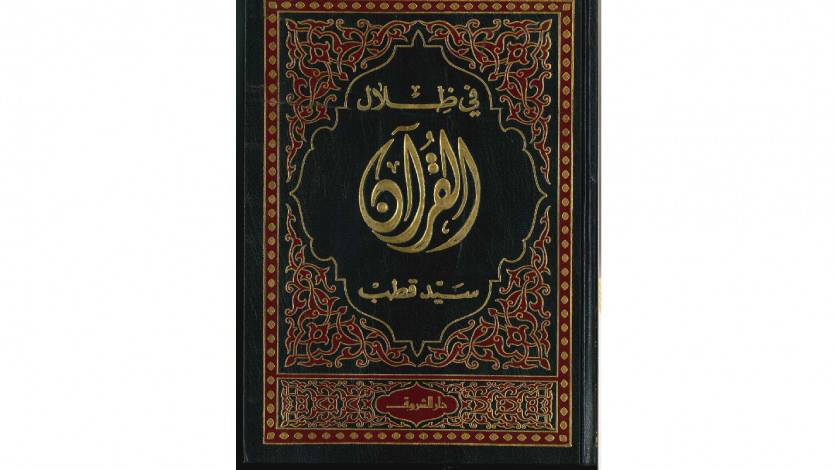
ومما ننكره على الأستاذ سيد رحمه الله أنه يتهم معارضيه من علماء العصر بأمرين:
الأول: السذاجة والغفلة والبله، ونحو ذلك مما يتصل بالقصور في الجانب العقلي والمعرفي.
والثاني: الوهن والضعف النفسي، والهزيمة النفسية أمام ضغط الواقع الغربي المعاصر، وتأثير الاستشراق الماكر مما يتعلق بالجانب النفسي والخلقي.
والذين يتهمهم بذلك هم أعلام الأمة في العلم والفقه والدعوة والفكر، ابتداء من الشيخ محمد عبده، مرورًا بالشيخ رشيد رضا، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ محمد مصطفى المراغي، والمشايخ: محمود شلتوت، ومحمد عبد الله دراز، وأحمد إبراهيم، وعبد الوهاب خلاف، وعلي الخفيف، ومحمد أبو زهرة، ومحمد يوسف موسى، ومحمد المدني، ومحمد مصطفى شلبي، ومحمد البهي، وحسن البنا، ومصطفى السباعي، ومصطفى الزرقا، ومحمد المبارك، وعلي الطنطاوي، ومعروف الدواليبي، والبهي الخولي، ومحمد الغزالي، وسيد سابق، وعلال الفاسي، وعبد الله بن زيد المحمود، ومحمد فتحي عثمان، وغيرهم من شيوخ العلم الديني.
هذا فضلًا عن الكتّاب والمفكرين "المدنيين" الذين لا يُحسبون على العلوم الشرعية، من أمثال: د. محمد حسين هيكل، وعباس العقاد، ومحمد فريد وجدي، وأحمد أمين، ومحمود شيت خطاب، وعبد الرحمن عزام، وجمال الدين محفوظ، ومحمد فرج، وغيرهم وغيرهم في بلاد العرب والمسلمين.
على أية حال، كانت هذه هي الأفكار المحورية في هذه المرحلة من حياة سيد قطب، وفيها عدَّل من أفكاره واتجاهه تعديلًا جذريًا، وأصبح ما كتبه قديمًا في "العدالة الاجتماعية" وغيرها؛ يمثل مرحلة من حياته، ولا يمثل الخط الأخير الذي يتبناه ويدعو إليه، ويدافع عنه.
وقد حدثني الأخ د. محمد المهدي البدري أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب -وكان معه معتقلًا في محنة 1965م- أخبره أن الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله، قال له: إن الذي يمثل فكري هو كتبي الأخيرة: المعالم، والأجزاء الأخيرة من الظلال، والطبعة الثانية من الأجزاء الأولى، وخصائص التصور الإسلامي ومقوماته، والإسلام ومشكلات الحضارة، ونحوها مما صدر له وهو في السجن، أما كتبه القديمة فهو لا يتبناها، فهي تمثل تاريخًا لا أكثر.
فقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذن أنت كالشافعي لك مذهبان: قديم وجديد، والذي تتمسك به هو الجديد لا القديم من مذهبك. قال سيد رحمه الله: نعم، غيرت كما غير الشافعي رضي الله عنه. ولكن الشافعي غير في الفروع، وأنا غيرت في الأصول! فالرجل يعرف مدى التغيير الذي حدث في فكره. فهو تغيير أصولي أو "إستراتيجي" كما يقولون اليوم.
وهو على كل حال مخلص في توجهه، مأجور في اجتهاده، أصاب أم أخطأ؛ ما دام الإسلام مرجعه، والإسلام منطلقه، والإسلام هدفه. وأشهد أن الرجل في المرحلة الأخيرة من حياته، كان كله للإسلام، عاش للإسلام، ومات في سبيل الإسلام! فرضي الله عنه وأرضاه، وجعل الفردوس مثواه، وغفر له ما نحسب أنه أخطأ فيه، وأجره عليه أجر المجتهدين الصادقين. وغفر لنا معه أجمعين، {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (الحشر:10).
تحامل على سيد قطب في فكرة الحاكمية
ولقد اتهم بعض الكاتبين سيد قطب بأنه تبنّى فكرة "الحاكمية" التي أخذها عن المودودي، وجعلها من صلب عقيدة التوحيد، ورتب عليها أحكامًا خطيرة، منها أن الدولة التي تقوم على أساسها أشبه ما تكون بالدولة الدينية، التي تقوم على الحكم بالحق الإلهي. وهذا تحامل ظالم على الرجل.
والحق أن فكرة الحاكمية أساء فهمها الكثيرون، وأدخلوا في مفهومها ما لم يرده أصحابها. وأود أن أنبه هنا على جملة ملاحظات حول هذه القضية:
1- الملاحظة الأولى: أن الحاكمية التي ركز عليها سيد قطب والمودودي، هي الحاكمية بالمعنى التشريعي، ومفهومها أن الله سبحانه هو المشرِّع لخلقه، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحل لهم ويحرم عليهم، وهذا ليس من ابتكار المودودي ولا سيد قطب، بل هو أمر مقرر عند المسلمين جميعًا؛ ولهذا حين قال الخوارج لعلي: لا حكم إلا لله؛ لم يعترض علي رضي الله عنه على المبدأ، وإنما اعترض على الباعث والهدف المقصود من وراء الكلمة، فقال ردًا عليهم: "كلمة حق يراد بها باطل".
وقد بحث في هذه القضية علماء "أصول الفقه" في مقدماتهم الأصولية التي بحثوا فيها عن الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم به، والمحكوم عليه. فها نحن نجد إمامًا مثل أبي حامد الغزالي يقول في مقدمات كتابه الشهير "المستصفى من علم الأصول" عن "الحكم" الذي هو أول مباحث العلم، وهو عبارة عن خطاب الشرع، ولا حكم قبل ورود الشرع، وله تعلق بالحاكم، وهو الشارع، وبالمحكوم عليه، وهو المكلف، وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلف...
ثم يقول: "وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حُكم إلا لله وأن لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه، لا حكم لغيره"(3).
ثم يعود إلى الحديث عن "الحاكم" وهو صاحب الخطاب الموجه إلى المكلفين، فيقول: "أما استحقاق نفوذ الحكم؛ فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي صلى الله عليه وسلم، والسلطان والسيد والأب والزوج؛ فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب من الله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئًا كان للموجَب عليه أن يقلب عليه الإيجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فإذن الواجب طاعة الله تعالى، وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته"(4).
وبهذا نعلم أن فكرة "الحاكمية" ليست من اختراع سيد قطب ولا المودودي؛ بل هي فكرة إسلامية أصيلة، قررها علماء الأصول، واتفق عليها أهل السنة والمعتزلة جميعًا.

2- الملاحظة الثانية: أن "الحاكمية" التي قال بها المودودي وقطب، وجعلاها لله وحده؛ لا تعني أن الله تعالى هو الذي يولي العلماء والأمراء، يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب، أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة، هي التي تختار حكامها، وهي التي تحاسبهم وتراقبهم، بل تعزلهم. والتفريق بين الأمرين مهم، والخلط بينهما موهم ومضلل، كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد كمال أبو المجد، بحق.
فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية، بل هذا ما نفاه كل من سيد قطب والمودودي رحمهما الله. وحسبي هنا أن أذكر قول سيد قطب في "معالمه": "ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم -هم رجال الدين- كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة، كما كان الحال فيما يُعرف باسم الثيوقراطية أو الحكم الإلهي المقدس!! ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة".
3- الملاحظة الثالثة: أن الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون لله وحده، وليست لأحد من خلقه، ونادى بها المودودي وقطب؛ هي الحاكمية "العليا" و"المطلقة" التي لا يحدها ولا يقيدها شيء، فهي من دلائل وحدانية الألوهية، بل من مقومات التوحيد، كما بين القرآن في قوله تعالى: {أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً} (الأنعام:114).
وهذه الحاكمية -بهذا المعنى- لا تنفي أن يكون للبشر قَدْر من التشريع أذن به الله لهم. إنما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع غير مأذون به من الله، وذلك مثل التشريع الديني المحض، كالتشريع في أمر العبادات، والتشريع الذي يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، ويسقط ما فرض الله. أما التشريع فيما لا نص فيه، أو في المصالح المرسلة، وفيما للاجتهاد فيه نصيب؛ فهذا من حق المسلمين؛ ولهذا كانت نصوص الدين في غالب الأمر كلية إجمالية لا تفصيلية؛ ليتاح للناس أن يشرعوا لأنفسهم، ويملئوا الفراغ التشريعي بما يناسبهم(5).
نقطة الضعف في المشروع القطبي:
نقطة الضعف الأساسية في المشروع الفكري والدعوي لسيد قطب - وهو مشروع عملاق بلا ريب - أنه كان شديد الإعجاب بعلامة الهند الكبير: الأستاذ أبي الأعلى المودودي، وأنه اقتبس منه - تقريبًا - جميع الأفكار التي كانت موضع الانتقاد في مشروع المودودي، مثل: الحاكمية، والجاهلية، والقسوة على التاريخ الإسلامي. بل الواقع: أنه رتب على هذه الأفكار من النتائج والآثار ما لم يرتبه المودودي نفسه، ساعده على ذلك قلمه البليغ، وأدبه الرفيع، وبيانه الحيّ الدافق.
فقد تحدث المودودي عن قضية «الحاكمية» الإلهية لهذا الكون، الذي هو مملكة الله وحده، وهو سبحانه ملكها كما أنه مالكها؛ فله وحده التصرف في الحكم فيها، فهو الذي يأمر وينهى كما يشاء، ويحلل ويحرم كما يريد، ويشرع للناس ما يشاء دون منازع، ولا يُسأل عما يفعل؛ وهو ما نطقت به آيات القرآن الصريحة، كما ذكرنا من قبل، مثل: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ} (الأنعام:57)، {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا} (الأنعام:114).
وهذه قضية مسلّمة كما نقلنا من قبل عن علماء أصول الفقه، ولكن المشكلة تقع في الإيحاءات التي تركتها هذه المسألة في الأنفس والعقول، حتى فهم بعض الناس مما قيل في شرحها وتفسيرها: أن لا دور للبشر في التشريع والتقنين، وإن كان تفصيليًّا، أو مصلحيًّا، أو إداريًّا، أو إجرائيًّا.
ولقد وقف كثير من الدعاة والمفكرين موقف النقد لمقولات «الفكر القطبي» التي انفرد بها، واقتبسها من المودودي، والتي انتشرت في «الظلال»، وتجسدت في «المعالم»، ومن هؤلاء من لا يمكن أن يُتهم بأنه يعمل لحساب سلطة أو جهة غير إسلامية.
أذكر من هؤلاء: علّامة الهند، الداعية الإسلامي الكبير: أبا الحسن الندوي، في كتابه «التفسير السياسي للإسلام» الذي انتقد فيه أفكار الأستاذ أبي الأعلى المودودي، والأستاذ سيد قطب، وإن كان تركيزه على المودودي؛ لقوة تأثيره وانتشار كتبه في القارة الهندية، وخالفهما في التهوين من قيمة التنسك والتضرع إلى الله تعالى، والتركيز على الحاكمية بالمعنى السياسي.
كما أذكر من هؤلاء: المفكر المسلم المعروف د. محمد عمارة، الذي نقد المودودي في شدته القاسية، أو قسوته الشديدة على التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، في عبارات صدرت عنه، يقف شعر الرأس عند قراءتها. والله يغفر له، ويأجره على اجتهاده من فضله أجرًا واحدًا. ثم قال د. عمارة: «ومن هذا الغلو المودودي - غيّر المبرر - انطلق الشهيد سيد قطب (1324 - 1386هـ/1906 - 1966م) في لحظات المحنة والتوتر، التي كتب فيها «معالم في الطريق»، فقال: «إنه يدخل في إطار المجتمع الجاهلي، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها «مسلمة»... وهذه المجتمعات تدخل في هذا الإطار لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضًا؛ ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، فهي - وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذا الحاكمية: نظامها، وشرائعها، وقيمها، وموازينها، وعاداتها وتقاليدها، وكل مقومات حياتها تقريبًا. إن موقف الإسلام من هذه المجتمعات كلها يتحدد في عبارة واحدة: إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات».(6)
فإسلام هذه المجتمعات - عند سيد قطب - هو مجرد «زعم» لأنها - وإن لم تعبد غير الله - قد دانت في كل مناحي حياتها لحاكمية غير الحاكمية الإلهية - في النظم والشرائع والقيم والموازين والعادات والتقاليد، وكل مقومات حياتها تقريبًا!!
بل تجاوز سيد قطب مجازفة المودودي، عندما لم يكتف بالحكم بجاهلية «المجتمعات الإسلامية» و«دولها» و«تاريخها» و«ثقافتها» و«حضارتها».. وإنما ذهب فأعلن «انقطاع الأمة الإسلامية عن الوجود منذ قرون»! وأن المهمة التي يدعو إليها، هي إيجاد الأمة والجماعة المسلمة من جديد!
ذهب سيد قطب - في المجازفة - إلى هذا المدى، فكتب يقول: «إن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة.. فالأمة المسلمة ليست «أرضًا» كان يعيش فيها الإسلام، وليست «قومًا» كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي.. إنما «الأمة المسلمة» جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي.. هذه الأمة - بهذه المواصفات - قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعًا.. ولذلك، فالمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحًا.. إن الناس ليسوا مسلمين - كما يدعون - وهم يحيون حياة الجاهلية.. ليس هذا إسلامًا، وليس هؤلاء مسلمين، والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام، ولتجعل منهم مسلمين من جديد».(7)
هكذا حكم سيد قطب - يرحمه الله - على «الأمة» - وليس فقط على «الدول والمجتمعات والحضارة» - بالكفر، والشرك، والجاهلية.. ونفى عن «الأمة» الإيمان، والتوحيد، والإسلام.. «فالناس» - نَعَم «الناس» - عنده ليسوا مسلمين كما يدعون! والمطلوب من الدعوة التي حدد منهاجها في «معالم في الطريق» هو رد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام، لنجعل منهم مسلمين من جديد!
ولقد مضى ليؤكد هذا الحكم الخطير على «الأمة» فقال: «ينبغي أن يكون مفهومًا لأصحاب الدعوة الإسلامية؛ أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين، يجب أن يدعوهم أولًا إلى اعتناق العقيدة، حتى لو كانوا يدعون أنهم مسلمون، وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون! فإذا دخل في هذا الدين عصبة من الناس فهذه العصبة هي التي يطلق عليها اسم: «المجتمع المسلم».(8)
قال د. محمد عمارة: وهذا المستوى من المجازفة في الغلو؛ غير مسبوق في تاريخ الصحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة على الإطلاق!(9). اهـ.
وأقول للدكتور عمارة: إن فكرة التكفير لمسلمي اليوم؛ لم ينفرد بها كتاب «المعالم»؛ بل أصلها في «الظلال» وفي كتب أخرى، أهمها «العدالة» كما سنذكر ذلك في الملاحق، إن شاء الله.
.....
(1) "العشاء الأخير للمشير"، لعبد الصمد محمد عبد الصمد، ص150.
(2) انظر: "الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ" لمحمود عبد الحليم "1/190-192". طبعة دار الدعوة ـ الإسكندرية.
(3) المستصفى: "1/8" طبع دار صادر ببيروت، مصورة عن طبعة بولاق.
(4) المستصفى: "1/83" طبع دار صادر ببيروت، مصورة عن طبعة بولاق. وفي فواتح الرحموت: مسألة: لا حكم إلا من الله تعالى، بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ، إن هذا عندنا، وعند المعتزلة الحاكم العقل، فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الإسلام، بل إنما يقولون: إن العقل معرف لبعض الأحكام الإلهية، سواء ورد به الشرع أم لا، وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا "يعني الماتريدية" "1/25" مع المستصفى.
(5) انظر: كتابنا "بينات الحل الإسلامي" ص163-167.
(6) انظر: «معالم في الطريق» (ص: 101 - 103).
(7) «المعالم» (ص: 8، 173).
(8) المصدر السابق (ص40) .
(9) مِن بحث للدكتور محمد عمارة ألقاه في «ندوة اقرأ» الإعلامية في رمضان (1424هـ) بمكة المكرمة بعنوان: «الخطاب الإعلامي الإسلامي المعاصر ودوره في مواجهة الأفكار المنحرفة المتطرفة باسم الدين».



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين