من المهم أنه في هذه الفترة عُقدت مسابقة لتعيين وعّاظ بالأزهر، وأئمة وخطباء بالأوقاف، وقدمت فيها أنا وعدد من الإخوان، ونحن نعلم أننا ممنوعون من الوظائف المتصلة بالجماهير، ومنها: الخطابة والوعظ، ولكن قلنا: لن نخسر شيئًا إذا قدمنا، فربما نجحنا وقبلنا.
ودخلنا الامتحان دخول من لا يعتقد أن وراءه جدوى، وسرعان ما ظهرت النتيجة، وقد نجح فيه عشرة من الإخوان: أنا، والعسال، وسليمان عطا، وعبد الرءوف عامر، وعبد التواب هيكل، ومحمود جودة، وعبد الحميد شاهين ... إلخ.
وكان ترتيبي هو الثاني في هذه المسابقة، فقد كان الأول هو زميلنا الأخ العالِم الفاضل الشيخ إبراهيم الدسوقي جلهوم، خطيب مسجد السيدة زينب فيما بعد. وبعد نجاحنا كان للشيخ الباقوري وزير الأوقاف موقف رجولة وإنسانية لا ننساه؛ وهو أنه عارض رجال الأمن، وقال: أنا سأعينهم على مسئوليتي، في أعمال غير الخطابة والتدريس. وفعلًا كانت وظيفتنا الرسمية: الإمامة والخطابة، ووظيفتنا الفعلية التي انتدبنا لها - نحن العشرة - العمل بقسم النظار والأوقاف، ومقره سطوح وزارة الأوقاف.
وقد حضرت أنا وأخي العسال يومًا واحدًا في هذا القسم، ثم انتدبنا للعمل في مراقبة الشئون الدينية، وكلفني المراقب العام للشئون الدينية الأستاذ البهي الخولي بالإشراف على «معهد الأئمة»، وكلف العسال بالإشراف على مكتبة إدارة الثقافة بمسجد عمر مكرم.
ومعهد الأئمة ليس له مبنى، ولكنه «فكرة» تقوم على أساس النهوض بمستوى الأئمة، والرقي بثقافتهم، على أساس تنظيم محاضرات لهم في موضوعات إسلامية وفكرية متنوعة: من علماء ومفكرين كبار، توسع من آفاقهم، وتنير من بصائرهم، في فقه حقيقة الدين، وحقيقة الواقع.
وكان من هؤلاء الأعلام: الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز، والدكتور محمد البهي، والشيخ محمد المدني، والدكتور عليّ عبد الواحد وافي، الذي كان يقرأ للأئمة فصولًا من مقدمة ابن خلدون، ويعلق عليها. بالإضافة إلى محاضرات الأستاذ البهي الخولي، والشيخ الغزالي، والشيخ سيد سابق، وكانت المحاضرات تلقى في الطابق الثاني من مسجد عمر مكرم.
الشيخ الباقوري:
وبمناسبة موقف الشيخ الباقوري منا - نحن الإخوان العشرة، أو العشرة الطيبة كما سمَّاها بعضهم - أود أن أقول كلمة هنا عن الشيخ رحمه الله:
كان الشيخ الباقوري طوال حياته من طلاب الأزهر النابهين، وكان خطيبًا مفوّهًا، وشاعرًا مجيدًا، وقد اختاره طلاب الأزهر قائدًا لثورتهم سنة 1940، حين ثاروا على مشيختهم المفروضة عليهم من قبل الملك، الذي أقال شيخهم الأكبر، القريب منهم، والمحبب إليهم: الشيخ محمد مصطفى المراغي.
ثار الأزهر على الظلم الواقع عليه، فقد كان العالِم من خريجي الأزهر في أيٍّ من كلياته يعين براتب قدره ثلاثة جنيهات في معاهد الأزهر، وكان معلم المدرسة الإلزامية خريج مدرسة المعلمين الابتدائية يعيّن بأربعة جنيهات. ولم يجد الأزهريون شيخًا يتبنى مطالبهم غير الشيخ المراغي، وهو من الشيوخ الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة، فثاروا مطالبين بتحسين أوضاعهم، وإعادة شيخهم المراغي لقيادة سفينة الأزهر. ومما ينسب إلى الباقوري من الشعر في هذه الثورة قوله: ثورة الأزهر أرخصنا الدماء ** فكلي الأرض وثنّي بالسماء!
وانتصرت ثورة الأزهر، التي لمع فيها اسم الباقوري زعيم الثورة، حتى أطلقت إحدى الباحثات لقب: «ثائر تحت العمامة» على الشيخ الباقوري، في دراسة لها عن الباقوري ومواقفه وحياته، فلم تجد عنوانًا يعبر عن مواقفه إلا هذا العنوان. وأصهر الباقوري إلى أحد كبار علماء الأزهر، وهو الشيخ محمد عبد اللطيف دراز، الذي تزوج ابنته، وأنجب منها ثلاث بنات.
كان الشيخ الباقوري إلى الأدباء أقرب منه إلى العلماء؛ لذا عُرف بالخطابة والشعر أكثر مما عُرف بالفقه والبحث العلمي. وكان له شعر جميل كنا نحفظه أناشيد تثير فينا مشاعر الحب والحماس للإسلام، ومنها النشيد المعروف:
يا رسول الله، هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا
ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى
أن يرانا الله في ساح الفداء
وهو النشيد الذي اعترض عليه بعض الإخوة السلفيين بأنه يخالف العقيدة الصحيحة؛ لأنه يوحي بأن العمل يكون لإرضاء رسول الله، لا لإرضاء الله. ورأيي أن الشيخ لا يقصد ما ذهب إليه هؤلاء، وإنما يريد أن يقول: هل يسرك يا رسول الله ويفرحك ويقر عينك: أخُوّتنا في الله، وقيامنا لنصرة دينك، والدفاع عن دعوتك ... إلخ.
ولا أعلم أن شعر الباقوري جُمع إلى اليوم، وقد سمعته مرة وقد سُئل عن شعره، فقال في تواضع: إنه من شعر العلماء، وشعر العلماء كعلم الشعراء. وأحسب أن هذا من جميل أدبه وتواضعه، فكثيرًا ما يكون للشعراء علم راسخ، كما يكون للعلماء شعر رائع. ومن هذا: شعر الإمام الشافعي الذي لا يشك دارس في قيمته الأدبية، وعلو مستواه الفني. ومن ذلك قوله:
أمطري لؤلؤًا جبال سرنديـ ـب، وفيضي آبار تبريز تبرا!
أنا إن عشت لست أعدم قوتًا وإذا مت لست أعدم قبرا!
همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا!
وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدًا وعمرا؟
على أننا إذا غلبنا الجانب الأدبي في حياة الباقوري العلمية؛ فمن الإنصاف أن نذكر أن له بعض مؤلفات جيدة، تحمل روح الداعية، وأسلوب الأديب، منها: كتابه: «قطوف من أدب النبوة»، الذي شرح فيه عددًا من الأحاديث شرحًا ميسرًا سلسًا، في متناول القراء العاديين، والكتاب يقع في جزأين صغيرين. وله كذلك كتابه: «من أدب القرآن: تفسير سورة تبارك».
أما ما يدل على عقلية الباقوري البحثية، فهو كتابه الصغير الحجم، الكثير النفع: «أثر القرآن الكريم في اللغة العربية»، وهو كتاب شهد بغزارة علم مؤلفه، وجزالة أسلوبه، وقوة حجته: الأديب المعروف الدكتور طه حسين، حتى كتب مقدمة للكتاب، أثنى فيها على الباقوري وعلمه .كما صدر له - بعد توليه الوزارة - كتاب بعنوان: «عروبة ودين»، ضم مجموعة من المقالات والبحوث القيمة في موضوعات مختلفة، منها: موضوع عن «ذي القرنين في القرآن»، رجح فيه رأي العلامة الهندي أبي الكلام آزاد في الموضوع.
وكان الشيخ الباقوري قد انضم إلى دعوة الإخوان المسلمين من قديم، وبايع الإمام حسن البنا على العمل لنصرة الإسلام، واستعادة مجده، وتحرير أوطانه، والتمكين له عقيدة ونظامًا في حياة المسلمين. وكان عضوًا في الهيئة التأسيسية، ثم بعد ذلك في مكتب الإرشاد العام. وقد ذكرت في الجزء الماضي أننا - نحن طلاب معهد طنطا - حين زرنا المركز العام في إحدى المرات، وطلبنا إلى الإمام البنا أن يلقانا لقاءً خاصًّا، اعتذر البنا لارتباط عنده، ورشّح لنا الشيخ الباقوري ليلتقينا.
وحين أصدر الأستاذ البنا «مجلة الشهاب» حياها الباقوري بقصيدة جميلة من قصائده. كما حيا من قبل مجلة «جريدة الإخوان المسلمين» - وهي أولى مجلات الإخوان - بقصيدة رائعة، عنوانها: «تحيتي». وعندما حل النقراشي جماعة الإخوان في ديسمبر 1948؛ بلغني أن الأستاذ البنا أوصى بأن يكون الباقوري مسئولًا عن الإخوان خارج المعتقل.
وبعد استشهاد الإمام البنا كان اسم الباقوري أحد الأسماء المرشحة لقيادة الجماعة. وفي الانتخابات التي جرت بعد سقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي وحزب السعديين؛ رشّح الشيخ الباقوري نفسه في دائرة الخليفة بالقلعة، كما رشح عدد من الإخوان أنفسهم، وقد شهدته وهو يدور على أماكن التجمعات في الدائرة، ويخطب فيها. وإن لم يحالفه النجاح في النهاية، شأنه شأن كل مرشحي الإخوان: مصطفى مؤمن، وفهمي أبو غدير، وطاهر الخشاب، والشيخ عبد المعز عبد الستار، وعليّ شحاتة، وغيرهم.
وأذكر أني لقيته في تلك الفترة - بعد خروج الإخوان من المعتقلات - في محطة القطار بمدينة طنطا، فهرعت إليه، وسلمت عليه، وعرفته بنفسي، وسألته عن حال الإخوان، فتنفس الصعداء، وشكا إلى الله من سوء الحال. وقال: خير للجماعة أن تكتفي بما أنجزت، وأن تقف عند هذا الحد، وتبقي على هذا التاريخ الناصع، بدل أن تكدر صفاءه بما لا يلائم تراث الجماعة ومواقفها الشامخة في قضايا الوطن والإسلام، ولم أعرف مم كان يشكو بالضبط، وجاء قطاره فركب بسرعة.
وحين اختار الجماعة الأستاذ الهضيبي مرشدًا عامًّا، كان الباقوري أول من بايعه، وكان الهضيبي يصطحب الباقوري كثيرًا في رحلاته إلى محافظات مصر، ويقدمه للحديث إلى الجماهير، وقد صحبته في رحلتين كان الباقوري رفيقه في كلتيهما: إحداهما إلى مدينة السويس، والأخرى إلى مدينة كفر الشيخ.
وكان الباقوري عضوًا في مكتب الإرشاد مع الأستاذ الهضيبي، حتى قامت ثورة 23 يوليو. وحين طلب جمال عبد الناصر ورجال الثورة من الإخوان أن يرشحوا أشخاصًا للوزارة: رشح الأستاذ الهضيبي لهم ثلاثة لم يكن الباقوري بينهم. واختار رجال الثورة الباقوري ليتولى وزارة الأوقاف معهم، وأبدى الباقوري للهضيبي أنه راغب في الاستجابة لهم، وأن لديه أفكارًا وتطلعات في إصلاح المساجد والأوقاف، ولم يمانع الأستاذ الهضيبي في ذلك، ولكنه طلب إليه أن يدخل في الوزارة باسمه لا باسم الجماعة. وهذا يتطلب منه أن يقدم استقالته من الجماعة، وقد فعل.
ومن مكارم الأستاذ الهضيبي أنه ذهب للباقوري في مكتبه يهنئه بمنصبه. وهذا يعني أنه لم يعتبر دخوله قطعًا لصلة المودة له. وقال له الباقوري: عفوًا يا مولانا، إنها شهوة نفس. فقال له الهضيبي: اشبع بها!
ومما يذكر للباقوري ما نشرته جريدة «المصري» في (11/9/1952م)، فقد سأل مندوبها الشيخ عن أسباب استقالته من الإخوان فكان جوابه: هي أسباب أحب أن أوثر نفسي بها. وليس من بينها سبب واحد يمس احترامي لإخواني، واعتزازي بهم، فكل واحد منهم -صغيرًا كان أو كبيرًا- في أعمق مكان في قلبي.
انسجم الباقوري مع الثورة، وانسجمت معه الثورة، وكان خطيبها ولسانها المتحدث باسم الدين، وهو رجل حسن المظهر، حصيف الرأي، حلو اللسان، يحسن استقبال الناس، ويحسن الحديث إليهم، ويعرف متى يمسك لسانه، ومتى يطلقه، وفيم يطلقه.
ومن حسناته: أنه ضم إليه مجموعة من الدعاة المعروفين، ووكل إليهم شئون الدعوة والمساجد، والثقافة الدينية، وعلى رأس هؤلاء: أستاذنا البهي الخولي، الذي ولَّاه منصب مراقبة الشئون الدينية، وشيخنا الشيخ محمد الغزالي، الذي تولى منصب مدير المساجد، وشيخنا الشيخ سيد سابق، الذي تولى منصب مدير الثقافة. كما شهد الكثيرون من الإخوان أن الباقوري ما ذهب إليه أحد من أعضاء الجماعة يطلب منه عونًا أو خدمة في قضية؛ إلا لبى طلبه، وقضى حاجته؛ ما دام يقدر عليها.
وظل عبد الناصر راضيًا عن الباقوري سنين طويلة، حتى بلغه عنه شيء كرهه منه، قيل: إنه حديث جرى عنده من الأديب والمحقق الكبير الأستاذ محمود محمد شاكر، وهو رجل معروف بأنه لا يبالي من أصاب بلسانه، لا يخاف لومة لائم، ولا نقمة ظالم، فيبدو أنه - على سجيته - صب جام غضبه على عبد الناصر، ولم يدافع الباقوري عن رئيسه وقائده كما ينبغي، ولم يعلم أن ذلك سيبلغ عبد الناصر، الذي له عيون وآذان في كل مكان، حتى عند وزرائه أنفسهم، وقد قيل: إن هذا الحديث سجل، وسمعه عبد الناصر. وقيل: إن الباقوري كان مشغولًا حين تكلم شاكر مع صديق له في يبت الباقوري، وإن الباقوري لم يسمع كلام شاكر.
وغضب جمال على وزيره، ولم يشفع له ماضيه معه، وخرج الباقوري من الوزارة سنة 1959م، وجلس في بيته معتكفًا أو كالمعتكف، خمس سنوات أو تزيد. واتخذ من بيته صومعة يخلو فيها إلى التعبد وتلاوة القرآن، ومدارسة كتب العلم، ولا يكاد يقابل أحدًا. ثم بدأ يلقى في بيته بعض الخاصة من الناس، من أهل العلم والفكر، يذهبون ويجلسون عنده، يتراجعون في بعض مسائل العلم، وقضايا الأدب والفكر، وقد يحتد النقاش بينهم، فيرجعون إلى مصدر من المصادر في مكتبة الشيخ.
وقد زرته في هذه الفترة أنا وأخي أحمد العسال، فكان عنده العالِم الأزهري البحاثة المعروف: الشيخ عبد الجليل عيسى، مؤلف كتاب: «صفوة صحيح البخاري»، الذي كان مقررًا علينا في المرحلة الثانوية، وكتاب «اجتهاد نبي الإسلام»، وكتاب «ما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين»، و«تيسير التفسير» وغيرها. وكان من جلسائه الدائمين.
كما وجدنا عنده الأستاذ خالد محمد خالد الكاتب الشهير، الذي لم أكن أعرف وجهه، ولم أعلم أنه خالد إلا بعد انصرافه. وبعد ذلك رضي عنه عبد الناصر، فأسند إليه في سنة 1964م منصب أول مدير لجامعة الأزهر بعد التطوير، واستمر فيه حتى وفاته رحمه الله سنة 1985.
كما كان مديرًا لمعهد الدراسات الإسلامية بالزمالك، الذي أسسه رحمه الله، حتى غدا يُعرف «بمعهد الباقوري»، الذي كان يعطي درجة الماجستير في العلوم الإسلامية. وقد ناقشت فيه رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي قدمها الطالب النابه محمد عبد الحكيم زعير - المراقب الشرعي الآن لبنك دبي الإسلامي - وكنت مع أ. د. عيسى عبده إبراهيم، رئيس لجنة المناقشة، والزميل الكريم أ. د. حسين حامد حسان.
لم تكن صلتي قوية بالشيخ الباقوري، كما كانت بالمشايخ: الخولي، والغزالي، وسابق؛ ولذلك لا أعرف الكثير عن سيرته وحياته، ولا عن إنتاجه العلمي والأدبي، إلا ما ذكرته من قبل. ولكنه كان رجلًا يحترم نفسه، ويعرف عصره. غفر الله للباقوري ورحمه، وجزاه خيرًا عما قدم لأمته، وما قدم إلينا حين تحمل تبعة تعييننا بوزارة الأوقاف.
كتاباتي بمجلة «منبر الإسلام»:
كان من فضل أستاذنا البهي الخولي، عليَّ: أن طلب مني أن أكتب مقالات لمجلة وزارة الأوقاف، والتي تصدر عن مراقبة الشئون الدينية بالوزارة، باسم «منبر الإسلام». وقد بدأت أول مقالة للمجلة تحت عنوان: «أمنيّة عُمَريّة».
ثم حثني الأستاذ البهي أن أكتب فتاوى للمجلة بلغة العصر، فإن الذين يكتبون الفتاوى في المجلة يكتبونها بلغة قديمة، كثيرًا ما تحمل التشديد، ولا تلائم روح العصر. فشرعتُ أكتب تحت عنوان: «يستفتونك؟» وهي البواكير التي تشير إلى اتجاهي الذي تبنيته وعُرفت به بعد ذلك، وهو «التيسير في الفتوى»، و «التبشير في الدعوة». وكان الشيخان: البهي، والغزالي يعجبان بها، ويشجعانني عليها.
ولم أشأ أن أوقع باسمي الصريح، حتى لا أثير ثائرة رجال المباحث العامة، الذين يقفون لنا بالمرصاد، ويريدون أن يغلقوا في وجوهنا كل الأبواب، فوقّعت المقال باسم: «يوسف عبد الله»، دون أن أذكر القرضاوي.
وكانت مكافأة المقالة في ذلك الوقت «خمسة جنيهات»، وهي مبلغ جيد لمثلي. ومن الطريف: أن أحد موظفي إدارة الشئون الدينية في الوزارة، وكان اسمه: يوسف عبد الله، لما رأى مقالتي مُوقّعة بهذا الاسم؛ ظن أن الشيخ الغزالي قد كتب هذه المقالة باسمه؛ ليصرف مكافأتها له. وقد فعل ذلك مع بعض المحتاجين، فذهب أخونا يوسف أفندي عبد الله، ليتسلم المكافأة المخصصة لصاحب المقال، وكاد يقبض المبلغ؛ لولا أن بعض موظفي المجلة كان يعرف القصة، فأنقذ الجنيهات الخمسة وصرفتها، وكانت أول مكافأة أتسلمها على شيء أكتبه. والحمد لله حمدًا كثيرًا.
يا أصحاب الفضيلة، اقرأوا:
ومما أذكره في هذه الفترة: أني كتبت مقالةً لمجلة «منبر الإسلام» بعنوان: «يا أصحاب الفضيلة، اقرأوا!» وقد عرضتها على الأستاذ البهي قبل نشرها، فأعجب بها الأستاذ، ولكنه قال: إنها ساخنة، وستغضب علينا المشايخ! قلت: ولكنها كلمة حق! قال: لا أشك في ذلك، ولكن ليس كل حق يقال في كل وقت.
وكنت قد لاحظت أن المشايخ - إلا القليل جدًّا - لا يقرأون، كأنهم بالحصول على الشهادة العالمية قد سقط عنهم التكليف. وقد حفظنا عن سلفنا: اطلب العلم من المهد إلى اللحد، حتى ظنه الناس حديثًا، وما هو بحديث. وكان بعضهم يقول لأحد تلاميذه، وهو على فراش الموت: اقرأ عليَّ كذا من كتاب كذا، حتى يجيئه الموت وهو يطلب العلم.
وقد قيل لبعضهم: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات.
ومما أُثر عن الإمام أحمد قوله: مع المحبرة إلى المقبرة.
وقيل لأحدهم: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إذا كان الجهل يقبح منه، فإن التعلم يحسن به.
وسُئل بعضهم نفس السؤال عن تعلم الشيخ؛ فقال: إن التعلم منه أوجب؛ لأن الخطأ منه أقبح.
ومن العجب أن أمة كان أول نص نزل في كتابها: {ٱقۡرَأۡ}: لا تقرأ!
حتى إن «موشى ديان» وزير الحرب الصهيوني قال لقومه يومًا، وقد لاموه على نشر شيء معين: اطمئنوا فإن العرب لا يقرأون!
هذا مع أن أولى الناس بالقراءة وتعميق الثقافة هم: المشايخ الذين يتصدون لتوجيه الناس، وخصوصًا الدعاة وخطباء المساجد، الذين يواجهون الناس كل يوم جمعة، فعليهم أن يكون لديهم في كل أسبوع شيء جديد يقولونه للناس. ولم تعد تنفع الناس دواوين الخطب القديمة، والكلام المسجوع المملول. وقد انتشر التعليم، وارتفع مستوى الذين يشهدون الجمعة، ويسمعون الخطبة.
وقد عنيت بهذا الأمر بعد ذلك، وفصلته وعمقته في كتابي: «ثقافة الداعية»، الذي أعددته لأشارك به في «المؤتمر العالمي الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة»، الذي عقد في المدينة المنورة في أواسط السبعينات من القرن العشرين.
على كل حال، استجبت لرغبة أستاذنا البهي، ولم أقدم المقالة للمجلة، ولعلي لو قدمتها، لوقفت عند رئيس التحرير. ولا أدري أين ذهبت هذه المقالة، فأنا لم أجدها في أوراقي حتى اليوم.
بعثة رمضانية إلى العريش:
وكان لوزارة الأوقاف بعثات في شهر رمضان من كل سنة تبعث فيها عددًا من المتميزين من أئمتها وخطبائها ومفتشيها إلى بعض البلاد العربية والإسلامية، وبعض الجاليات الأوروبية والأمريكية، وتعطيهم مكافآت لا بأس بها، تنعشهم وتقضي بعض حاجاتهم.
ونظرًا لظروفي الأمنية، لم يكن من الممكن أن يكون لنا حظ في هذه البعثات الخارجية أنا والعسال. ولكن كانت هناك بعثات داخلية داخل مصر إلى الصحراء الشرقية «سيناء»، والصحراء الغربية «السلوم» وما حولها. ورشحتني الوزارة للذهاب إلى سيناء وعاصمتها العريش، ورشحت العسال إلى الصحراء الغربية.
وكانت بعثتي إلى العريش في رمضان تجربة فريدة، فهي أول مرة أتعرف فيها على جزيرة سيناء، هذا الجزء العزيز من أرض مصر، الذي فصله الإنجليز عن الوادي، حتى كأنه ليس من مصر. وعندما أردنا الذهاب إلى هناك كان علينا أن نحصل على تصريح خاص بدخول سيناء، فليس من حق أي مصري أن يذهب إلى هذه المنطقة. وقد ذهبنا في صيف سنة 1957، وكانت آثار العدوان الثلاثي لا تزال ظاهرة للعيان، نشاهد بقاياها ومخلفاتها في كل مكان.
ولقد تعرفت على أهل العريش، وهم عرب أصلاء، يتميزون بالكرم ودماثة الأخلاق، وخصوصًا آل الرفاعي، وآل الشريف وغيرهما. وقد أكرموا وفادتنا، وكنا مجموعة من المشايخ المختارين، بعضنا من وعّاظ الأزهر مثل الشيخ النشار، وبعضنا من خطباء الأوقاف مثل الشيخ عبد المطلب صلاح خطيب مسجد الحسين، والشيخ إبراهيم الدسوقي المفتش بالمساجد، والذي أصبح بعد ذلك وزيرًا للأوقاف في عهد السادات.
وقد كنت أصلي بالإخوة التراويح، وألقي الدروس في المساجد وفي المجالس، كما نخطب الجمعة في مساجدهم: المسجد العباسي، ومسجد السنة، ومسجد المالح، وغيرها مما نسيت اسمه لطول المدة.
ومما أذكره أن ذهبت إلى رفح، وقالوا لي: هذه رفح المصرية وهذه رفح الفلسطينية، ونجد العائلة الواحدة بعضها في مصر وبعضها في فلسطين، والفاصل بينهما «مزلقان» من الخشب، وقد وقفت عند هذا المزلقان، ووضعت رجلي اليمنى في مصر، ورجلي اليسرى في فلسطين، وقلت لهم: أنا الآن نصفي في مصر، ونصفي في فلسطين!
وقد زرت غزة لأول مرة أيضًا، وألقيت فيها درسًا، وأفطرنا عند الأخ الفاضل العالِم الشيخ هاشم الخازندار، واشترينا من أسواقها بعض الأشياء، التي لا توجد في الأسواق المصرية، ثم عدنا إلى العريش، وكان هذا الرمضان من أخصب الرمضانات، وأكثرها بركة، وقد ترك في نفسي وفي أنفس أهالي العريش أثرًا حسنًا، وذكرى طيبة، وصلات عميقة بيني وبينهم.
وقد تكررت هذه الزيارة أو هذه البعثة في السنة التالية، فزادت الروابط عمقًا، وامتد التواصل بيني وبين العرايشة الكرام. وما كان لله دام واتصل.



 الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟ 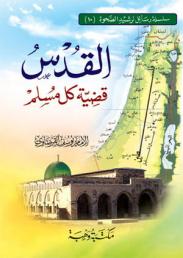 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم 






