كان هناك جلسات لمناقشة أسباب المحنة، وإن كانت قليلة جدًّا، فلم يتعود الإخوان أن يبحثوا في مثل ذلك، فهم يعتبرون أن أسباب المحنة ظلم الآخرين لهم لذلك كان من غير المعتاد أن يناقش الإخوان بعد كل محنة تصيبهم: لماذا أصابتهم؟ وهل يتحملون أي جزء من المسئولية عما حدث؟
هذا مع أن القرآن الكريم علمهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم، وذلك في تعقيب القرآن على ما وقع للمسلمين في أُحد كيف فقدوا سبعين من رجالهم اتخذهم الله شهداء، في حين أصابوا في معركة بدر من قبل سبعين من صناديد قريش قتلى، وسبعين آخرين أسرى. وقال القرآن في ذلك: {أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ} «أي في أُحد» {قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا} «أي في بدر» {قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَٰذَاۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ} (آل عمران: 165).
هكذا قال الله تعالى لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وقائدهم رسول الله، وقال في آية أخرى: {وَلَقَدۡ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥٓ إِذۡ تَحُسُّونَهُم بِإِذۡنِهِۦۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلۡتُمۡ وَتَنَٰزَعۡتُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ وَعَصَيۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنۡيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۚ ثُمَّ صَرَفَكُمۡ عَنۡهُمۡ لِيَبۡتَلِيَكُمۡۖ وَلَقَدۡ عَفَا عَنكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (آل عمران:152).
لقد أشارت الآية إلى سبب ما أصابهم في أُحد، وهو فشلهم وتنازعهم في الأمر، وعصيانهم لتوجيه قائدهم رسول الله، وأن فيهم من أراد الدنيا وغلب عليه حب الغنيمة، ثم ذكر في النهاية أنه عفا عنهم؛ لأن هذا الخطأ والخلل لم يكن خطًّا ثابتًا في حياتهم، بل هو خلل عارض، ومثله يعفو الله تعالى عنه، كما قال تعالى في نفس السياق: {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ مِنكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ بِبَعۡضِ مَا كَسَبُواْۖ وَلَقَدۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (آل عمران:155).
كنا نتناقش فيما أصاب الإخوان مع الأستاذ عبد العزيز كامل، الذي كشف لنا أن كثيرًا مما نحسبه أمجادًا لنا إنما ساقنا أعداؤنا إليه، وجرونا إليه جرًّا، ونحن لا ندري، مثل دخول حرب فلسطين!! كما ناقشنا في هذه القضية: محن الإخوان المتتابعة، وماذا وراءها؟ وهل هناك خلل أو لا؟ وكان يعز علينا نحن الإخوان أن نقر يومًا بأن فينا قصورًا أو تقصيرًا، فنحن -في نظر أنفسنا- نمثل الكمال البشري، وهذا خطأ جوهري. وكان الأخ الكاتب الداعية الأستاذ فتحي عثمان من السباقين إلى النقد الذاتي، ودعوتنا إلى أن نسأل أنفسنا: لماذا؟ وما العلاج؟
وأذكر أني زرته في زنزانته في الدور الثاني، وكان من الحضور في الزنزانة الأخ الشيخ حسن عيسى عبد الظاهر، وكان سؤاله: ما الذي تحتاج إليه جماعة الإخوان في المستقبل، والذي يجب أن نركز عليه؟ وأذكر أننا اتفقنا على وجوب الاهتمام بالجانب العلمي والفكري، وتعميقه في أفراد الجماعة الذين تغلب عليهم السطحية والعاطفية والتعميمية، وأن من الضروري أن تخطط الجماعة لمستقبلها، بناءً على معرفة حاضرها، معرفة علمية قائمة على الإحصاء والأرقام والدراسة والمقارنة والتحليل.
ومن ذلك: أن تحدد مواقفها وعلاقتها بالآخرين - ومنهم الحكومة - تحديدًا قائمًا على أسس شرعية وموضوعية، لا أن تترك الأمور تسيرها عواطف الرضا أو الغضب، وردود الأفعال. وهذا لا يعني إغفال الجانب الرباني في التربية، فهو ضروري للدعوة، وهو الذي يحقق شعارها الأول: الله غايتنا.
عبد العزيز كامل
وبالنسبة لتكرر ذكر الأستاذ عبد العزيز كامل؛ أودّ أولًا أن أقف عنده وقفة. عرفتُ عبد العزيز كامل أول ما عرفته من قراءتي لمقالاته في مجلة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية، وكنت من المعجبين بهذه المقالات، والمداومين لقراءتها، هي ومقالة الشيخ الغزالي، وإن كان لكل منهما طابعه المتميز، ومذاقه الخاص. فقد كان الشيخ الغزالي يكتب - عادة - للمسلمين عامة، وكان عبد العزيز كامل يكتب للإخوان خاصة، بل كثيرًا ما يكتب للإخوان العاملين منهم.
كان الغزالي يركز على التوعية العامة، وكامل يركز على التربية الخاصة، بغرس الجانب الرباني في تكوين الشخصية المسلمة، وكانت له سلسلة مقالات تحت عنوان: «كونوا ربانيين». كما كتب سلسلة مقالات عن «البناء والهدم في الدعوات»، وعن «المحن في الدعوات»، كان لها تأثيرها في إضاءة العقول بالمعرفة، وإنارة القلوب بالإيمان.
والعجيب أن هذه المقالات التي كتبها عبد العزيز كامل لعدة سنين لم يسع أحد لجمعها ونشرها، ليستفيد الناس منها، فالأفكار لا تموت بموت أصحابها. بل يموت العلماء وتبقى آثارهم حية. وعندما قُدِّر لي أن ألتقي بالأستاذ عبد العزيز ازداد إعجابي به، وحبي له، فشخصيته جذابة، ووجهه محبب، وكلماته مؤثرة. وقد كان أول لقاء لي به حينما زارنا في طنطا قبل حل الإخوان بقليل، وألقى محاضرة مؤثرة في دار الإخوان بطنطا، وكان في ذلك الوقت مدرسًا بمعهد شبين الكوم العالي للتربية، ولم يكن قد حصل على الدكتوراه بعد.
ثم زادت معرفتي به، حين لقيته في معتقل الطور، واستمعنا بشغف إلى أحاديثه العميقة، وكنا نسمع من إخوان القاهرة: أن الأستاذ البنا كان يعدّه ليكون «المرشد» من بعده. وبعد الإفراج عن الإخوان، زرته أكثر من مرة في بيته أنا والأخ أحمد العسال. وتوثقت هذه الصلة أكثر حين كان مسئولًا عن «قسم الأسر» بالمركز العام للإخوان، وقد اجتهد أن يرقى بهذا القسم، وأن يقيمه على دعائم راسخة من العلم الشرعي والثقافة التربوية.
وكان معنيًّا بالتأصيل أكثر من اهتمامه بالتفريع، ولا سيما فكرة المحاسبة للنفس أو النقد الذاتي للجماعة، فإن الله لم يجعل العصمة إلا لمجموع الأمة. أما أي جماعة فيمكن أن تخطئ، كما يمكن أن تصيب. وبدأ بنشر سلسلة تنويرية للإخوان سمَّاها: «نحو جيل مسلم» لا تستنكف أن تتضمن النقد لبعض الأفكار، وبعض السلوكيات السائدة في الجماعة.
ثم توثقت العلاقة أكثر حين جمعنا السجن الحربي، والمحن بطبيعتها تجمع ولا تفرق، وكان في السجن نموذجًا حيًّا لتجسيد الأخوة والإيثار، والبذل لخدمة إخوانه، وكان يتقرب من إدارة السجن، لينفع بعض إخوانه ما استطاع. وكان يقترح لحكام السجن بعض الآراء المفيدة للمعتقلين دون أن يشعرهم بأنه يملي عليهم أفكاره، فكان اقترابه منهم رحمة وخيرًا. وبعد خروجنا من السجن كنت أتردد عليه أنا وأخي العسال، للاقتباس منه، والاقتطاف من ثمار معرفته وخبرته.
وهذا الاتصال به كان سببًا في اعتقالي أنا والعسال في صيف سنة 1962م، بعد إعارتنا إلى دولة قطر من الأزهر، وبعد وصولنا من قطر إلى مصر بعدة أيام، ولم نعرف سبب اعتقالنا إلا بعد الإفراج عنا، فقد كان عبد العزيز كامل، وحسن عباس زكي، وعمر مرعي، وآخرون متهمين مع بعض الضباط في الجيش المصري بعمل انقلاب ضد عبد الناصر. وأننا - باعتبارنا في الخليج - كنا همزة الوصل لتمويل هذا الانقلاب المزعوم الذي لم نعلم عنه شيئًا إلا بعد خروجنا من سجن المخابرات! مع أني لم يكن لي في الخليج إلا بضعة أشهر.
ومن عرف عبد العزيز كامل واقترب منه؛ وجده من أوسع الناس ثقافة، فرغم أنه خريج الجامعة المصرية من قسم الجغرافيا بكلية الآداب، تجد ثقافته العربية والإسلامية مؤسسة تأسيسًا قويًّا، وقد نشأ في الإسكندرية قريبًا من جماعة أنصار السنة المحمدية، فاستفاد من مصادرها واهتماماتها السلفية، وتعرف على مدرسة ابن تيمية وابن القيم، كما كان على اطلاع على الفكر الغربي ومدارسه، وعني كذلك بالفكر التربوي وفلسفته وأصوله النظرية، وتطبيقاته العملية.
ثم اتصل بدعوة الإخوان مبكرًا، وكان من الناشطين المؤثرين فيها، واقترب من الإمام البنا، وكان من المقربين إليه، وذوي الحظوة عنده، كما كان موضع ثقة وتقدير عند النظام الخاص ورئيسه عبد الرحمن السندي. وكان مقبولًا محببًا من جمهور الإخوان، فقد كان للسانه حلاوة، ولقلمه طلاوة، ولكتاباته تأثير في العقل والقلب معًا.
وكان كثير من الإخوان يرشحون الأستاذ عبد العزيز كامل، ليكون خليفة للمرشد العام الأول، الإمام حسن البنا؛ لما رأوا فيه من مواهب وفضائل، ربّما لا تتوافر في غيره، ولما رأوا قربه من الأستاذ البنا، بل قيل: إن الأستاذ البنا نفسه كان يرشحه لهذا المنصب في وقت من الأوقات.
وكان آخرون يعيبون على الأستاذ عبد العزيز: الغموض في موقفه من بعض القضايا الكبرى داخل الجماعة، ومحاولته أن يمسك العصا من الوسط، وأن يرضي جميع الأطراف، وربما كان هذا ناشئًا عن خلق الرفق واللين عنده، فهو لا يحسم الأمر، حيث ينبغي أن يُحسم، ولا يعلن موقفه الصريح حين ينبغي أن يعلن.
وبعد ذلك غير أكثر الإخوان موقفهم منه، حين انضم إلى ركب الثورة، وقرر أن يسلك سبيل التعاون معهم لا المعارضة لهم. وقد عرفت من الأستاذ محمد فريد عبد الخالق أنه أخبره في أواخر أيامه في السجن الحربي: أنه سيعمل وحده بعيدًا عن الإخوان، وكلّفه أن يبلغ ذلك إلى الإخوان، وأنه استخار الله في ذلك وصمم عليه. ويبدو من هذا: أنه رأى أن يغير خطه بعد خروجه من السجن، وأنه لا فائدة من الصراع مع الثورة، وأن العمل معهم أجدى من الصراع ضدهم.
وكان هذا اجتهادًا منه، رضيه منه رجال الثورة، وعُيِّن على أساسه وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر في عهد عبد الناصر، ثم نائبًا لرئيس الوزراء لهذه الشئون الدينية في عهد السادات. ولم يرض ذلك منه جمهور الإخوان، واعتبروه قد خان الدعوة التي نشأ فيها، وسار في ركاب أعدائها، وأنه قد أحبط عمله، وضيّع تاريخه، وختم حياته خاتمة سوء، وإنما الأعمال بالخواتيم.
والإخوان بهذا قساة في حكمهم على إخوانهم الذين يختلفون معهم، كما ذكرنا من قبل قسوتهم على صالح عشماوي والشيخ الغزالي. ورأيي: أن الناس تتفاوت طاقاتهم في احتمال البلاء والصبر عليه، وهذا أمر مشاهد ومتفق عليه، وأن من ضعف احتماله عن السير في الطريق إلى نهايته، فمن حقه أن يستريح ويريح، ولا يكلف نفسه ما لا تطيق. وفي الحديث الشريف: «لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: «يُحمّلها من البلاء ما لا تطيق». والقرآن يقول: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا} (البقرة:286).
والعمل الجماعي لخدمة الإسلام يقوم على الإرادة الطوعية الاختيارية، وهي مبنية على اقتناع الإنسان بأهمية هذا العمل وقدرته على الإسهام فيه، فإذا تغير هذا الاقتناع، ورأى المرء المسلم أن وجوده في العمل الجماعي غير نافع له، بل ربما أضر به، أو أنه لم يعد قادرًا على الإسهام فيه؛ فلا جناح عليه أن يعمل بما يقدر عليه من وسائل، وفقًا لقوله تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ} (التغابن:16)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم".
والأجدر بالمسلم أن يحسن الظن بالمسلمين عامة، ولا يظن بهم السوء، ويحمل تصرفاتهم على الوجه الحسن ما استطاع، فقد قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ} (الحجرات:12)، وقال عليه الصلاة والسلام: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث".
وهذا في المسلمين عامة، فكيف بإخوانك الذين عرفتهم وخبرتهم، ولم تعلم عنهم طوال تاريخهم إلا خيرًا، فهم أولى بحسن ظنك بلا ريب، وقد قال بعض السلف: ألتمس لأخي من عذر إلى سبعين، ثم أقول: لعل له عذرًا آخر لا أعرفه! والمؤمن أبدًا يلتمس المعاذير، والمنافق يبحث عن العثرات.
وبعد أن ترك الدكتور عبد العزيز كامل الوزارة؛ طُلب إلى الكويت، ليعمل مستشارًا للأمير أو لولي العهد، وبقي بالكويت بقية عمره - فيما أعلم - حتى توفاه الله.
لا نملك إلا أن ندعو للأخ الكبير الدكتور عبد العزيز كامل - وإن اختلفنا معه في بعض مواقفه الأخيرة - أن يغفر الله له ويرحمه ويتقبله في الصالحين من عباده، ويجزيه خيرًا عما قدم لدينه وأمته، وألا يحرمه أجر المجتهد المخطئ فيما أخطأ فيه من مواقف، ويجعلنا وإياه من الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
تحول الذئب الكاسر إلى حمل وديع
وفي الأشهر الأخيرة لنا في السجن الحربي رأينا عجبًا، رأينا حمزة البسيوني المتكبر الجبار، الذي كان يتحدى الله جل جلاله فوق عرشه؛ يحاول التودد إلى الإخوان والتقرب منهم، والظهور بمظهر الحمل الوديع، وهو الذي كان يحمل وجه خنزير، وقلب وحش، وأنياب كلب عقور. فليت شعري ما هذه الوداعة التي هبطت فجأة عليه؟! وما هذا اللطف الذي يبديه لنا حين يكاد يمر يوميًّا لزيارتنا؟! وكيف تحول الذئب الكاسر إلى هرٍّ أليف؟! وما تفسير ذلك يا أولي الألباب؟!
يبدو أن حمزة البسيوني حين شعر بأن الأزمة قد بدأت تنفرج، وأن الإفراج عن المعتقلين قد بات وشيكًا، وأن هذا الحصن الذي يختبئ فيه لن يدوم له، وأن دوام الحال من المحال، أن الليل مهما يطل فلا بد له من فجر، وكان يخشى هو هذا الفجر أن تشرق أنواره، وأن يزول الظلام الذي يحتمي به، ويختفي في مسوحه السوداء.
كان البسيوني يخاف مما اقترفت يداه من مظالم، وما ارتكبه هو وجنوده من مآثم؛ أن يحل به القصاص على أيدي من ظلمهم من الإخوان، ولا يلوم أحد المظلوم إذا اقتص من ظالمه؛ لذا حاول أن يسترضي الإخوان ليسامحوه ويعفوا عنه، ولا يفكروا في الانتقام منه. ونسي البسيوني هنا أمورًا هامة كان يجب أن يعلمها أو يتعلمها:
أولًا: أن الإخوان لم يفكروا يومًا أن ينتقموا من ظالميهم؛ فإنهم وهبوا ما أصابهم لله وفي سبيله، واحتسبوه عند الله، راجين منه تعالى أن يجعله كفّارة لسيئاتهم، وزيادة في حسناتهم، ورفعة لدرجاتهم. وقد أصيب الإخوان في عهد الملكية بما أصيبوا، فلم يثأروا من أحد، وتركوا ثأرهم من ظالميهم للحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة.
الثاني: أن الإخوان لو عفوا وصفحوا في حق أنفسهم باعتبارهم أفرادًا، وتنازلوا عن حقوقهم الفردية؛ فأين حق الله تعالى، وحق الدعوة، وحق الإسلام؟ ومن يملك أن يتنازل عن هذه الحقوق؟ وقد تطاول البسيوني على الله الواحد القهار، وعلى دينه وعلى دعوته.
الثالث: أن الإخوان قد اعتادوا ألا ينتقموا لأنفسهم، وإنما يدعون الانتقام للرب الأعلى الذي لا يظلم أحدًا، ولا يحابي أحدًا، وهو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، {وَكَذَٰلِكَ أَخۡذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلۡقُرَىٰ وَهِيَ ظَٰلِمَةٌۚ إِنَّ أَخۡذَهُۥٓ أَلِيمٞ شَدِيدٌ} (هود:102). ولقد ترك الإخوان البسيوني لسلطان القدر الأعلى، فماذا فعل به؟
لقد قُتل شر قِتلة بغير أيدي الإخوان. كان يسوق سيارته من الإسكندرية إلى القاهرة، وفي جنح الليل دخلت سيارته في سيارة كبيرة أمامها تحمل أسياخًا من الحديد، فمزقت الرجل الجبار شر ممزق، وقطعت جسده أشلاء، وكان ذلك أمام قرية من قرى المنوفية، فلما عرف الناس صاحب السيارة أمطروه بلعناتهم، {إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٖ} (إبراهيم:47) .
آخر فوج يغادر السجن الحربي
ظلت أفواج الإفراج من السجن الحربي تتوالى، في كل أسبوعين يغادر فوج السجن الحربي، لا إلى فضاء الحرية مباشرة، ولكن إلى سجن آخر هو «سجن القلعة»، الذي يقضي فيه المغادرون أسبوعين، قبل الإفراج النهائي عنه.
وسر ذلك: أن السجن الحربي يتبع الجيش ووزارة الحربية، أما سجن القلعة فهو تابع لوزارة الداخلية... ولهذا أرادت الداخلية وجهاز «المباحث العامة» المسئولة عن الأمن السياسي أو أمن الدولة، ويدخل في اختصاصها قضية الإخوان: أن تضع المفرج عنهم من المعتقلين تحت رقابتها فترة من الزمن، تشعرهم بأنها هي التي ستتولى زمام أمرهم فيما بعد، وتقوم بملاحقتهم في بيوتهم وأعمالهم، وتراقب كل تحركاتهم، وتحصي عليهم أنفاسهم إن استطاعت.
ومن هنا فتحت لكل معتقل ملفًا، ووضعت فيه ما شاءت من المعلومات، واستكملت بالأسئلة كل ما ينقصها. وكان سجن القلعة سجنًا قديمًا كريهًا ليس فيه من الشمس والهواء والفسحة خارج الزنازين، ما في السجن الحربي؛ ولهذا كانت أيام القلعة أيامًا كئيبة، وختامًا سيئًا، هوّنها علينا عِلمنا بأن وراءها الإفراج المرتجى، وكنا نقول ما قال العرب من قديم: إن مع اليوم غدًا، وإن غدًا لناظره قريب.
وكنا نحن آخر مجموعة تغادر السجن الحربي في أوائل شهر يونيو «حزيران» (1956م)، وبقينا في سجن القلعة أسبوعين، تم الإفراج عنا - على ما أذكر - يوم 16 يونيو 1956م. ونُقلنا من القاهرة إلى طنطا، ومنها إلى المحلة الكبرى، ومباحثها العامة، التي تسلمتنا أولًا، وبعد أن أخذ عليَّ تفتيش المباحث التعهد اللازم بأن أبتعد عن كل نشاط سياسي؛ فكوا أسري، وأطلقوا سراحي، وكان بعض الأهل والأقارب ينتظرونني، فانطلقت معهم إلى القرية، حامدًا الله تعالى على ما حدث لي خلال تلك المدة التي انقضت كما تنقضي كل أحداث الدنيا..
والمطلوب من المسلم أن يحمد الله في السراء والضراء، والنعماء والبأساء، وفي الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه»، عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له".
لاحظ خالي أني لم أكن منشرحًا ومنطلقًا، مثل انشراحي وانطلاقي، حينما أفرج عني سنة 1949م، وسألني عن ذلك، فقلت له: هناك فرق كبير بين الإفراجين: في الإفراج الأول كانت الحكومة التي اعتقلتنا قد سقطت وذهبت مشيعة باللعنات. أما في هذا الإفراج فلا تزال الحكومة التي اعتقلتنا باقية ومتمكنة، ولن تدعنا في حالنا. ولكن الله أكبر منهم، وهو من ورائهم محيط {وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ} (الأنفال:30).
على كل حال، بخروجنا من السجن الحربي؛ انتهت مرحلة أليمة مريرة من حياتي، وإن كانت آثارها ستظل غائرة في الجسم وفي النفس إلى مدى لا يعلمه إلا الله ...على أن من رحمة الله بالإنسان أنه رزقه نعمة النسيان للمصائب والآلام الماضية، واختلاف النهار والليل يُنسي كما قال شوقي، وقد قيل: كل شيء يبدأ صغيرًا ثم يكبر، إلا المصيبة، فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر!
كما منح الله الإنسان عامة، والمؤمن خاصة: نعمة الأمل والرجاء في الغد، وقال له في كتابه: {فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا * إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا} (الشرح:5-6)، ولن يغلب عسر يسرين. وكما قال ابن مسعود: لو دخل العسر جحرًا لتبعه اليسر حيث كان. وعلى هذا الأمل في فضل الله ورحمته نعيش معتصمين بالله، متوكلين عليه {وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا} (الطلاق:3).



 الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟ 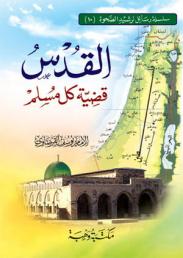 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم 






