قتل النقراشي
في اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر -أي بعد حل الإخوان بعشرين يوما- وقع ما حذر منه الإمام البنا، فقد أُذيع نبأ اغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحاكم العسكري العام "محمود فهمي باشا النقراشي"، في قلب عرينه في وزارة الداخلية، أُطلقت عليه رصاصات أودت بحياته.
وكان الذي قام بهذا العمل طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة "فؤاد الأول" بالقاهرة، اسمه "عبد المجيد حسن" أحد طلاب الإخوان، ومن أعضاء النظام الخاص، الذي قُبض عليه في الحال، وأودع السجن، وقد ارتكب فعلته، وهو يرتدي زي ضابط شرطة، لهذا لم يُشَك فيه حين دخل وزارة الداخلية، وانتظر رئيس الحكومة، حتى أطلق عليه رصاص مسدسه.
وعُين "إبراهيم باشا عبد الهادي" نائب النقراشي خلفا له في رئاسة الوزارة، الذي صمم على أن يضرب بيد من حديد، وأن ينتقم لسلفه النقراشي.
وقابل بعض شباب الإخوان اغتيال النقراشي بفرحة مشوبة بالحذر؛ لوفاة الرجل الذي ظلمهم وحل جماعتهم، ولكن هل كان في الاغتيال حل للمشكلة؟ لقد أثبت التاريخ أن الاغتيال السياسي لا يحل مشكلة، وأنه كما قال أحد الساسة للشيخ البنا: "إن ذهب عير فعير في الرباط"، والملاحظ أنه كثيرا ما يكون الخلف أنكى وأقسى من سلفه، وفي هذه القضية كان رد الفعل هو اغتيال حسن البنا؛ ثأرا للنقراشي؛ فأي خسارة أكبر من فقد حسن البنا، وإن ذهب شهيدا عند ربه؟!
ولم يكن للأستاذ البنا صلة بهذا الحادث، ولا علم له به، ولما سُئل عنه: قال: "إن جماعة الإخوان لا تتحمل وزر هذا الحادث؛ لأنها غير موجودة بحكم القانون؛ فكيف تتحمل تبعة عمل فرد ليس لها قدرة على أن تحاسبه، بل ولا مشروعية أن تسأله؟! وهو الذي حذرت منه أن ينطلق الأفراد بدوافعهم الذاتية يفعلون ما يشاؤون".
وقد اعتقلت الحكومة بعض الأفراد مع عبد المجيد، منهم: عبد العزيز البقلي الترزي الذي خاط له حلة الضابط، والشيخ سيد سابق، الذي قيل: إنه أفتاه بذلك، والذي أطلقت عليه الصحف اسم "مفتي الدماء"، واتخذ من ذلك مصورو الكاريكاتير مادة للسخرية والتشهير، ومما يُذكر من نكات الشيخ سيد سابق -وهو رجل خفيف الروح- أنه عندما قُبض عليه سألته المباحث عن "مالك"، فقال: "رضي الله عنه، كان إماما من أئمة المسلمين". قالوا: إنما نسألك عن "محمد مالك" الإرهابي الخطير الهارب! قال: هذا لم ندرسه في الأزهر، إنما درسنا "مالك بن أنس"!
وقد برأت المحكمة ساحة الشيخ سيد، وكان معنا في معتقل الطور، وسألناه بصراحة عن فتواه لعبد المجيد حسن، فأقسم لنا أنه لم تصدر منه فتوى له.
وكثير من القضايا التي كان الإعلام يضخمها، ويجعل من الحبة منها "قُبة"، كانت تتمخض في النهاية عند القضاء عن الحكم بالبراءة، ولكن بعد أن يكون الإعلام قد عمل عمله في عقول الناس لعدة أشهر، ثم يصدر حكم البراءة في عدة أسطر، وهو ما لا يزال إلى اليوم!!.
وأشهد أنني عرفت الأخ "محمد مالك" وصحبته، وصحبني عدة أيام بعد أن أفرجت عنه ثورة يوليو بعد قيامها، فرأيته شابا في غاية الصلاح والدماثة واللطف، على حين أوحت الصحف بأنه غول أو سبُع قاتل. وكنا -نحن طلاب الإخوان- في حالة ترقب، ننتظر أن يصدر الأمر باعتقالنا في أي وقت، ولا سيما الطلاب الذين لهم زعامة وتأثير في محيطهم، ويخشى أن يؤثروا في معاهدهم ومدارسهم.
ولقد قابلنا - نحن الشباب والطلاب - اغتيال النقراشي بارتياح واستبشار ، فقد شفى غليلنا ورد اعتبارنا ومما أذكره أني نظمت بيتين في هذه المناسبة - يعبران عن ثورة الشباب في هذا السن - خطابا إلعبد المجيد حسن قاتل النقراشي ، كان الطلاب يرددونهما ، وهما:
عبد المجيد تحية وسلام ** أبشر فإنك للشباب إمام
سممت كلبا جاء كلب بعده ** ولكل كلب عندنا "سمام"
ولكن " الكلب" أو "العير" - كما عبر بعضهم - الذي جاء بعد المقتول، استمر أشد من سابقه وأقسى وأفظع، ولم يُخِفْه ما حدث لسلفه، بل بالغ في القسوة والتنكيل والتشديد.
وهذا ما جربه كثيرون في مثل هذه الأحوال: أن يُغتال رئيس أو حاكم، فيخلفه من هو شر منه وأسوأ بمراحل ومراحل، حتى ينشد الناس:
رُبَّ يوم بكيت منه، فلما * صرت في غيره بكيت عليه!
ومن هنا كانت فلسفة (الاغتيال) فلسفة عقيمة، لا تحل عقدة، ولا تعالج مشكلة، بل كثيرا ما تزيد الطين بلة، والداء علة!!.
وهذا ما جعل الإخوان في عقودهم الأخيرة يتبنون فلسفة أخرى تقوم على رفض سياسة الاغتيالات والعنف عامة وتبني فلسفة الحوار والتغيير السلمي، والأنظمة عادة لا تقوم على فرد واحد، بحيث إذا زال انهار النظام وهوى بنيانه، بل الغالب أنها تقوم على مؤسسات يقوم بها مجموعة من الناس، كلما سقط فرد قام بعده من يسد مسده.
حادثة محكمة الاستئناف:
في هذه الآونة وقعت حادثة كان لها صدى ودوي، وهي حادثة محاولة نسف محكمة الاستئناف بالقاهرة، التي اتُّهم فيها الأخ "شفيق أنس"، وقُبض عليه فيها، وكان ذلك بحجة أن فيها أوراقًا تخص بعض قضايا الإخوان، وقد أغضبت هذه الواقعة الأستاذ البنا -رحمه الله-، وساءته، وثار على من فعلها ثورة شديدة؛ وهو ما دفعه إلى أن يصدر بيانا نشرته الصحف في حينها، يبرأ فيه ممن اقترف هذه الفعلة، ويقول في نهاية بيانه عمن فعل ذلك أو شارك فيه: "هؤلاء ليسوا إخوانا، وليسوا مسلمين" بهذا الحسم البين.
وقد زعم بعض الأخوان أن الأستاذ البنا ضُغط عليه حتى أصدر هذا البيان، والواقع أن أحدا لم يضغط على الأستاذ، أو يطلب إليه مجرد طلب أن يصدر هذا البيان، ولكن الرجل من واقع شعوره بالمسؤولية أمام الله وأمام التاريخ أصدر هذا البيان.
الاختفاء من المعهد بالسملاوية:
اتسعت دائرة الاعتقال لتضم أعدادا أكثر من الإخوان في أرجاء المملكة المصرية، واعتُقل عدد من الإخوان في طنطا، وقال لي بعضهم: "الدور عليك لا محالة"، وفكرت في الأمر أنا وأخي ورفيقي "محمد الدمرداش مراد"، وتشاورنا في الأمر، وقررنا أن نغيب عن المعهد، ونختفي معا في قرية الأخ الدمرداش (السملاوية) فهي قرية صغيرة بعيدة عن أعين الرقباء، ونستطيع أن ندخلها خلسة بحيث لا يرانا أحد، ولا نخبر بوجودنا أحدا إلا بعض الثقات المأمونين من الإخوة، وهناك نبقى فترة من الزمن، حتى تهدأ الأمور، أو يهيئ الله حلا للمشكلة.
ونفذنا ما اتفقنا عليه بالفعل بعد أن اصطحبنا ملابسنا وكتبنا؛ لنستذكر فيها ما يفوتنا من دروس، وغاب عنا: أن اختفاءنا معا سيوجه رجال الأمن إلى البحث عنا في قرية كل منا، وقد علمت أنهم ذهبوا إلى قريتنا (صفط تراب) وسألوا عني، فقالوا لهم: "إنه يدرس في طنطا"، قالوا: "إنه مختفٍ عندكم، واختفاؤه لا يفيده فأين هو؟" قالوا: "الدار أمامكم.. ففتشوا كيف شئتم؟"، وفتشوا الدار، وقلبوها رأسا على عقب، ولم يجدوا فيها شيئا إلا بعض الأوراق الخاصة بي، أخذوها معهم، ودُور الأرياف غاية في البساطة؛ فليس فيها من الأثاث والأدوات ما يجعل التفتيش فيها عسيرا، ففي دقائق معدودة تم كل شيء.
ولما لم يجدوني في "صفط"، اتجه تفكيرهم إلى (السملاوية)؛ فبينا كنا نجلس أنا وأخي الدمرداش في (مقعد) في الطابق الثاني، نتدارس في بعض ما صحبنا من الكتب فإذا طرق شديد عنيف على باب الدار، فأدركنا أنهم رجال الأمن السياسي أو القسم المخصوص، -كما كان يسمى في ذلك الحين-.
وقال الأخ محمد: يمكننا أن نختفي عند الجيران بواسطة (سلالم السطح)، وكانت سطوح منازل القرى في الريف المصري متصلة، فليس هناك أسوار تعزل البيوت بعضها عن بعض، وكانت السطوح مغطاة بالقش والحطب ونحوها؛ وهو ما يعرضها للخطر عند وجود أي حريق في أحدها.
وصعدنا سلم سطح الأخ محمد لننزل من سلم سطح الجيران إلى الطابق الثاني، فالطابق الأرضي، فأدخلتنا جارتهم إحدى الحجرات ثم أغلقت علينا بالمفتاح، وخرجت من المنزل ذاهبة إلى الحقل.
فتحت الحاجة أم الدمرداش الباب بعد الطرق الشديد، لتجد أمامها رجال الأمن، فسألوها: "أين ابنك وصديقه؟" فقالت: "ابني في معهده في طنطا.. اسألوا عنه هناك". ففتشوا الدور الأول من المنزل، فلم يجدوا فيه شيئا، ثم صعدوا إلى الدور العلوي، فوجدوا أحذيتنا وكتبنا وملابسنا موجودة، فتوجهوا إلى أم الدمرداش، وقالوا لها: "تكذبين وأنت امرأة كبيرة؟ هذه آثارهم تدل عليهم، فقولي: أين هما؟ وإلا أخذناك بديلا عنهما". قالت: "لا أعرف عنهما شيئا".
واتجه تفكيرهم إلى البيت المجاور، فدخلوه، وفتشوا حجراته تحت وفوق، فلم يجدوا إلا حجرة كانت مغلقة، لم يتمكنوا من دخولها أو فتحها، وبعد هذه الجولة غادروا القرية مصطحبين معهم المرأة الطيبة الصالحة أم محمد الدمرداش إلى نقطة البوليس في (نهطاي) القرية المجاورة، وبقينا نحن حبيسي الحجرة التي أُغلقت علينا، ولا ندري ماذا حدث في الخارج؟ فلما جاءت الجارة صاحبة البيت فتحت علينا، وعرفنا ما حدث، وقلت للأخ محمد: "لم يعد أمامنا بُدٌّ من تسليم أنفسنا، ولا يجوز أن تبقى والدتك ليلة واحدة في الحجز، فلنتوكل على الله، ولنبادر بالذهاب إلى نهطاي؛ لكيلا ندع حجة في إبقاء الوالدة عندهم". وفعلا أبلغنا عمدة القرية، وبعث بنا إلى نقطة نهطاي، فسلمنا أنفسنا، وأفرجوا عن الحاجة -رحمها الله-.
إلى شرطة زفتى.. حولناها إلى مسجد بفضل الله!!
وبعد أن سلمنا أنفسنا إلى النقطة، أرسلت بنا إلى (مركز زفتى) ليتولى أمرنا، ويرسل بنا إلى طنطا (عاصمة المديرية)، وكان اليوم يوم خميس، وقد وصلنا إلى مركز زفتى في المساء، فلم يكن مأمور المركز ولا نائبه ولا أحد المسؤولين موجودا، ماعدا (الضابط النوبتجي) الذي سلمنا إلى جاويش المركز ليضعنا في الحجز، حتى صباح يوم السبت، لنسلم إلى طنطا.
ودخلنا حجز المركز، لنجد فيه أكثر من أربعين شخصا، معظمهم ليسوا من أهل الجريمة، بل من الفلاحين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالزراعة أو بالري أو نحو ذلك، وجاء وقت العشاء فأذَّنَّا في الحجز، وأقمنا الصلاة، وطلبنا منهم أن يصلوا معنا، وكان عدد منهم من أهل الصلاة، فصلوا معنا، وقد أَمَمْتُهم وقرأت بهم قراءة طويلة خاشعة تأثر الناس بها، وسألونا عن تهمتنا فأجبناهم بقدر ما يفهمون، واغتنمناها فرصة لنحدثهم عن الدعوة، وقد كان يوسف -عليه السلام- في سجنه يبلغ دعوته إلى من حوله من السجناء، كما حكى الله عنه في قوله: {يَا صَاحِبَيْ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَّفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} (يوسف: 39)
ونمنا بعض ساعات في هذه الحجرة الواسعة -أو العنبر-، مع الزحام والصخب، ثم استيقظنا قبل الفجر، لنتوضأ ونستعد لصلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر ألقيت عليهم موعظة قصيرة، ثم بدأنا أنا والأخ الدمرداش نقرأ (المأثورات) وهي جملة من الأدعية المأثورة جمعها الأستاذ البنا، وحثّ إخوانه أن يذكروا الله بتلاوتها في الصباح والمساء، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} (الأحزاب: 41، 42).
وكنا نقرؤها نحن الاثنان فقط، حتى جاءت بعض الأذكار التي يمكن أن نشركهم معنا فيها، مثل: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"، وهي تقال عشر مرات، فرددوها معنا.
وكذلك الباقيات الصالحات من الكلمات الأربع: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، وهذه تُردد مائة مرة، فرددها الجميع معنا بصوت جماعي كان يهز أركان حجز المركز، وقد أحس بذلك جاويش المركز، وفتح باب الحجز، فسمع هذا الدويّ الهائل بالذكر، فقال: "يا أولاد الإيه، أنتم خليتوها جامع؟!"
وفي عصر هذا اليوم -يوم الجمعة- فوجئنا بالنداء علينا: أن هيا معنا، فقد طلبوكم في طنطا.
لقاء حاد مع سعد الدين السنباطي:
بعد أن رحلنا إلى طنطا، أُخذنا لمقابلة "سعد الدين السنباطي" رئيس قسم المخصوص بمديرية الغربية، وكان مشهورا بالقسوة والإجرام، ولا أذكر ما كانت رتبته في ذلك الوقت، أظنه كان رائدا (صاغا)، ويبدو أن تقريرات شتى رُفعت إليه عني وعن نشاطي في قسم الطلاب، ونشاطي الدعوي في أنحاء المديرية، فكوَّن عني فكرة أحسبها أكبر من الواقع.
ولعل هذا ما جعله يلقاني لقاء حادًّا عاصفًا، فكان يخاطبني وكأني قائد في الإخوان، وأنا مجرد جندي صغير فيهم..
أول ما لقيني تجهم في وجهي، وقال لي: "حضرتك عامل زعيم؟!"..
قلت له: "أنا طالب مجتهد في دروسي بشهادة جميع أساتذتي"..
قال: "ماذا يريد مرشدكم، يريد أن يكون (إلها) مثل (سليمان المرشد) في سوريا؟!"..
قلت له: "حسن البنا رجل متواضع، يقول: الله غايتي، والرسول قدوتي"..
قال: "بتدافع عنه، لأنه سحركم، وسخركم لتحقيق مآربه"..
قلت: "ليس للرجل مأرب إلا نصرة الإسلام، وهو لم يسحرنا، بل سِرنا وراءه طائعين لخدمة ديننا ووطننا"..
قال: كم عدد الإخوان؟ 200 ألف؟ نصف مليون؟ بناقص نصف مليون، أو مليون.. بدل أن يكون الشعب 20 مليونا فليكن 19 مليونا، يمكننا أن نقضي على الإخوان ولا ينقص الشعبُ شيئًا".. وسكت ولم أرد.
ودار النقاش الحادّ على هذا النحو، كثير من الاستفزاز عنده، وقليل من الحدة عندي، ولكن الحق يقال أنه رغم سلاطة لسان السنباطي، وتطاوله على الأستاذ البنا وعلى الإخوان، لم يمسني بأي أذى بدني، ولم يلحقني منه أي تعذيب، ولكنه قام بتعذيب الذين لفَّق لهم تهما، كما ثبت ذلك عندما اتُّهم بعد الثورة، وحوكم في قضية إبراهيم عبد الهادي. ومن المعروف -كما ثبت في المحاكمات في عهد الثورة بعد ذلك- أن السنباطي كان يتلقى أوامره مباشرة من عبد الهادي نفسه، متخطيا رؤساءه في المديرية حتى مدير المديرية نفسه.
كما أثبتت المحاكمات وفق ما جاء في شهادة اللواء "أحمد عبد الهادي" حكمدار القاهرة، الذي قال: "ضباط البوليس السياسي لا يخضعون للحكمدار، وإنهم يكتبون تقاريرهم من ثلاث صور؛ إحداها تُرسل للسفارة البريطانية، والثانية للسراي، والثالثة للوزارة"!
في سجن قسم أول طنطا:
أُدخلنا حجز قسم أول طنطا، مع من فيه من المجرمين والمتهمين أياما قليلة، ثم نُقلنا إلى سجن خاص بنا داخل القسم نفسه، ووجدنا فيه بعض الإخوان قد سبقونا إليه، بعضهم من مدينة طنطا، وبعضهم من كفر الزيات، ومن بسيون ومن شربين...
كان منهم الأستاذ جمال الدين فكيه الإخواني القديم في طنطا، والأستاذ حسني الزمزمي القانوني، والمهندس شفيق أبو باشا مهندس الري في كفر الزيات، وحكمت بكير المهندس في كفر الزيات أيضا، وإبراهيم الباجوري من بسيون، والحاج محمود عبيه من شربين، وكانت تتبع الغربية، ولحق بنا الإخوان: أحمد العسال، ومصباح محمد عبده من طلبة المعهد.. وآخرون لا أذكرهم.
كان السجن عبارة عن حجرة واحدة متسعة معزولة عن العالم، لا يدخلها الشمس ولا الهواء إلا من نافذة واحدة صغيرة عالية، وكنا لا ندري شيئا عما يجري في العالم من حولنا، فلم يكونوا يسمحون لنا بدخول الصحف.
كان الأستاذ "الزمزمي" رجلا له طبيعة خاصة؛ فهو لا يستطيع أن يعمل شيئا لنفسه، حتى تقشير البرتقالة لا يحسنها!، لا بد أن تأتي مقشورة جاهزة، فلا غرو أن يكون الاعتقال أمرا صعبا وشديدا على نفسه، فعلى حين لم يكن يهمنا -نحن الشباب- ما نأكله وما نشربه، وعلى أي جنب ننام، وعلى أي فراش نرقد، ويكفي أحدنا أن يجعل ذراعه مخدة له.. نرى الأستاذ الزمزمي يعنيه كل هذا، ويؤرقه ويعذبه، ويحاول إخوانه جميعا أن يهونوا عليه ويساعدوه، ولكن طبيعته المدللة المرفهة لا تحتمل هذه الحياة الخشنة المضطربة، حتى ليكاد ينطبق عليه قول الشاعر:
خطرات النسيم تجرح خديْـــ * ـــه ولمس الحرير يُدمي بنانه!
أما الحاج "محمود عبيه" فقد كان من دعاة الإخوان في شربين، وكان من المعجبين بالإمام "أبي محمد بن حزم"، ومن قراء كتابه "المحلى"، وقد تبنى آراءه في كثير من المسائل، حتى أصبحنا نسميه "ابن حزم"، وكنا نصلي الصلوات الخمس في جماعة، ويخطب أحدنا خطبة الجمعة، ونصليها داخل هذا السجن، وقد مكثنا في هذا السجن الطنطاوي نحو أربعين يوما، حتى نودي علينا يوما بأن نتأهب للرحيل إلى القاهرة، لننضم إلى سائر إخواننا هناك.



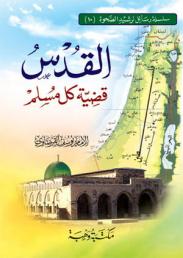 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






