كما وقفنا وقفة نقد ذاتي لمناهج المرحلة الابتدائية؛ يحسن بنا أن نقف نفس هذه الوقفة النقدية لمناهج المرحلة الثانوية، سواء منها ما يتعلق بعلوم الدين أم غيرها .
• علوم الدين: علم الفقه:
أول علوم الدين كان (علم الفقه) الذي يحظى بنصيب الأسد بين علوم الدين الأخرى، في الخطة الدراسية بحيث يكاد يكون عندنا في كل يوم درس للفقه.
وكنا ندرس الفقه الحنفي في كتاب قيم، هو كتاب (الاختيار) شرح (المختار) وكلاهما لابن مودود الموصلي، وكان هذا الكتاب يمتاز على (اللباب في شرح الكتاب) أو (الميداني على القدوري) بعنايته بالأدلة النقلية والعقلية، التي تؤيد مذهب الحنفية، وترد على مخالفيهم، وخصوصا الشافعية. فهو يمرن الطالب على الاستدلال والحجاج، ولا سيما في معتركات النزاع الحادة، مثل تزويج المرأة نفسها دون اشتراط الولي إذا زوجت نفسها من كفء. ومثل قتل المسلم بالكافر الذمي ونحوها.
ولكن عيب هذا الكتاب وغيره من الكتب في المذهب الحنفي وفي سائر المذاهب: أنه كتب لعصر مضى، ولم يكتب لعصرنا، ولا لعلاج مشكلاتنا، أو الإجابة عن تساؤلاتنا.
وليس العيب في مؤلفي هذه الكتب، فهم قد عالجوا مشكلاتهم بلغة عصرهم، وبذلوا ما في وسعهم، وإن كان يعيبهم التقليد المطلق للمذهب، وإن ظهر تهافته وضعف دليله.
ولكن العيب فينا نحن، فنحن ندرس الفقه كله من ألفه إلى يائه، من كتاب الطهارة إلى كتاب الفرائض (المواريث)، ولكنه فقه نظري محض، يعيش في صفحات الكتب ولا يحيا في واقع الحياة.
نحن ندرس كتاب (البيوع) و(المعاملات) ولكن لا نعرف شيئا عن البيوع الحديثة وما يجري فيها، ولا نعلم شيئا عما يدور في (البنوك) وماذا فيها من حلال أو حرام؟ وكذلك شركات (التأمين) لا نعلم شيئا عنها ولا عن أحكامها. بل حتى في العبادات لا ندري شيئا عن الزكاة في الشركات أو المصانع أو العمارات السكنية، أو غير ذلك من الأموال النامية المستحدثة.
وكان زملاؤنا ممن يدرسون الفقه على مذهب الشافعي، أو مذهب مالك، على نفس حالنا ووضعنا، فكلنا في الهمِّ شرق، كما قال شوقي.
• علم التوحيد:
إذا كان الفقه يتعلق بالسلوك والعمل، فإن علم التوحيد يتصل بالعقيدة، التي هي أساس الدين كله، فإذا ثبتت العقيدة وسلمت، فقد ثبت الدين وسلم، وإذا انهدمت العقيدة انهدم الدين، وإذا وهت العقيدة وهى الدين.
ولكن المنهج الذي يدرس على أساسه التوحيد: منهج قديم، من آثار عصور التراجع والتخلف في الحضارة الإسلامية، وهو يقوم على افتراضات معينة، وفلسفة معينة، لم تعد موجودة أو مؤثرة في حياتنا العقلية، وما رد عليه الأشاعرة والماتريدية قديما من أفكار ومفاهيم خلطوها بالتوحيد، لم يعد له ذلك التأثير الذي كان، ونحن في حاجة إلى أن نرد على أفكار أخرى، وعقائد أخرى. نحتاج أن نرد على الماديين والماركسيين واللادينيين، ممن ينكرون الألوهية، أو ينكرون الوحي والنبوة، ونرد عليهم بالمنطق العقلي البرهاني، والمنطق العلمي المعاصر، الذي ألفت فيه كتب شتى ترد على الماديين الجاحدين.
كما أننا في حاجة إلى الرد على أصحاب الأديان المخالفة من اليهود والنصارى، فيما يثيره المبشرون والمستشرقون من شبهات على عقائد الإسلام ومصادره.
وفي حاجة إلى الرد على الفرق المنشقة مثل القاديانية والبهائية.
وفي حاجة إلى أن نعرض أصول العقيدة، كما عرضها القرآن بوضوحها وفطريتها وعمقها، وبما يخاطب به العقل والقلب معا.
لقد كنا ندرس التوحيد في السنتين الرابعة والخامسة في شرح الجوهرة للقاني، والجوهرة (منظومة) تتضمن العقائد في الإلهيات والنبوات والسمعيات، على المذهب الأشعري. وهي مكتوبة بلغة لا تلائم هذا العصر ولا تعالج مشكلاته العقلية، وقد شرحها الشيخ الباجوري بنفس اللغة.
ولكن يحمد لواضع منهج التوحيد: أن ضم إليه جزءا من رسالة الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد وهو (حاجة البشر إلى الرسالة) وهو فصل مهم، وإن لم نجد من يدرسه لنا كما ينبغي.
• علم التفسير:
وقد كنا ندرس (علم التفسير) من السنة الثالثة الثانوية، وأعتقد أنه تأخر كثيرا، ومع تأخره، فلم يكن الكتاب المقرر كافيا في إفادة الطالب المعاصر ما يحتاج إليه من مادة التفسير.
كان الكتاب المقرر هو تفسير الإمام النسفي، وهو تفسير مقبول في زمنه، معني بالجانب اللغوي، النحوي والبلاغي، وليس معنيا بمفاهيم القرآن ومقاصده في إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع.
لذا كان الأولى في نظري: أن يدرس التفسير في كتابين: كتاب قديم كالنسفي أو النيسابوري أو البيضاوي أو غيرها، يتدرب فيه الطالب على قراءة كتب التراث في التفسير وحسن فهمها.
وكتاب آخر حديث، يقدم لنا هداية القرآن ومقاصده، مستفيدا من كتب التفسير بالمأثور والرواية، استفادته من كتب التفسير بالرأي والدراية، مكتوبا بلغة عصرية سلسة، رادا على كل المشكلات التي يثيرها بعض الخصوم على القرآن وعلى الإسلام. وذلك على منهج تفسير الشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا في (تفسير المنار).
كما أرى ضرورة إعطاء طالب المعهد (جرعة كافية) من أساسيات (علوم القرآن) فلا يدرس الطالب تسع سنوات، ثم لا يعرف شيئا عن المكي والمدني، أو عن الناسخ والمنسوخ، أو عن أسباب النزول، وغيرها مما لا بد منه.
• علم الحديث:
كان علم الحديث يدرس لنا في السنة الأولى الثانوية، وهو مختارات من صحيح البخاري في كتبه وأبوابه المختلفة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وغيرها.
وقد شرح الأحاديث المختارة أحد علماء الأزهر المرموقين، وهو الشيخ عبد الجليل عيسى، الذي استفاد من شروح البخاري، ولا سيما فتح الباري، وسمى تأليفه (صفوة صحيح البخاري) وقد درسناه في السنوات الخمس كلها، واستفدنا منه ولا شك. وربما كان هو المادة الوحيدة التي تجاوبنا معها أكثر من غيرها.
وقد درسنا في السنة الأولى الثانوية كتابا مختصرا في علم (مصطلح الحديث)، ولكنه كان كتابا لا يسمن من شبع، ولا يغني من جوع، ولم يفدنا كثيرا في فهم هذا العلم المهم، لأنه كان أشبه بمتن ينقصه الشرح والتمثيل، فبالمثال يتضح المقال. ولم نوفق إلى مدرس يجبر قصور الكتاب، فالمدرس الناجح يعوض ما في الكتاب من نقص. والمدرس الفاشل يضيع قيمة الكتاب النافع، ويميت المادة الحية.
وما زال هذا العلم في مسيس الحاجة إلى كتاب معاصر، يذكر القاعدة من القواعد، ويدلل عليها، ويمثل لها بأمثلة واقعية موضحة، فهو مدخل ضروري لعلم الحديث؛ ولذا يسميه بعض العلماء: علم (أصول الحديث) إشارة إلى أنه مثل (أصول الفقه) لعلم الفقه.
• علوم العربية:
وبعد علوم الدين تأتي علوم العربية في المرتبة التالية. فعلوم الدين تمثل (المقاصد) وعلوم العربية تمثل (الوسائل)؛ ولذا كانوا يسمونها (العلوم الآلية). لأنها الآلة اللازمة لفهم الدين وعلومه. فالدين ـ كما شرعه الله ـ إنما هو نصوص قرآنية نزلت بلسان عربي مبين، أو نصوص حديثية تكلم بها رسول عربي بلغ القمة في البلاغة البشرية.. ولا يمكن فهم هذه النصوص الربانية والنبوية إلا بوساطة علوم العربية. ولهذا كان لهذه العلوم العربية في الأزهر مكان ومكانة منذ نشأته وإلى اليوم.
• النحو والصرف:
أبرز علوم العربية التي عني بها الأزهر: علم النحو، ومعه علم الصرف، وقد درسناه في المرحلة الثانوية مرتين كاملتين، متخذين من (ألفية بن مالك) الشهيرة في النحو والصرف وشرحها أساسا للدراسة المستوعبة.
ففي السنتين الأولى والثانية، درسنا شرح ابن عقيل المشهور على الألفية، وفي السنوات الثلاث الباقية: الثالثة والرابعة والخامسة، درسنا شرح العلامة المصري ابن هشام الأنصاري على الألفية، المسمى (أوضح المسالك إلى شرح ألفية ابن مالك). وقد كنت شخصيا أزيد على هذه الشروح بالرجوع إلى بعض الحواشي عليها، مثل حاشية الخضري على ابن عقيل.
والواقع أن دراسة النحو في المعاهد الدينية، قد يقال عنها: إنها نضجت حتى احترقت، وربما قيل: إنها أخذت أكثر من حقها، فقد درسنا النحو في القسم الابتدائي أربع مرات كاملة، كل مرة يدرس النحو بجميع أبوابه. ثم أعدنا دراسته في القسم الثانوي بتوسع وتعمق أكبر. وقد كان يكفي بعض هذا في رأيي. على أن هذه الدراسة برغم توسعها وتعمقها ينقصها شيء جد مهم، وهو الخروج من النظرية إلى التطبيق، فكثير من الذين يحصلون على 40 من 40 في امتحان النحو، لا يكادون يقيمون جملة سليمة إذا تكلموا.
• علم البلاغة:
ومن علوم العربية التي درسناها في المرحلة الثانوية: علم البلاغة، وإن شئت قلت: علوم البلاغة، لأنها تتضمن علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع.
وقد درسنا البلاغة في السنتين الأوليين في كتاب ألفه الشيخ الحملاوي، اسمه (زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع).
وفي السنوات الثلاث الثانوية، درسناها في كتاب (تهذيب السعد) ويقصد بـ (السعد) العلامة سعد الدين التفتازاني، الذي اشتهرت كتبه في علم الكلام وفي أصول الفقه، وغيرها. وقد شرح تلخيص المفتاح للقزويني في البلاغة، والمفتاح هو (مفتاح العلوم) للسكاكي.
وقد حول السعد البلاغة إلى علم معقد، يحتاج إلى معاناة لفهمه، وليس إلى مادة تتذوق، ويحس بجمالها الفني. مع أن ما كتبه الإمام عبد القاهر في (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) أقرب إلى السلاسة والإفهام، وأبعد عن التعقيد والإلغاز، مما كتبه السعد وغيره من بعده.
على أن (تهذيب السعد) كان ينقصه ـ ككل علوم العربية وكتبها القديمة ـ الإكثار من الأمثلة الأدبية البليغة من الشعر والنثر، حتى يتذوقها الطالب الدارس، ويجتهد أن يسير على غرارها.
وقد ألف الأستاذ علي الجارم المفتش بوزارة المعارف كتابا سماه (البلاغة الواضحة) حاول أن يتفادى فيه سلبيات الكتب القديمة، ويكثر من الأمثلة التطبيقية لمسائل البلاغة وعلومها، وقد تلقى علماء العربية كتابه بالقبول، وكذلك كتابه (النحو الواضح) بأجزائه ومستوياته .
• تاريخ الأدب العربي:
ومن علوم العربية التي درسناها: تاريخ الأدب العربي، وقد درسناه مرتبا حسب العصور التاريخية، من عهد الجاهلية، إلى العهد النبوي والراشدي، إلى عهد الأمويين فالعباسيين فالعثمانيين، إلى النهضة الحديثة.
وهي مادة شيقة ونافعة، كنا ندرسها في كتاب (الوسيط) الذي ألفه جماعة من كبار أساتذة الأزهر.
وقد كان التركيز فيه على تاريخ الأدب لا على الأدب نفسه. وربما كان في حاجة إلى كتاب آخر يكمله عن (الأدب) وفنونه من الشعر والخطابة والرسالة والمقامة والقصة والرواية والمسرحية والملحمة وغيرها من ألوان الأدب. كما أن هناك حاجة إلى إعطاء طالب الأزهر فكرة عن (النقد الأدبي) وأصوله.
• القراءة والمحفوظات:
وهناك مادتان من المواد العربية، يمتحن الطالب فيهما شفهيا، وليس لهما منهج واضح، ولا يستفاد مما قرر لهما من حصص في الخطة الدراسية. وهما: المطالعة والمحفوظات، أو ما عبر عنهما حديثا بـ (القراءة والنصوص). والواجب تحويلهما إلى مادتين يمتحن فيهما تحريريا، وتقرر فيهما أشياء واضحة ترفع من مستوى الطالب الأدبي وذوقه، وتطالبه بحفظ قطع أدبية من ورائع الشعر والنثر، حتى لا تترك بلا خطام ولا زمام.
• علم المنطق:
ومن العلوم التي درسناها في الثانوي: علم المنطق، ويراد به (المنطق الصوري) أو القياسي، أو (منطق أرسطو). وقد اختلف علماء المسلمين في شأنه، فمنهم من حرم تعلمه كالإمامين ابن الصلاح والنووي.
ومنهم من لم يكتف بتحريمه، بل زاد على ذلك، فنقده نقدا علميا موضوعيا رصينا، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية. الذي قال فيه: إنه علم لا يحتاج إليه الذكي، ولا ينتفع به البليد.
ومنهم من اعتبر تعلمه واجبا، وأن من لم يتعلمه ويضبط به علمه وفكره، فلا ثقة بعلومه، وسماه (معيار العلوم)، وذلك مثل الإمام الغزالي.
ويبدو أن الأزهر قد تبنى رأي الإمام الغزالي في ضرورة تعلم المنطق؛ لذا قرر تدريسه في معاهده الثانوية، وفي كلياته الجامعية، مثل أصول الدين والشريعة. أو لعله تبنى (القولة المشهورة الصحيحة) كما ذكر الأخضري في منظومته التي سماها (السلم) في علم المنطق.
وقد درسناه في السنتين الأوليين في كتاب (شرح السلّم) للأخضري، والسلم منظومة في علم المنطق، بدأه ببيان اختلاف العلماء فيه:
فابن الصلاح والنواوي حرما * وقال قوم: ينبغي أن يعلما
والـقولة المشهورة الصحيحة * جوازه لـكامل الـقريحة
ممـارس الـسنة والـكتاب * ليهتدي به إلى الـصواب
ورأيي أن طالب الأزهر في حاجة إلى أخذ فكرة مبسطة عن علم المنطق القديم هذا، وما فيه من (تعريفات) في جانب التصور، وما فيه من أدلة في جانب التصديق، وأنواع هذه الأدلة الحملية والشرطية، ومقدمات الدليل الصغرى والكبرى، وهذه المصطلحات تمتلئ بها كتب التراث عندنا، فلذا يلزم الطالب أن يأخذ فكرة عنها، حتى لا تلغز عليه هذه العبارات إذا قرأها، وهو لا بد قارئها.
وأرى أن يكمل بفكرة مكملة عن (المنطق الحديث) ومناهجه، ولا سيما المنهج الاستقرائي أو التجريبي الذي قامت على أساسه النهضة العلمية الأوربية الحديثة، وقد اقتبست هذا المنهج من الحضارة العربية الإسلامية، كما شهد بذلك بريغولث وجوستاف لوبون، وجورج سارتون، وأمثالهم من مؤرخي العلم.
• التاريخ:
كان يدرس لنا من المواد الاجتماعية: علم التاريخ. أما علم الجغرافيا، فقد درسناه في القسم الابتدائي.
والتاريخ مادة حية ولازمة، وقد دعا القرآن إلى الانتفاع بتاريخ الأولين، والاعتبار بما حدث لهم (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) يوسف:111 وقال: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) الروم:9 وتكرر هذا كثيرا في كتاب الله.
ولقد كان كثير من كبار علماء المسلمين فقهاء ومحدثين ومفسرين ومؤرخين، مثل: ابن جرير الطبري، كان شيخ المؤرخين، وهو شيخ المفسرين، وصاحب مذهب فقهي، ومثل ابن كثير وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم.
ولهذا كانت دراسة التاريخ عامة، والتاريخ الإسلامي خاصة، أمرا ضروريا لتكوين ثقافة حية متكاملة.
ولكن عيب دراسة التاريخ في المعاهد: أنها لم تجعل الإسلام محور دراسته، بل سارت على المنهج المتبع في وزارة المعارف، حذو النعل بالنعل، فجعل (مصر) هي محور التاريخ، وليس رسالة الإسلام، فأول ما درسناه: مصر القديمة: في عهد الفراعنة، وفي عهد الرومان والبطالمة، إلى الفتح الإسلامي.
ثم درسنا ظهور الإسلام، وحياة الرسول وغزواته، وعهد الخلفاء الراشدين، وعهود الأمويين والعباسيين، كلها في سنة واحدة. وقد درس الإسلام على أنه حدث تاريخي، لا على أنه رسالة رحمة وهداية للعالم. ولم تقدم معالم هذه الرسالة، ولا مجرد ملامح العظمة في شخصية صاحبها.
ثم درسنا الحروب الصليبية، وغزو التتار، ومقاومة المسلمين، وانتصارهم في النهاية، ولكن بروح غير الروح الإسلامية.
ثم كان الحديث عن المماليك على اختلافهم، ثم ظهور الدولة العثمانية، وغزوها لمصر، واستيلائها عليها سنة 1517م، وظهور الإصلاح الديني في أوربا، وبوادر النهضة الأوربية.
ثم كان الحديث في الجزء الرابع بتفصيل عن أوربا ونهضتها ووحدة أقطارها التي كانت مفككة، مثل الوحدة الإيطالية، والوحدة الألمانية، ثم ظهور نابليون وفتوحاته وصراعاته مع جيرانه من الإنجليز وغيرهم، وظهور الثورة الفرنسية، ومبادئها في الحرية والإخاء والمساواة. ثم كان التاريخ الحديث في السنة الأخيرة، وظهور محمد علي باشا، ومصر الحديثة، وثورة عرابي، واحتلال الإنجليز لمصر... إلخ.
المهم أن طالب الأزهر درس السيرة النبوية وتاريخ الإسلام كله دراسة سريعة سطحية، تبرز السلبيات أكثر مما تبرز الإيجابيات، وقد عرف عن نابليون بونابرت أكثر مما عرف عن محمد عليه الصلاة والسلام.
ولو كان (الإسلام ورسالته) محور الدراسة التاريخية، لوجب أن ندرس ما قبل الإسلام على أنه عهود الجاهلية المختلفة، عربية كانت أو فارسية أو رومانية أو هندية أو غيرها. وبيان تحريف الديانات الكتابية ذاتها. ثم يدرس الإسلام على أنه الرسالة الجديدة، التي جاءت لتخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور التوحيد، مع تقديم موجز مركز لمعالم هذه الرسالة في إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمة والعالم.
وتقديم الرسول باعتباره نموذج الكمال البشري، الذي يمثل التجسيد الخلقي للقرآن، والتطبيق العملي للإسلام، مع حديث مركز عن خصائص سيرته، ومعالم عظمته. وتقديم عهد الراشدين باعتباره امتدادا لعهده، وتقديم ما حدث من فتن في عهد عثمان وعلي في حجمها الحقيقي وشرح أسبابها والعوامل المؤثرة فيها، داخلية وخارجية. وكذلك الدول التي جاءت بعد ذلك: أموية وعباسية وعثمانية، مع إبراز ما قدمته من فتوح، وما أنجزته من حضارة، ما تركته من علوم وفنون وآثار.
وتقديم الصراع بين الإسلام وخصومه في الغزو الصليبي والتتري بما يبرز ضعف المسلمين وتفرقهم وتخاذلهم، مما مكن منهم عدوهم، ويبرز القوة الذاتية للإسلام، التي كانت وراء المقاومة الصلبة التي انتهت بطرد الغزاة الصليبيين، وتحول التتار إلى الإسلام.
وينبغي أن يدرس سقوط الأندلس وأسبابه، واستئصال جذور الإسلام من جنوب أوربا، وما جرى للمسلمين من وحشية على أيدي نصارى أسبانيا.
كما يدرس ظهور الدولة العثمانية على أنها تمثل (دورة جديدة) للإسلام زاحفة على أوربا من الشرق، وكيف نمت وازدهرت، ثم تآمرت عليها القوى الصليبية حتى اقتسموا تركتها.
كما ينبغي أن يدرس تاريخ أوربا باختصار في إطار هذا الصراع التاريخي، وكيف استفادت أوربا بما اقتبسته من المسلمين في الأندلس وصقلية، والاحتكاك بالحروب الصليبية، وغيرها من قنوات الاتصال. ثم ينبغي أن يدرس الاستعمار الحديث لبلاد الإسلام وما وراءه من دوافع مادية وأدبية، يتجلى في الأطماع والأحقاد والمخاوف والاستعلاء.
ومن المقررات المهمة التي يجب أن تطرح في علم التاريخ: مقرر (حاضر العالم الإسلامي) بحيث تطرح فيه أسباب وحدة هذا العالم، والقواسم المشتركة بين بلاده بعضها وبعض، وكيف كانت دولة واحدة يحكمها خليفة واحد، خلال التاريخ الإسلامي. ثم مزقت. وما عوامل ذلك؟ وما المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي؟ وما حلولها؟ وما الأخطار الداخلية والخارجية على هذا العالم؟ وما موقف الاستعمار والصهيونية والشيوعية منه؟… إلخ.
إن هذا المقرر الحي غائب عن علم التاريخ. ويجب أن يستفاد مما علق به أمير البيان شكيب أرسلان على كتاب (حاضر العالم الإسلامي)، ولكن يجب تحديثه، فحاضر هذا العالم يتغير، ويتطور بسرعة هائلة في الماديات والمعنويات، ويجب علينا حين ندرسه أن نلحظ ذلك كله.
• العلوم الحديثة:
ومما درسناه في المرحلة الثانوية: العلوم الكونية التي أطلق عليها اسم (العلوم الحديثة). ويعنون بها: علوم الفيزياء (الطبيعة) والكيمياء، والأحياء: الحيوان، والنبات.
وهذه العلوم التي سميت (حديثة) هي في الواقع (علوم قديمة) عندنا نحن المسلمين، بل كنا فيها أئمة وروادا، فقد كان علماؤنا الطبيعيون والرياضيون أشهر العلماء في العالم، وكانت كتبنا العلمية أشهر المراجع في العالم، وكانت جامعاتنا العربية الإسلامية موئل طلاب العلم في العالم، وكانت اللغة العربية هي لغة العلم الأولى في العالم، التي عجز أكثر أهلها اليوم أن يدرسوا بها الطب والهندسة والصيدلة والعلوم الطبيعية والرياضة.
وكثيرا ما كان علماء الدين أنفسهم هم علماء الدنيا وعلماء الطبيعة، ولم يجدوا من دينهم ما يعوقهم عن التفوق في هذه العلوم، بل وجدوا فيه الباعث والحافز والمحرك.
وأذكر من هؤلاء الفخر الرازي الذي قالوا: إن شهرته في علم الطب لم تكن تقل عن شهرته في علوم الدين.
ومثل ذلك ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى، ومع هذا كان من الفقهاء المعدودين، وقد ترجم له التاج السبكي في (طبقات الشافعية).
وكذلك ابن رشد الحفيد، الذي كان من أعظم الفلاسفة، وأعظم الأطباء صاحب كتاب (الكليات) في الطب، وكان من أعظم الفقهاء، كما دل على ذلك كتابه الفريد (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) وهو من أعظم ما ألف في الفقه المقارن وأسباب الاختلاف. وقد عرف بأنه القاضي ابن رشد.
فتسمية هذه العلوم الكونية بـ (الحديثة)، إنما هو بالنظر إلى العهود الأخيرة التي تراجعت فيها حضارتنا، وتخلفت فيها أمتنا، وتقدم غيرها، ونامت واستيقظ غيرها، ممن تتلمذ عليها، وقبس من نورها، ثم تفوق عليها، وأمست هي تتلمذ عليه، وتأخذ منه.
ولا غبار على تدريس هذه العلوم في معاهد الأزهر، إلا أنها كان ينقصها اللمسات الإيمانية، التي تدرس القوانين على أنها جزء من (سنن الله في الكون) وليست مجرد (قوانين طبيعية) كأن الطبيعة هي صانعتها. وكانت الكتب المؤلفة كثيرا ما تذكر أن الطبيعة زودت الكائن الفلاني بسلاح يدافع به عن نفسه، وكان الواجب والحق أن يقال: إن الله زود كل كائن بما يدفع به عن نفسه.
ويمكن أن يقوم المدرس بما ينقص الكتاب، لو تهيأ المدرس الذي يملك ثقافة علمية وإسلامية، ولم يكن مثل هذا متيسرا في ذلك الزمان.
كما يمكن أن يدخل في هذا الميدان بعض حقائق (الإعجاز العلمي في القرآن) إذا تهيأ المنهج وتهيأ له المدرس، ويمكن أن يؤخر ذلك إلى المرحلة الجامعية.
• سلبيتان شنيعتان: غياب اللغة الأجنبية.. وغياب روح الدعوة
وما لاحظته في المرحلة الابتدائية من غياب اللغة الأجنبية، استمر في المرحلة الثانوية، مع أني أرى حاجة الطالب الأزهري إليها، كما يحتاج إليها طلاب التعليم العام. بل ربما ظهرت حاجة بعضهم إليها أشد من غيرهم، لضرورتهم إليها في الدعوة إلى الإسلام، الذي جعله الله رسالة عالمية، فليس هو دعوة لإقليم من الأرض، ولا لشعب معين أو جنس خاص، كما أنه ليس لجيل محدود بزمن معين. إنه الرسالة العامة الخالدة الشاملة.
وكان يمكن اختصار بعض حصص النحو أو سواها لإعطائها للغة الأجنبية، دون أن يفقد الطالب كثيرا.
وأهم من ذلك كله: غياب (روح الدعوة) من الدروس المقررة، حتى من دروس المقررات الدينية نفسها: التفسير والحديث والفقه والتوحيد، كلها تشكو من (الجفاف الروحي) وتعاني حالة من الهمود والجمود، في المادة العلمية، وفي طريقة عرضها، وفي المعلم الذي يدرسها، فلا تدفع العقل ليبحث ويحقق، ولا الروح ليحلق ويشرق، ولا الإرادة لتعمل وتطبق.
على خلاف ما رأيته في (ندوة العلماء) و (دار علومها) بلكهنو بالهند، التي كان يشرف عليها العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي، حيث وجدت تعليمهم ومناهجهم وشيوخهم، تسري فيها الروح الدعوية، والمعاني الربانية، كما تسري العصارة في أغصان الشجرة اليانعة.
وقد قال شاعر الإسلام في الهند يشكو جفاف التعليم المدني العصري الذي أدخله الإنجليز في البلاد: إن هذا التعليم قد يعلم الطالب التأنق في الزي، والتشدق في الحديث، ولكنه لا يعلم عينيه الدموع، ولا قلبه الخشوع.
فإذا كان التعليم الأزهري مثل هذا التعليم المدني، لا يساعد الطالب على تزكية نفسه، والانتصار على شهواتها، ولا يعلم عينيه الدموع، ولا قلبه الخشوع، فماذا بقي له من أزهريته الحقيقية غير العمامة والجُبَّة (الكاكولة) إن بقيتا؟!



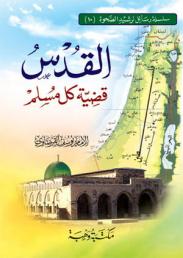 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






