لقد غيب الموت عبد الناصر، وطويت صفحته من دنيانا، ولقي ربه بما له وما عليه، وسيجزيه ربه بما يستحقه، يوم تبلى السرائر، إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، ولا يضيع عنده مثقال ذرة، ولا يخاف أحد عنده ظلمًا ولا هضمًا. ومعنى الظلم: أن يحمل وزر غيره، ومعنى الهضم: أن يضيع أجر عمله.
ومن الناس من إذا مات ماتت خطاياه معه، فطوبى له. ومنهم من يموت ولا تموت ذنوبه، بل تبقى من بعده آثار ظلمه وعدوانه، وهو الذي قال الله تعالى في أمثاله: {وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡ} (يس:12).
هل من حقنا أن نقف وقفة متأنية لتقويم عبد الناصر وعهده، وما فيه من حسنات وسيئات، وإنجازات وإخفاقات؟ هل كانت ثورة 23 يوليو خيرًا أو شرًّا على المصريين والعرب؟
ربما توقف بعض أهل الدين من الناحية الشرعية، وقالوا: نحن أُمرنا أن نذكر محاسن موتانا، وجاء في الحديث: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»(1). كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات(2)؛ لسببين: الأول: أنهم أفضوا إلى ما قدموا، وأمسوا عند رب عادل يحاسبهم.
والثاني: أن سب الأموات يؤذي الأحياء، ممن يهمه أمر الميت من أبناء وأقارب وأصحاب.
لهذا يتورع بعض المتدينين من الكلام عمن مات، وإن أصابه من ظلمه ما أصاب، ويكل أمره وجزاءه إلى من لا يخفى عليه خافية، ولا تضيع عنده مظلمة مظلوم، ولا حق مهضوم.
ولكن إذا كان السب ممنوعًا، فإن النقد الحق مشروع، لا سيما من كان يتحمل مسئولية عامة، فإن من حق الناس أن ينقدوا أعماله، ويثنوا على ما كان فيها من حق وخير، وينكروا ما كان فيها من باطل وشر. وهذا ما فعله المؤرخون المسلمون الأثبات في تقويم الخلفاء والأمراء، من بني أمية، وبني العباس وغيرهم. وقالوا: كان فلان عادلًا، وكان علان ظالمًا، وأوسعوا الحجاج بن يوسف ذمًّا وتجريحًا.
فالتعديل والتجريح من أجل مصلحة الدين، ومصلحة الأمة: أمر مشروع. وعلى هذا مضت سنة أئمة الحديث في خير القرون ومن بعدهم: يقولون عن الموتى في كتبهم: هذا مغفل، وهذا كثير الغلط، وهذا مدلس، وهذا كذاب، وهذا أكذب الناس؛ ليحذروا الأمة أن تثق بهؤلاء، أو تأخذ عنهم الدين.
وسيظل من حق المظلوم: أن يصرخ شاكيًا من ظالمه، حيًّا كان أو ميتًا، ما دامت مظلمته قائمة، كما قال تعالى: {لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} (النساء: 148).
فلسفتي في تجميع كل القوى:
وأنا لا أريد - بحق - أن أنكأ الجراح، ولا أن أنبش القبور، ولا أن أُذكِّر بالماضي الأليم، ولا سيما في هذا الوقت الذي تواجه الأمة فيه أخطارًا جسامًا، وقد كاد لها أعداؤها كيدًا، ومكروا بها مكرًا كبّارًا.
وقد عرفت من سيرة الإخوان ومن أخلاقهم: أنهم لا يحاولون أن يثأروا ممن ظلموهم، بل يدخرون ما أصابهم عند الله، الذي لا يضيع عنده عمل عامل، ولا يُظلم أحدًا مثقال ذرة، وهو الذي سيأخذ لهم حقهم، ويجزيهم، الجزاء الأوفى.
وهذا ما سجله تاريخهم في عهد الملكية، وعهد الثورة. وقد كان بوسعهم أن ينتقموا من ظالميهم الذين ساموهم سوء العذاب، بعد أن ترك كثير من هؤلاء مناصبهم، وزال سلطانهم، فأصبحوا بلا ظفر ولا ناب! ولكنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يفكروا فيه، وتركوا ذلك للقدر الأعلى، الذي ثأر لهم من خصومهم، فرأوا نهايتهم السوداء في حياتهم.
رأوا «حمزة البسيوني» وقد دخلت سيارته في سيارة أمامها في الليل، تحمل أسياخًا من الحديد، حطمت سيارته، وقطعت جسده تقطيعًا. ورأوا «شمس بدران» يدخل السجن معهم، ولكنه لم يكن متماسكًا كما كانوا، بل كان ذليلًا منهارًا، يبكي بكاء الأطفال!
ومن هنا لا تعجبوا إذا دعوت إلى نسيان المظالم والمآسي الماضية، وحثثت على رصّ الصفوف، وتجميع القوى كلها، لمواجهة الخطر المحدق، ومقاومة العدو الشرس، قائلين: عفا الله عما سلف. ولهذا رحبت باجتماع القوميين والإسلاميين من العرب في صورة المؤتمر القومي الإسلامي، وكنت أحد الذين اشتركوا في إعداد الورقة التي تمثل الجانب الإسلامي، وحضرت أكثر من مرة دورات هذا المؤتمر في بيروت. ولا شك في أن «الناصريين» في مصر وفي غيرها من العالم العربي: جزء أساسي من هذا المؤتمر.
ومع هذا لا يسعني - وأنا أتحدث عن هذا الجانب المهم من التاريخ في سيرتي ومسيرتي - أن أتجاهل ذلك، وأغض الطرف عنه، وسيلومني الكثيرون أني لم أقل رأيي، وقد وعدت قارئ هذه المذكرات في الجزء الثاني: أن أقول رأيي في عبد الناصر وعهده عندما يأتي الحديث عن وفاته. وكل من يتعرض للعمل العام لا بد أن يتعرض للنقد في حياته وبعد مماته.
الاختلاف الشديد في عبد الناصر:
ولا ريب في أن الناس في رجل كعبد الناصر جد مختلفين، فله أنصار يرتفعون به إلى أعلى عليين، وله خصوم يهبطون به إلى أسفل سافلين. وبين مدح المغالين في المدح، وقدح المبالغين في القدح: تضيع الحقيقة.
ومما لا يخفى على ذي لب: أن عين المحب لا ترى عيبًا فيمن تحب، ولا ترى غير المحاسن والمزايا، كما ورد: «حبك الشيء يُعَمِّي ويُصِمّ»(3)، وعين الكاره والساخط لا ترى غير العيوب والسقطات. وهذا ما عبر عنه الإمام الشافعي من قديم بشعره الذي يحفظه الخاص والعام:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ** كما أن عين السخط تبدي المساويا
وهل يستطيع إنسان أن يتجرد من عواطف الحب والكره، أو الرضا والسخط، وينظر إلى من يقومه نظرة «موضوعية» خالصة، بعيدة عن «الذاتية» تمامًا؟
لا يجرؤ بشر أن يدعي ذلك، وإن بلغ في تزكية النفس ما بلغ، فلا بد أن تغلبه بشريته، فيحاول - واعيًا أم غير واع - أن يضخم بعض الهنات الصغيرة، أو يصغر بعض الحسنات الكبيرة، أو نحو ذلك.
ولقد توقفت فترة من الزمن في تقويم عبد الناصر، بوصفي ممن جرحتهم سهامه، وأصابهم ظلمه، ولا تزال آثار جراحه في جسده، وآثار مظالمه في نفسه، تأتيه في صورة كوابيس بالليل، وذكريات أليمة في النهار، ومضايقات في أشكال شتى، منها ما يعرفه الناس، ومنها ما لا يعرفونه. ومن كان في مثل حالي ربما لا يتوقع منه أن يكون منصفًا في تقويم الرجل.
ويهمني أن يعلم قارئي أني لا أدعي العصمة لنفسي، ولا أزعم أني فوق البشر الذين يتأثرون بمشاعر الحب والبغض، ولكني أرجو أن أسلك «النهج الوسط» الذي اخترته منهاجًا لي في حياتي كلها، ورضيت به، وأحب أن ألقى الله عليه. لقد رأيت من الناس من يجعل من عبد الناصر: ملاكًا رحيمًا، وبطلًا أسطوريًّا، وقائدًا لا يشق له غبار، وسياسيًّا فاق السياسيين، ومصلحًا بز المصلحين!
هو عندهم منقذ وطني، ومحرر سياسي، وزعيم عربي، ورائد إفريقي، وربما أضافوا إليه: وقائد إسلامي! فهو الذي دبر الثورة، وطرد الملك، وحرر مصر من الإقطاع، وحررها من الإنجليز، وهو داعية القومية العربية، والتحرر الإفريقي، وأحد أبطال كتلة عدم الانحياز، ومنشئ المؤتمر الإسلامي في مصر.
وزعم بعض المداحين: أنه سمع خطباء مصر الثلاثة: «مصطفى كامل، وسعد زغلول، وجمال عبد الناصر» فوجده أبرز الثلاثة وأقدرهم على التأثير في الجماهير بلغته الشعبية السهلة! «أي بلغته العامية المبتذلة فاق الخطباء الذين تدرس خطبهم في كتب الأدب»!!
إلى آخر ما يروج من سلع المديح والإطراء والمبالغات في سوق النفاق، حتى سمى بعض الكتاب مصر في ذلك العهد: «نفاقستان»!
وما تضخه أجهزة الإعلام بمختلف أدواتها وألوانها من مواد مقروءة أو مذاعة أو متلفزة، كلها مسخرة لتمجيد الزعيم، وأقوال الزعيم، وأعمال الزعيم، وأفكار الزعيم، وبطولات الزعيم؛ لا تتوقف، ولا تتوانى، يومًا ولا بعض يوم حتى مات! بل بعد أن مات إلى يوم 15 مايو 1971م يوم ضرب السادات «مراكز القوى» الناصرية - التي ظلت تحكم باسمه من بعده - ضربة قاضية، لم تقم لها بعدها قائمة.
هنا بدأ المخبوء ينكشف، والمستور يظهر للعيان، والذي أخرسه الخوف يتكلم، والمخدوع بالدعاية والشعارات ينزع الغشاوة عن عينه ليرى، وبدأت الصحف «القومية المؤممة» تفيض بالمقالات والتحقيقات والتعليقات، وأصحاب الأعمدة اليومية يفضون بما كتموه في صدورهم.
وظهرت كتب كثيرة تتحدث عن مظالم تلك الفترة، وعن مآسي تلك السنين، وعن الأموال التي هلكت، وعن الفرص التي ضاعت، وعن القباب الضخمة التي شيدت وليس تحتها شيخ، وعن الدعايات الهائلة التي ضللت الشعب، حتى جرى وراء السراب يظنه ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا!!
ظهر كتاب توفيق الحكيم: «عودة الوعي» يبين فيه أنه عاش غائب الوعي طوال تلك السنين، مخدوعًا بالدعاية المضللة، حتى انكشف القناع، وعاد إليه الوعي! وظهر كتاب جلال الحمامصي: «حوار وراء الأسوار»، وكتاب المستشار محمد عبد السلام: «سنوات عصيبة»، وكتاب سامي جوهر: «الصامتون يتكلمون»، وكتاب محمد عبد الرحيم عنبر: «محاكمات جمال عبد الناصر»، وكتابه: «ويل لهؤلاء من محكمة التاريخ»..
وكتاب محمد شوكت التوني: «قضية التعذيب الكبرى»، و«محاكمات الدجوي»، وكتاب: «في معتقل أبي زعبل» لإلهام سيف النصر، وكتاب د. إبراهيم عبده: «رسائل من نفاقستان»، و«مذكرات عبد اللطيف البغدادي»، وكتاب: «كلمتي للتاريخ ... كنت رئيسًا لمصر» للرئيس محمد نجيب، وكتاب صلاح الشاهد: «ذكرياتي بين عهدين»، وكتاب محمد أنور رياض: «القابضون على الجمر»، وكتاب عادل سليمان وعصام سليمان: «شهداء وقتلة في عهد الطغيان»..
ومصطفى أمين في كتبه: من «سنة أولى سجن» إلى «سنة تسعة سجن»، وكتاب: «عبد الناصر» لأحمد أبو الفتح، وكتاب أنيس منصور: «عبد الناصر المفترَى عليه والْمُفترِي علينا»، وما كتبه أحمد رائف: «البوابة السوداء»، و«سراديب الشيطان»، وما كتبه الدكتور أحمد شلبي في الجزء التاسع من موسوعة التاريخ الإسلامي عن حوليات عصر جمال عبد الناصر، الذي سمّاه: عصر المظالم والهزائم. وكتب لا أذكر أسماء مؤلفيها، مثل: «أموال مصر، وكيف ضاعت؟»، وكتاب: «الموتى يتكلمون».
وهذا غير ما كتبه الإخوان مثل: زينب الغزالي «أيام من حياتي»، ومثل: جابر رزق «مذابح الإخوان في سجون ناصر»، ود. علي جريشة في عدد من كتبه: «في الزنزانة»، و«دعاة لا بغاة»، و«عندما يحكم الطغاة»، وحسن عشماوي «الإخوان والثورة»، واللواء عبد المنعم عبد الرءوف في كتابه: «أجبرت فاروق على التنازل عن العرش»، وعباس السيسي في كتابه: «في قافلة الإخوان المسلمين»، ومحمود عبد الحليم في كتاب: «الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ»..
وعمر التلمساني «قال الناس ولم أقل في حكم عبد الناصر»، ومحمد حامد أبو النصر «سر الخلاف بين عبد الناصر والإخوان»، وصلاح شادي «صفحات من التاريخ»، وجابر الحاج «زلزال التآمر الناصري»، وكتاب: (25 عامًا في جماعة مرورًا بالغابة) لحسن دوح، وكتاب: «عندما غابت الشمس» لعبد الحليم خفاجي، وغيرها.
وهناك «أفلام» عبرت عن هذه الحقبة المظلمة الظالمة، وإن لم تذكر الأسماء صراحة، مثل: فيلم «البريء»، وفيلم «الكرنك»، و«ليل وقضبان»، و«شيء من الخوف»، وغيرها.
وإذا كنا رأينا من جعل من عبد الناصر «ملاكًا رحيمًا» وأضفى عليه من الفضائل ما أضفى، وجعل تاريخه أبيض من الثلج، ولم يحاسبه على خطيئة ولا خطأ واحد؛ لأنه لم يصدر منه شيء من ذلك؛ فهناك فريق آخر، على النقيض من هؤلاء، جعل من عبد الناصر: «شيطانًا رجيمًا»: يجرده من كل فضيلة، وينسب إليه كل رذيلة، ولا يضيف إلى رصيده حسنة واحدة، فثورته كانت وبالًا على مصر والعرب، وعهده كان شرًّا وبلاءً على المصريين والعرب والمسلمين.
ويتمنى هؤلاء العودة إلى عهد الملكية البائدة، قائلين: إن عهد الملك فاروق - على ما كان من فساد وانحراف - لم ترتكب فيه من المظالم والشرور ما ارتكب في عهد عبد الناصر.
حتى الحسنات الظاهرة في عهد عبد الناصر، مثل: «تأميم قناة السويس» التي صفقت لها مصر، وصفق لها العرب جميعًا؛ ضنوا أن يحسبوها في ميزانه، وقالوا: إنه استعجل في أمر كان سيتم طبيعيًّا بعد ثلاثة عشر عامًا، بدون أن يجازف بالدخول في حرب مع دول كبرى كبريطانيا وفرنسا، وأن يتيح فرصة لإسرائيل لتدخل معهم في حرب ضد مصر.
ونسي هؤلاء أن الشركة الاستعمارية العتيدة، كانت تخطط لاستمرار السيطرة على القناة، وربما لو تركهم حتى تنتهي المدة، ولم يفاجئهم بقرار التأميم، لكانوا أعدوا العدة لإفشال أي محاولة للاستيلاء على القناة.
وحتى بناء «السد العالي» ذكروا من آثاره السلبية ما ذكروا، وأنه «هدف عسكري» سهل لإسرائيل، يمكن أن تلجأ لضربه في ساعة البأس، عندما تحيط بها المخاطر في وقت ما، وفي هذا غرق مصر وهلاك الحرث والنسل.
ويأخذون عليه: أنه ضيع جهودًا وأموالًا في مغامرات فاشلة، في الكونغو، وفي اليمن، وفي غيرها. وأنه لم يدخل حربًا إلا خسرها، كما في سنة 1956م، وسنة 1967م. وقد استطاع إعلامه الذي برع في الكذب وقلب الحقائق: أن يجعل هزيمة سنة 1956م نصرًا يحتفل به كل عام. مع أن البغدادي يقول في مذكراته: إنه قال له: نحن ضيعنا البلد. وإنه ليس أمام مجلس الثورة وأعضائه إلا أن ينتحروا جميعًا. وطلب من زكريا محيي الدين، إحضار زجاجة من السم «سيانور البوتاسيوم» تكفي لعدد الأعضاء، وأكد كلامه بقوله: إني جاد فيما أقول!(4)
وينقمون عليه: أنه قهر الشعب المصري، وأهان كرامته، وأذل كبرياءه، وحطم نفسيته، وقيد حريته، وكبله بالأغلال التي جعلته غير قادر على الحركة يمنة أو يسرة.
ويضيفون إلى مآثمه: أنه ألغى الحياة الديمقراطية من مصر، وهي من أوائل الديمقراطيات في الشرق، وفرض على الناس دكتاتورية الحزب الواحد، الذي اختلفت تسميته من: «هيئة التحرير» إلى «الاتحاد القومي» إلى «الاتحاد الاشتراكي» ولم يسمح لمعارض أن يكون له صوت يسمع، وإن كان من رفقائه في الثورة، ابتداءً من رشاد مهنا، إلى محمد نجيب، إلى خالد محيي الدين، إلى عبد المنعم عبد الرءوف، إلى آخرين.
حتى خطيب ثورته والمتحدث الديني باسمه، لم يسلم من أذاه وبطشه، وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري، فقد طوح به، وطرده من منصبه شر طردة، لا لشيء إلا لأن رجلًا ذم عبد الناصر، وهو الأديب المحقق المعروف محمود محمد شاكر، وكان الباقوري يزوره في ذلك الوقت، ولم يدافع عنه.
وقد قيل: إن الباقوري لم يكن حاضرًا وقت الكلام عن عبد الناصر! على أن الذين يعرفون الأستاذ شاكرًا وطبيعته الحادة، لا ينتظرون من الباقوري ولا من غيره أن يرد عليه!
وقد ابتلى مصر بفكرة: أن يكون للعمال والفلاحين نصف مقاعد مجلس النواب، وهي بدعة لم تتخلص مصر منها إلى اليوم، ولم تُعرف في بلد غير مصر! ويزيدون على ذلك: أنه أضر بالاقتصاد المصري، نتيجة سيطرة القطاع العام، الذي أخفق في إدارة مؤسساته، حتى أصبحت تخسر خسارات فادحة، بعد أن كانت تكسب مكاسب هائلة، يوم كانت ملك القطاع الخاص.
ولا ينسى هؤلاء أن يضعوا في ميزان سيئاته: الإساءة إلى الدين والشريعة، حين ألغى المحاكم الشرعية، وأساء إلى قضاتها بتلفيق تهم لهم لم يثبتها قضاء عادل، وأصدر قانون تطوير الأزهر: الذي يتاح فيه للكليات المدنية في جامعة الأزهر: أن تأخذ خيرة طلابه، وأن لا يبقى للكليات الأصلية الدينية «أصول الدين والشريعة واللغة العربية» غير المتردية النطيحة وما يعاف السبع أن يأكله! هذا مع أني رفضت هذا التفسير، ودافعت عن التطوير في الجزء الثاني من هذه المذكرات.
كما سَخِر عبد الناصر من علماء الدين في خطبه، واتهمهم بأن أحدهم من أجل وليمة عند إقطاعي، يقدم فيها خروف أو ديك رومي: يبيع دينه، ويصدر فتواه في إقرار المظالم الواقعة على الفلاحين، وهضم حقوقهم، وأكل عرقهم.
كما أتاح للصحف الحكومية أن تسخر بالدين وعلمائه، كما فعل الرسام الشهير صلاح جاهين في صحيفة «الأهرام» الذي سخر قلمه للسخرية بالداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي وعمامته في 18 رسمًا كاريكاتيريًّا.
هذا ما ذكره خصوم عبد الناصر عن شخصه، وعن عهده. وليس كل ما قالوه حقًّا، كما أنه ليس كله باطلًا.
ثم إني أفرق تفريقًا واضحًا بين أمرين: أولهما: ما كان من «اجتهادات» قد تصيب، وقد تخطئ، وهو مأجور على صوابه، ومعذور في خطئه، بل ربما كان مأجورًا أجرًا واحدًا؛ إذا صحت نيته، وتحرى في اجتهاده، واستشار أهل الذكر والخبرة، واستفرغ وسعه في الوصول إلى الحقيقة والرأي الأرشد.
وذلك مثل سياسته في إفريقيا وفي اليمن وفي غيرها، فأقصى ما يقال فيها: إنه سياسي فاشل. وفرق بين الفاشل والظالم! ولكن الفشل إذا تكرر واستمر يصبح كارثة على الوطن، وعلى الأمة. ففشل الفرد العادي وإخفاقه على نفسه، أما فشل الزعيم المستمر، ففيه خسارة الأمة وتأخرها، وضياع فرصها في النهوض والتقدم.
وثانيهما: ما كان من مظالم ومآثم متعمدة، كما حدث لمعارضي عبد الناصر عامة، وللإخوان المسلمين خاصة، فلا يستطيع مدافع أن يدافع عن عبد الناصر، في إيقاع هذا الكم الهائل من المظالم والمآثم: من شنق وتقتيل، وتشريد وتنكيل، وإيذاء وتعذيب، ومصادرة وتضييق، لجماعة كانت هي أول من ساند ثورة عبد الناصر، بل كانت هي أول من أوحى إليه بضرورة العمل الوطني داخل الجيش، كما اعترف عبد الناصر بنفسه في المذكرات التي كتبها الأستاذ حلمي سلام رئيس تحرير المصور بعنوان: «الثورة من المهد إلى المجد»، وذلك أوائل ما قامت الثورة..
وقال فيها: إن أول من لفت نظره إلى هذا العمل: هو الصاغ ذو الوجه الأحمر م. ل، يقصد: محمود لبيب، أحد العسكريين الأحرار الذين عملوا مع عزيز باشا المصري، وكان وكيلًا للإخوان في عهد المرشد الأول حسن البنا.
بعض الناس يهونون من الأهوال التي عاناها الإخوان، ولو ذاقوا معشار ما ذاقوا، لكان لهم رأي آخر، وقول آخر. وقد قيل: النار لا تحرق غير القابض عليها. وقال الشاعر: لا يعرف الشوق إلا من يكابده ** ولا الصبابة إلا من يعانيها!
والقرآن يقرر مع كتب السماء: {أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (المائدة:32)، ويقول رسول الإسلام: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم»(5).
ومن العجب أن يتحدث هؤلاء عن أهمية حقوق الإنسان، وحقوق الأفراد، وحق الحرية المقدس، وحق الفرد في أن يأمن على نفسه وأهله وماله وخصوصياته.. فإذا وصل إلى الإخوان: استثناهم من هذا كله، كأنما ليست لهم حقوق، وإذا وصل إلى عبد الناصر: استثناه من هذا كله، كأنما ليس عليه واجبات، وكأن من حقه أن يصادر ويعذب ويظلم ويبغي في الأرض بغير الحق. بلا حسيب ولا رقيب.
ولقد بينت في حديثي عن السجن الحربي في الجزء الماضي: مسئولية عبد الناصر عن الجرائم الوحشية والاعتداءات الهمجية، التي وقعت في السجن الحربي، وأنه شهد بنفسه بعض وقائع التعذيب، وأنه لا يعقل أن يتم هذا الذي تناقله الناس في الآفاق دون علمه، وقد ذكرنا أن «هيكل» مؤرخ عبد الناصر اعترف بأنه كان يعلم، وعرضت عليه وقائع، فلا معنى لتبرئته بدعوى أنه يجهل ما يجري!
وحتى لو لم يعلم، فهو المسئول الأول عن هذه الوحوش الآدمية، التي عينها في مناصبها لتنهش لحوم الناس، وتفترسهم، وهم مطمئنون إلى أنهم محميون، وأن ظهورهم مسنودة إلى جدار السلطان. إن رسولنا الذي لا ينطق عن الهوى: أخبرنا أن امرأة أدخلها الله النار، من أجل هرة حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض(6).
هذا في حبس هرة، فكيف بمن حبس الألوف من الناس، وسقاهم كئوس العذاب، وجرب فيهم ما استورده من أدوات التعذيب من عند الشيوعيين أو غيرهم، وسلط عليهم كلاب البشر، وكلاب الكلاب، وقد كانت الكلاب الحقيقية أرحم من الكلاب البشرية في كثير من الأحيان.
إن شر ما فعله عبد الناصر في مصر: أنه أذل الإنسان المصري وقهره، وأحياه في خوف دائم؛ أن يدهمه زوّار منتصف الليل، أو زوار الفجر، من كلاب الصيد، فتتخطّفه، وتذهب به إلى مكان سحيق وراء الشمس، لا يستطيع أحد الوصول إليه، وقد أصبح المصريون يتجسس بعضهم على بعض، ويشك بعضهم في بعض، حتى أصبح الأخ يتجسس على أخيه، بل الابن على أبيه، وفقدت الأسرة الثقة بعضهم ببعض.
وقد اعترف الرئيس أنور السادات في كتابه: «البحث عن الذات» بما زرعته الثورة من خوف ملأ صدور الناس، وشل إرادتهم، حين قال: انتهى مجلس الثورة في 22 يونيو سنة 1956م، عندما انتخب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية بالاستفتاء. ولكن قبل أن ينتهي المجلس كان الشعور بالخوف قد عم البلاد.. هذا في رأيي أبشع ما يمكن أن يصيب الإنسان! فالخوف يقتل الشخصية، ويشل الإرادة، ويمسخ تصرفات البشر!(7).
وقال في حديث له في «الأهرام»: لاحظت أن أكبر خطأ ارتكب في حق الإنسان المصري: كان هو زرع الخوف. فبدلًا من أن نبني الإنسان، أصبح همنا أن نخيفه، والخوف أخطر ما يهدم كيان الفرد أو الشعب. فقد كانت أرزاق الناس كلها ملكًا للحاكم: إن شاء منح، وإن شاء منع. وكان المنع مصحوبًا في أغلب الأحيان بمصادرة حرية الفرد واعتقاله، ثم فصل جميع أهله من وظائفهم، مع اتخاذ إجراءات ضدهم!(8).
وأحسب أن السادات شاهد من أهلها، فهو من صناع ثورة يوليو، ونائب عبد الناصر، وعضو اليمين في «محكمة الشعب» محكمة جمال سالم، التي حاكمت الإخوان.
إن خسارة الإنسان المصري هي الخسارة الكبرى، وليس الإنسان المصري هو هؤلاء الذين يتجمعون في السرادقات في الاحتفالات المعدة، ويلقّنون هتافات يرددونها كالببغاوات: ناصر، ناصر.
وأذكر أن عبد الناصر ذهب إلى إحدى المدن في أول الثورة، فهتف الناس باسم نجيب، فثار عليهم، وقال في حرقة وبحرارة: إنما قمنا لنحرر الناس من عبادة الزعماء، والهتاف للأشخاص، لكي يكون الهتاف للوطن. فلما أصبح بعد ذلك الهتاف باسمه أصبح مشروعًا ومحمودًا.
لقد أذل عبد الناصر الشعب المصري، كما أذل الحجاج بن يوسف الشعب العراقي من قبل. وكان في ذلك خسارة معنوية لا تقدر بثمن، ولا تقاس بالمادة. لقد أراد عبد الناصر أن يدير مصر، كما يدير صاحب الدكان دكانه، أو صاحب المزرعة مزرعته.
وقد قال مرة: أريد أن أضغط على زر، فتتحرك مصر كلها من أسوان إلى الإسكندرية! وأضغط على زر آخر فتسكن مصر كلها. ولقد قال لي مرة أحد شيوخنا الفضلاء «الدكتور محمد يوسف موسى»: إن هذا البلد سجن كبير، له باب واحد، وقفل واحد، ومفتاح واحد، في يد سجان واحد، هو عبد الناصر!
وإن كان هذا «السجان» قد غدا في فترة من الفترات «سجينًا» لدى بعض مرءوسيه، كما هو معروف في سيرة عبد الناصر: أن عبد الحكيم عامر، صديقه الأول قد أصبح هو الذي يحكم مصر حقيقة، سواء ما يتعلق بالجيش أم ما يتعلق بالشعب، وصار عبد الناصر «طرطورًا» أو «ديكورًا»، صار كما قيل: يملك ولا يحكم!
وفي قضية «الوحدة العربية» جاءت الوحدة الاندماجية مع سوريا إلى عبد الناصر على طبق من ذهب، ورضي الشعب السوري أن يُصهر مع الشعب المصري في بوتقة واحدة، وتنازل الرئيس السوري «شكري القوتلي» عن كرسي رئاسته، واكتفى بأن يكون «المواطن العربي الأول». ولكن عبد الناصر، بسوء تصرفه، وغلبة الاستبداد عليه، وتركه الأمور في الإقليم الشمالي لـ «عامر» يتصرف فيها كيف يشاء، بدل أن يعين نائبًا حقيقيًّا له من زعماء سوريا أنفسهم.
لقد سلط عامر أجهزة المخابرات - أو المكتب الثاني كما يسميها السوريون - على الشعب السوري، وعبث عبد الحميد السراج وبطانته بحريات الشعب وحرماته ومقدراته، فلم يكن من الشعب السوري الذي قدم الوحدة ورضيها إلا أن يرفضها ويتخلص منها، فاختار نار الانفصال مع الحرية، ولا جنة الوحدة مع الاستبداد. وكان الضابط عبد الكريم النحلاوي، مدير مكتب عامر في سوريا، أحد الذين قادوا حركة الانفصال!
هذا في قضية الوحدة العربية، فماذا فعل عبد الناصر في قضية فلسطين؟
لقد انتهى مصير القضية إلى نكبة حزيران أو يونيو 1967م، واحتلت إسرائيل ما بين القنطرة في مصر والقنيطرة في سوريا. أي احتلت سيناء والجولان مع الضفة الغربية وغزة، بل اعترف عبد الناصر بلسانه في خطابه في 23 يوليو 1967م: أن الطريق كان مفتوحًا أمام إسرائيل إلى القاهرة ودمشق.
لقد ظهر أن هناك أخطاء فادحة ارتكبت قبل هذه الحرب، وفي أثناء هذه الحرب، كتب عنها الكاتبون والمحللون السياسيون، والخبراء الاستراتيجيون، وقد سميت: «حرب الأيام السبعة»، والواقع أن النتيجة حسمت بعد الساعات الست الأولى، بعد القضاء على طيران مصر، ومطارات مصر بضربة قاضية وسريعة، أبقت القوات البرية المصرية في سيناء مكشوفة بلا غطاء(9).
وكانت الروح المعنوية في غاية الوهن إلى حد الانهيار؛ إذ لم يسلح الجندي المصري بسلاح الإيمان الذي به يتخطى العقبات، ويصنع البطولات، ويقدم الغالي من التضحيات. كانوا يوزعون على الجنود صور المطربات والممثلات، بدل أن يوزعوا عليهم المصاحف للمسلمين، والأناجيل للمسيحيين!
لم يسلح المقاتل المصري بعقيدة تشد أزره، بأنه يقف في وجه عدو دنس المقدسات، واغتصب أرض النبوات، أرض الإسراء والمعراج، وأن هذا العدو خطر على ديننا ودنيانا وأوطاننا ومقدساتنا، وأن وقوفنا في وجهه جهاد في سبيل الله، وأن من قُتل منا فهو شهيد حي يرزق عند الله.
لم يقل له مثل هذا الكلام؛ لأن هذا كلام الرجعيين، الذين يوظفون الدين في مثل هذه المعارك، والمطلوب منا: أن نوظف الدبابة والطائرة والبارجة، وندع الدين للعجائز وخطباء المساجد، أو رهبان الكنائس.
على حين كان العدو يسلح جنوده بعقيدة إيمانية، ورؤية توراتية، وأحلام تلمودية؛ ولهذا قلت: إنهم انتصروا علينا؛ لأنهم دخلوا المعركة ومعهم التوراة، ودخلناها وليس معنا القرآن، دخلوها يهودًا يعتزون باليهودية، ولم ندخلها نحن مسلمين نعتز بالإسلام.
دخلوا يهتفون باسم موسى، ولم نهتف باسم محمد. قالوا: الهيكل، ولم نقل: الأقصى. عظموا السبت، ولم نعظم الجمعة. كان الدين عندهم شرفًا يباهون به، وكان الدين عندنا تهمة نبرأ منها!
لقد جردوا القضية من كل معنى ديني لها، في حين قال «موسى ديان» وزير الدفاع: إن جيش إسرائيل مهمته حماية المقدسات، لا مجرد حماية المؤسسات، حتى العلمانيون من الإسرائيليين أمثال «بن جوريون»، وظّفوا الدين لخدمة قضيتهم.
ولهذا كان جنودنا فارغين من كل معنى روحي يدعوهم إلى الثبات والتضحية، فلما وقعت الواقعة، كان كل واحد منهم يقول: النجاة، النجاة. تركوا أسلحتهم ودباباتهم ومجنزراتهم دون أن يكلف أحدهم نفسه أن يشعل فيها عود ثقاب، حتى لا يستفيد منها عدوه، ويأخذها غنيمة باردة، سالمة من كل سوء.
إن من المعروف أن الأسلحة لا تقاتل وحدها، ولكن تقاتل بأيدي رجالها الأبطال، واليد التي تستعمل السلاح إنما يحركها هدف سام، مرتبط برسالة عليا، يؤمن بها الجندي، ويضحي بالنفس والنفيس في سبيلها.
وقد انتهت المعركة بما سموه: «النكسة»، ولكن أخطر من النكسة هو تغيير السياسة العربية رأسًا على عقب، واتخاذ فلسفة جديدة مناقضة للفلسفة القديمة تمامًا. فقد كانت فلسفة الأمة قائمة على أن إسرائيل اغتصبت أرض العرب بالعنف والإرهاب والدم والحديد والنار، وشردت أهلها - بعد أن أخرجتهم منها - في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وأن وجود إسرائيل في أرض فلسطين، وأرض العرب المغتصبة: وجود باطل، وأن إزالة هذا الاغتصاب الظالم فريضة على الأمة، طال الزمن أم قصر، فإن مضي الزمن لا يجعل الباطل حقًّا، ولا يقلب الحرام حلالًا.
وهذا ما كان عليه العرب قبل هذه النكبة أو النكسة، ولكن عبد الناصر تبنى فلسفة جديدة، تقوم على إزالة آثار العدوان! أي عدوان 1967م، وكأن هذا العدوان الجديد أعطى الشرعية للعدوان القديم: عدوان 1948م. عبد الناصر هو المسئول الأول عن تغيير السياسة العربية كلها في هذا المجال. فلم يكن أحد غيره يقدر على تغيير هدف الأمة التي أسلمت إليه القياد، ومنحته الثقة.
وهذا التنازل الكبير، بل الخطير، هو أساس كل ما عانته الأمة بعد ذلك من تنازلات جر بعضها إلى بعض، من كامب ديفيد، فمدريد، فأوسلو، حتى حالة الاستسلام والتخاذل التي نشهدها اليوم. فهو الذي غير الاستراتيجية الأصلية - استراتيجية الجهاد والكفاح - إلى استراتيجية التنازل والاستسلام. والأمة إذا بدأت طريق الانحدار، فلن يوقفها حاجز ولا شيء، حتى يسعفها القدر بمن يردها إلى أصلها، ويشعل ما انطفأ من جذوتها.
هل كان عبد الناصر عميلًا؟
ومما يُسأل عنه هنا: هل كان عبد الناصر عميلًا؟ ولقد اتهم بعض خصوم عبد الناصر بأنه كان عميلًا لأمريكا، وكتب الصحفي المعروف محمد جلال كشك، كتابًا سمَّاه: «ثورة 23 يوليو الأمريكية»! قال فيه كلامًا كثيرًا، وذكر فيه وقائع شتى.
وآخرون قالوا: إنه انتهى عميلًا روسيًّا، وللاتحاد السوفيتي، وكتب بعضهم كتابًا قال فيه: الروس قادمون!
بل سمعت من قال: إنه عميل لإسرائيل، وإنه التقى بعض اليهود عندما كان محاصرًا في الفالوجا في حرب فلسطين، واتفق معهم اتفاقيات سرية، إذا وصل إلى الحكم!!
وأنا بصفتي عالِمًا مسلمًا يحتكم إلى الشرع الذي يرى أن الأصل في الناس البراءة، وأن الإنسان لا يدان إلا ببينة، وأن الشك يفسر لصالح المتهم: أرفض هذه الاتهامات التي لا دليل عليها، وهذه الدعاوى العريضة التي تنقصها البينات، وقد جاء في الحديث: «لو أخذ الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». وقال الشاعر: والدعاوى - ما لم يقيموا عليها ** بيّنات - أبناؤها أدعياء!
والاتصال بالأمريكان قبل الثورة أو بعدها: لا يثبت العمالة لهم. فالعميل: من لا هدف له ولا رسالة يعمل من أجلها. ولكن هدفه ورسالته تتلخص في خدمة من يعمل لحسابه، وتحقيق أهدافه. ولقد أيد الإخوان عبد الناصر عند قيامه بالثورة وبعد قيامه بالثورة، وكانوا أول أعوانه، بل كانوا سنده الشعبي البارز، حتى دب الخلاف بين الطرفين، فلماذا لم يُتهم في ذلك الوقت بأنه عميل أمريكي؟
هل كان عبد الناصر ماركسيًّا؟
ومما يسأل عنه هنا: هل كان عبد الناصر ماركسيًّا؟
إن من المعروف أن عبد الناصر في فترة من تاريخه اصطدم بالماركسيين - الشيوعيين - وأدخلهم السجون، وإن لم يصبهم من التعذيب والتنكيل ما أصاب الإخوان. ولكنه بعد ذلك، اصطلح مع الشيوعيين، وأطلق سراحهم، ولم يكتف بالإفراج عنهم، بل مكّن لهم في أجهزة الإعلام والثقافة، فأصبحوا في وقت من الأوقات هم الذين يوجهون الفكر والثقافة في مصر. فهل كان هذا لتغير في سياسة عبد الناصر أو لتغير في فكره؟
المفهوم: أن هذا كان نتيجة لتغير في سياسة عبد الناصر؛ نظرًا لارتباطه بالمعسكر الشرقي، وتحالفه مع الاتحاد السوفيتي في أكثر من مجال: في مجال التسليح، وفي بناء السد العالي، وفي مجال الخبراء العسكريين والفنيين، وغير ذلك.
وقد ظل الروس يعملون في مصر، ويؤثرون في سياستها، حتى جاء السادات، وقرر قراره الحاسم بإخراجهم منها!! وقد لام «خروشوف» عند افتتاحه مبنى السد العالي: عبد الناصر، أنه يدعو إلى الاشتراكية، ولكنه لا يمكن الاشتراكيين من إقامتها، ولا اشتراكية من غير اشتراكيين.
وكان لهذه الإشارة مغزاها وأثرها، فسرعان ما تغير الموقف من الاشتراكيين، وفسح المجال لهم، ليثبوا على مراكز الدولة، ولا سيما بعد ما تولى «علي صبري» رئاسة الوزارة، وأعلنوا التمهيد لمرحلة «التحول العظيم» يعنون: التحول إلى «الاشتراكية العلمية».
ومن قرأ «الميثاق» الذي يمثل فكر عبد الناصر: وجد فيه رشحات من الفكر الماركسي في مواضع شتى، ولكن لا نستطيع أن نصف «الميثاق» بأنه ماركسيّ تمامًا.
نجد أثر الماركسية في تقليص الجانب الإيماني والفكرة الغيبية والقيم الروحية، فلا تكاد تحسها وتشعر بها. كما لا نجد أثرًا لشريعة الإسلام الذي يدين به عبد الناصر، ويدين به شعب مصر. بل قال وهو يتحدث عن الأسرة: لا بد أن نسقط بقايا الأغلال التي تكبل الأسرة. والسياق يبين أنه يشير إلى التشريعات الإسلامية في الزواج والطلاق وغيرهما.
هل كان عبد الناصر متدينًا؟
ونسأل، ويسأل معنا كثيرون: هل كان عبد الناصر متدينًا؟
سأل الأديب يوسف القعيد، الأستاذ محمد حسنين هيكل: هل كان عبد الناصر متدينًا؟ فأجاب هيكل: كان عبد الناصر متدينًا. ولكنه لم يدلل على تدينه بشيء، واكتفى بتقرير هذا الأمر، وكفى.
ولعله يقصد: أنه لم يكن ملحدًا جاحدًا للغيبيات من الألوهية والوحي والإيمان بالآخرة. ولا يقصد أنه كان متمسكًا بشعائر الدين وفرائضه الحتمية، وأنه يخشى الله في أموره، ويضع الآخرة نصب عينيه، ويزن كل شيء بميزان الحلال والحرام عند الله، كما هو شأن المتدينين.
والحق: أن عبد الناصر لم يُعرف بشرب الخمر، كما لم تعرف عنه علاقات نسائية محرمة، ولكنه لم يشتهر عنه إقامة الصلوات، التي فرضها الله على المسلمين خمس مرات في اليوم والليلة. لم يقل أحد ممن كتبوا عنه: إنه دخل عليه فوجده يقيم الصلاة، أو إنه دعا زواره يومًا ليقيم معهم الصلاة، أو إنه في مجلس من المجالس التي كان يعقدها توقف مرة ليصلي وحده، أو مع زملائه.
ولم يحك مؤرخ عبد الناصر الملازم له - أعني الأستاذ هيكل - شيئًا من ذلك، على كثرة ما حكى من تفصيلات حياته، في الحضر والسفر، والخلوة والجلوة. حتى الجمعة لم يعرف أين كان يصليها عبد الناصر؟ ولقد حكم عبد الناصر ثمانية عشر عامًا، كل سنة فيها 52 جمعة، فأين كان يصلي هذه الجمع؟
لقد كان للملك فاروق - ولأبيه الملك فؤاد قبله - إمام خاص، تعينه وزارة الأوقاف، أو ترشحه ليعينه الديوان الملكي، ليصلي به في مسجده في قصره، في الجمع خاصة، وفي الصلوات الأخرى في بعض الأوقات. فمن إمام عبد الناصر؟ وهل له مسجد في منزله في منشية البكري؟ أو بجوار منزله؟!!
هناك جمع معروفة ومعلنة في مناسبات معينة، أو لزيارة بعض الضيوف، رآه الناس فيها مصليًا للجمع، ولكن ما عدا ذلك لم يُعرف أين صلى عبد الناصر نحو 900 جمعة أمر الله الناس إذا سمعوا النداء: أن يستجيبوا لداعي الله، ويسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع. كان الرئيس أنور السادات حريصًا على أداء الشعائر، فلهذا قالوا عنه: الرئيس المؤمن.
وظهر هذا في سياسة كل منهما، فالسادات حين خاض معركة العاشر من رمضان 1393هـ - 6 أكتوبر 1973م؛ تجلى فيها أثر التدين في الضباط والجنود، وفي الشعارات، فقد كان شعار المعركة: الله أكبر. في حين كانت كلمة السر في حرب يونيو 1967م «برّ بحر جوّ». وللأسف لم ينتصروا في بر ولا بحر ولا جو.
وعلى أي حال، لقد لقي عبد الناصر ربه، وأفضى إلى ما قدم، وسيجزيه الله بما يستحق، وهو الحكم العدل، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يضيع عنده حق مظلوم، ولا يروج عنده تلبيس ظالم. ولولا أمانة الكلمة، وما أخذه الله من ميثاق على العلماء: أن يبينوا الحق للناس ولا يكتموه؛ لوسعني السكوت، ولم أتكلم بكلمة واحدة.
وقد ذكرت: أنه في السنوات الأخيرة، دفعت الظروف التي تعيشها أمتنا وأوطاننا المعتدلين من الإسلاميين، والمعتدلين من القوميين، ومنهم الناصريون، إلى أن يلتقوا ويتفاهموا معًا، وينسوا جراحات الماضي، وما تحمله من مرارة وقسوة، ليجتمعوا على الأمر المشترك، وهو: الوقوف في وجه الغزوة الصهيونية والأمريكية، ومقاومة التطبيع، وتأييد الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية الباسلة، والحفاظ على هوية الأمة وذاتيتها وتميزها في أهدافها ورسالتها، وتجميع كل قوى الأمة في مواجهة هذا الطاغوت الجديد، فانعقد المؤتمر القومي الإسلامي في بيروت من الفريقين.
وكنت ممن شارك في لقاءاته، وفي اللجنة التحضيرية التي أعدت الورقة الإسلامية للمؤتمر الأول. وبهذا ينتصر الرشد على الانفعال، وكلمة الأمة العليا على الجماعات والأحزاب، فالأمة هي الأصل، وكل ما عداها فرع، وعفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. ورحم الله الأموات، ووفق الله الأحياء.
.....
(1) رواه النسائي (1935) عن عائشة، وذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (7271).
(2) رواه البخاري (1393) عن عائشة.
(3) رواه أبو داود في «الأدب» (5130) عن أبي الدرداء.
(4) انظر: «مذكرات البغدادي» (ص: 345).
(5) رواه الترمذي (1395)، والنسائي (3987) عن ابن عمر، وصححه الألباني في «غاية المرام» برقم (439).
(6) رواه البخاري (3318) عن ابن عمر، ومسلم (2619) عن أبي هريرة.
(7) «البحث عن الذات» (ص: 184).
(8) صحيفة الأهرام في (16/ 10/ 1975م).
(9) راجع ما كتبناه في هذه المذكرات في أحداث سنة 1967م عن هذه النكبة، تحت عنوان: «تحليل لأسباب النكسة».



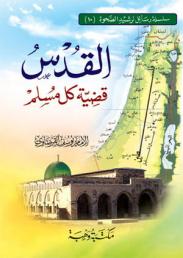 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






