
أمتنا بين قرنين
مقدمة
منذ عشرين سنة كان لنا وقفة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، اعتبرتها في حينها وقفة «الحساب الختامي» للقرن بما لنا وما علينا، وهي وقفة طبيعية على رأس قرن، هو قرننا نحن أمة الإسلام، إذ هو يؤرخ لرسالتنا ومسيرتنا وحضارتنا، منذ أسس رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أول مجتمع وأول مسلم وأول دولة إسلامية بالمدينة.
واليوم نقف وقفة أخرى في مطلع القرن الحادي والعشرين الميلادي، وهو يتميز بأنه بداية الألف الثالث لميلاد المسيح عليه السلام .
المسلمون والقرن الميلادي:
وهذا القرن - وإن لم يكن في الأصل قرن المسلمين - لا يسعنا نحن المسلمين أن نتجاهله، والعالم كله من حولنا يهتم به ويتحدث عنه، ونحن جزء من هذا العالم، الذي تقارب وتقارب حتى أصبح اليوم - كما قيل - قرية كبرى، بل قلت: إنه أصبح اليوم قرية صغرى بعد ثورة الاتصالات، فإن القرية الكبرى قد لا يعلم الناس في شرقها ما يحدث في غربها إلا بعد يوم أو أكثر، على حين نحن نعلم اليوم ما يحدث في العالم بعد لحظات، وقد نتابع الحدث في أثناء حدوثه لحظة بلحظة.
على أننا نحن المسلمين لا نقف موقفا متشنجا من ميلاد المسيح عليه السلام ؛ فقرآننا الكريم قد احتفى بهذا الميلاد، وأفرد له جزءا بارزا من سورة سميت باسم أم المسيح «مريم» عليه السلام ب، وذلك لما صحب هذا الميلاد من خوارق لم تكن لغيره، حتى إن القرآن ذكر معجزة لعيسى عليه السلام ، لم تذكرها الأناجيل ولا المصادر المسيحية، وهي: كلامه في المهد صبيا، ولكن الإسلام يحرص في تربية أمته وتوجيهها على أن تكون متميزة بشخصيتها المستقلة المتفردة، جوهرا ومظهرا... تتسامح مع الآخرين، ولكن لا تذوب فيهم.
والإسلام يؤمن بالمسيح عليه السلام ، وبأن ميلاده كان آية من آيات الله، ولكنه لا يتخذه عيدا، فإن لكل أمة أعيادها، التي ترتبط بهويتها وتاريخها، وللمسلمين عيداهم: عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس عيد الميلاد، كما أن المسيحيين للأسف يرتكبون باسم المسيح في ميلاده ما لا يقبله هو ولا أمه عليها السلام، وما يبرأ منه رسل الله جميعًا.
على كل حال، فنحن نتحدث عن القرن الجديد باعتباره حدثا عالميا مهما، فلا حرج علينا أن نهتم به، كما اهتم المسلمون في العهد المكي بالحرب الدائرة بين فارس والروم، وحزنهم لهزيمة الروم، وهم نصارى أهل كتاب، أمام الفرس، وهم مجوس يعبدون النار، ونزول قرآن يتلى في ذلك، وهو أوائل سورة الروم {الٓمٓ * غُلِبَتِ ٱلرُّومُ * فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ * فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ * بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ} (الروم: 1 – 5) .
ولعل حديثنا عن هذا القرن الجديد، أو عن «الألفية الثالثة» كما عبروا عنها، يقرب ما بين أتباع المسيح وأتباع محمد عليهما والسلام، ويطفئ تلك النار التي أججتها الحروب الصليبية ولم تزل مشتعلة في نفوس كثير من الغربيين إلى اليوم، حتى وجدنا المسيحيين تقاربوا مع اليهود، وأصدروا وثيقة تبرئهم من دم المسيح، وهم لا يعترفون بالمسيح ولا بإنجيله ولا بأمه، والمسلمون لا يصح إسلامهم، ولا ينعقد إيمانهم ما لم يؤمنوا بالمسيح وبكتابه، ومع هذا لم يقترب المسيحيون منهم إلى هذا المدى، بل رأينا الأمريكان - وهم مسيحيون - يرشحون الإسلام عدوا جديدا، يمثل الخطر المستقبلي الذي يهددهم، بعد زوال خطر الاتحاد السوفييتي.
متى يبدأ القرن الجديد؟
أكتب هذه السطور، ولم يبق إلا شهر واحد، أو أقل على مقدم سنة 2000 للميلاد، بداية القرن الحادي والعشرين، أو الألفية الثالثة، كما هو مشهور ومتعالم عند كثير من الناس، وكما تعلن عنه وتهلل له أجهزة الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية.
بيد أن الذي أو من به، ويؤمن به كثيرون غيري: أن سنة 2000م هي نهاية القرن العشرين، وأن بداية القرن الحادي والعشرين هي سنة 2001م، وهذه بدهية ما كان ينبغي الخلاف فيها؛ فإن الإنسان إذا بدأ قرنا «أي 100 سنة» فإن هذا القرن لا ينتهي بسنة 99 منه، بل بنهاية سنة 100 منه، ولا أحسب أحدا ينازع في هذا، ومثل ذلك القرن التالي، لو بدأنا سنة 101 لوجب علينا أن ننهي القرن سنة 200 لا لسنة 199.
وهذه قضية قد حدث الخلاف في شأنها عندما استقبلنا - نحن المسلمين - القرن الخامس عشر الهجري، وكان بعض الناس قد حسبوا أن القرن يبدأ سنة 1400هـ ثم انتهى الرأي إلى أنه يبدأ بيقين سنة 1401هـ، وقد كانت بداية الاحتفالات بهذا القرن هو إقامة المؤتمر العالمي للسنة والسيرة النبوية بدولة قطر.
ربما كان تغيير التاريخ من 1900 إلى 2000، وعقدة الكمبيوتر في ذلك، ومحاولة التغلب عليها، لها تأثيرها العقلي والنفسي في النظر إلى أن الألفية سنة 2000 هي الفاصل، وليست 2001 .
على كل حال، سواء كان مطلع القرن سنة 2000 أو 2001 فالحديث عنه وعن الألفية الثالثة مقبول في هذا الوقت، بل قد بدأ الحديث من قبل ذلك بسنوات، وأريد أن أنبه هنا على مسألة مهمة تتصل بمقدم هذا القرن، أو هذه الألفية وما يتوقعه الناس من تغير أو تطور إلى الأمام أو إلى الخلف بهذه المناسبة الفاصلة.
هذه المسألة هي: هل الحياة ستتغير في 1/1/2000م عن الحياة في 31/12/1999م أو في 1/1/2001 عن الحياة في 31/12/2000م؟ أعني هل يبيت الناس بشكل، ويصبحون بشكل آخر؟ أو هل يتغير تفكيرهم وسلوكهم ما بين عشية وضحاها، ولمجرد انتهاء قرن وحلول قرن آخر؟
لا شك أن الناس في يناير هم الناس في ديسمبر، والحياة في أوائل القرن الجديد هي الحياة في أواخر القرن المنصرم، والكون والحياة والإنسان لا تتغير فجأة، لأن قرنا قد تولى، وآخر قد بدأ، فإن كل شيء يمضي في طريقه وفق قوانين الكون، وسنن الخلق {فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِيلًا} (فاطر: 43) .
ولكن جرت أعراف الناس، وتعلقت أمانيهم من قديم: أن تحدث تغيرات وتطورات، عقب كل قرن يذهب وآخر يجيء ولا شك أن هناك تغيرات تقع قبل انتهاء القرن، أو بعد بدء الآخر، فالحياة لا تزال تتجدد، والدين نفسه لا يزال يتجدد، كلما جد قرن، وفي هذا جاء الحديث النبوي: «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها»، والمراد بتجديد الدين هنا: تجديد الفهم له، والإيمان به، وإحياء الالتزام به والدعوة إليه، وهذا يشير إلى أن التغيير والتجديد أمر يترقب كلما مضى قرن وأهل آخر، وإن جاء ذلك أصلا في القرن الهجري، ولكن قد يستفاد من المبدأ نفسه هنا.
دورنا في الألفية الثانية:
وقد أثار بعض الباحثين المسلمين سؤالا عن دور المسلمين في «الألفية الثانية» المنصرمة، وماذا كان لهم فيها من خلاق.
والواقع أن النصف الأول للألفية الثانية، كان المسلمون فيه هم سادة العالم، وحضارتهم هي المعلمة للدنيا، في حين كانت أوربا ترى النظافة من عمل الشيطان، وترى التطبب على أيدي الكهنة، وكان رجال الدين فيها عقبة في سبيل تقدم الدنيا، وهم مشغولون بإصدار قرارات الحرمان، وبيع صكوك الغفران، كانت تلك القرون التي تسمى عندهم «القرون الوسطى» تمثل عصور التأخر والظلام.
عرف العالم أسماء كبيرة لعلماء وفلاسفة وأدباء وموجهين وحكام ومسلمين، حازوا شهرة عالمية، وتركوا «بصماتهم» في الحياة الفكرية والأدبية والدينية والسياسية، أمثال البيروني والخوارزمي وابن الهيثم وأبي بكر الرازي والزهراوي في العلم، وأمثال ابن سينا وابن رشد وابن طفيل في الفلسفة، وأمثال الغزالي وابن تيمية في الدين، وأمثال المتنبي، وأبي العلاء وأبي حيان وجلال الدين الرومي في الأدب والشعر، وأمثال نور الدين محمود الشهيد وصلاح الدين الأيوبي في السياسة والحكم، وغير هؤلاء كثير، وأكثر منهم من لم يبلغوا مكانتهم وشهرتهم من النوابغ والعباقرة في العلوم والآداب والفنون، وهم يعدون بالألوف وعشرات الألوف، هكذا كنا في النصف الأول من الألف الثانية للميلاد.
على حين غدا النصف الثاني للألفية الثانية يتحرك لحساب الغرب ونهضته وتطوره، وانتقاله من الظلام إلى النور، ومن الجمود إلى الحركة، ومن النوم إلى اليقظة، ومن الجمود إلى التحرر، ومن الرجعية إلى التقدم، ولا ينكر منصف أن الغرب إنما تحرك وتطور عندما احتك بالمسلمين في الحرب والسلم، في الحروب الصليبية وفي الأندلس، وفي صقلية وغيرها من قنوات الاتصال، واستفاد الغرب من جامعات المسلمين، وعلماء المسلمين، وكتب المسلمين، واقتبس المنهج التجريبي الاستقرائي من حضارة المسلمين، وطفق الغرب ينهض ونحن نتعثر، ويصحو من نومه، ونحن نغط في سبات عميق، وينظر إلى الأمام، ونحن مشدودون إلى الخلف.
هل لنا أمل في الألفية الثالثة؟
ترى ماذا يكون دور المسلمين في الألفية الثالثة الجديدة، أو على الأقل في القرن الجديد؟ أيكون لهم مكان تحت الشمس أم يظلون في ذيل القافلة كما هو اليوم؟ يستهلكون ولا ينتجون، ويستوردون ولا يبدعون، ويستقبلون ولا يرسلون، ويقلدون ولا يجددون!!
أنا لست من المتشائمين، وقد علمنا التاريخ أن الحضارة دورات، وأن الدهر قلب، ودوام الحال من المحال، وهذه هي سنة «التداول» الكونية الثابتة، التي قررها القرآن الكريم حين قال: {إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ} (آل عمران: 140) .
وقد كانت شعلة الحضارة في القديم لدى الشرق، أيام الحضارات الفرعونية والفينيقية والبابلية والفارسية، ثم انتقلت الشعلة إلى الغرب أيام حضارة اليونان والرومان، ثم عادت إلى الشرق أيام الحضارة العربية الإسلامية... فلما ركد المسلمون وتخلفوا حين أساءوا فهم دينهم وتطبيقه... هرولت الحضارة إلى الغرب، الذي يقود العالم اليوم، بل كاد الغرب يتجسد الآن في أمريكا، القطب الأعظم، بل القطب الأوحد في العالم، وهي تريد أن تفرض سيادتها الثقافية والاقتصادية والسياسية على العالم تحت اسم «العولمة» وما هي إلا «الأمركة».
وسنة الله تعالى، ومنطق التاريخ، أن الدورة الحضارية القادمة لنا نحن المسلمين، حسبما يقتضيه «صراع الحضارات» الذي تحدث عنه الكاتب الأمريكي «صمويل هنتنجتون» وفق قانون «البقاء للأصلح» وليس للأقوى، فإن «البقاء للأقوى» هو قانون الغابة، أما البقاء للأصلح، فهو قانون الإنسان.
وقد كان الاتحاد السوفيتي قوة ضخمة، ويملك ترسانة هائلة من الأسلحة النووية والتدميرية، وجيوشا جرارة مدربة مستعدة، ومع هذا لم تغن عنه هذه القوة العسكرية شيئا، وانهار هذا البناء الكبير؛ لأنه أسس على شفا جرف هار، فانهار بأصحابه، والله لا يهدي القوم الظالمين.
إن بقاء الأمم الكبيرة لا يدوم بقوة السلاح وحدها، فلا بد من قوة معنوية وراء القوة المادية، والقوة المعنوية لا تعني الدين وحده، كما يتصور الكثيرون، الدين والإيمان في المقدمة، ولكن القوة المعنوية تشمل الأخلاق والفكر والمعروفة والمعاني الإنسانية، وهذه كلها ضرورية للبقاء والتفوق، مع ضرورة القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية.
وإن لدينا - نحن المسلمين - من المبشرات الدينية والدنيوية ما يملؤنا ثقة بالمستقبل، ويقينا بغد أفضل، ولا يعني ذلك أن ننام على آذاننا، ونتكل على هذه البشائر، بل يجب أن نحفزنا هذه المبشرات إلى العمل، والعمل الدءوب، المبني على العلم والتخطيط، حتى نحول الأحلام إلى حقائق، والأمل إلى واقع مشهود، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فإذا كان العالم من حولنا، قد أطالوا الحديث عن الألفية الجديدة، فلا علينا أن نتجاوب معهم، وخصوصا المسيحيين الذين يحكمون عالمنا اليوم، سواء بالقوة العسكرية أو بالقوة الاقتصادية، أو بالقوة العملية والمعرفية.
ولنقف بهذه المناسبة وقفة مراجعة ومحاسبة مع أنفسنا، لا لنجلد ذاتنا، ونتحسر على ما ضيعنا، ونردد «لو» و«ليت» ترديد اليائسين المحزونين، ولننشد مع شاعرنا القديم: وليس براجع ما فات مني بـ «لهف» ولا بـ «ليت» ولا «لو اني»! ، والحديث الشريف يعلمنا أن «لو» تفتح عمل الشيطان.
إنما علينا - بعد أن نعرف إنجازات البشرية وإخفاقاتها في هذا القرن، وقد خصصنا لها الباب الأول هنا - أن نقف وقفة التاجر الواعي ليعرف أرباحه من خسائره، ليستكثر من الأرباح، ويتفادى الخسائر، وكذلك يجب أن نقف أمام نجاحاتنا وإخفاقاتنا «وقد خصصنا لها البابين الثاني والثالث من هذه الدراسة» لنستزيد من أسباب النجاح ونعمقها ونحس توظيفها، وندرس أسباب الإخفاق، ونجتهد في التغلب عليها وتفاديها في المستقبل، والقرآن يعلمنا فيقول: {وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةٗ لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورٗا} )الفرقان:62) أي إن تعاقب الليل والنهار يعطي فرصة للاستدراك لمن أراد.
ثم علينا أن نواجه التحديات، الداخلية والخارجية، المحلية والعالمية «وقد خصصنا لها الباب الرابع والأخير» ببصيرة نافذة، ووعي عميق، وإيمان صادق، وعزم مصمم، وجهد دؤوب، ولا سيما التحديات الكبرى؛ التحدي الصهيوني، وتحدي التجزئة والتفكيك، وتحدي العولمة، وإذا توافر العلم والعزم والإيمان والعمل فإن الله لا يضيع جهد العاملين، ولا أجر المصلحين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الدوحة - رمضان 1420هـ
ديسمبر 1999م
الفقير إليه تعالى
يوسف القرضاوي


 الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟ 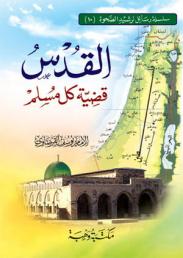 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم 






