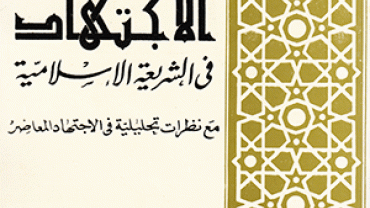ساري عرابي
الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، لمّا أراد أن يجمع حياته في كتاب، اختار لها البدايات الصغيرة، القرية والكتاب، عنواناً. كان يمكن لمن عرف الشيخ وقد صار ملء السمع والبصر، أن يكتفي بهذا العنوان، دليلاً على هذه النفس الفريدة في هذا العالم، وفي الأوساط التي نشأ بينها وتميّز فيها، وأطلّ منها على العالم، الأوساط المشيخية، والحركية الإسلامية.
قد تحسبُ، أوّل أمرك، حينما تتصفح عنوان مذكرات الشيخ، أن الاختيار كان محض حاسّة أدبيّة ذكيّة من الشيخ الشاعر، لكنك، حينما تعود إلى مراجعاته المطوّلة في قناة "الحوار"، تقف إلى رجل مُصفّى بالشفافية. وبالرغم من أن ما كتبه عبارة عن رقّته التي بها شبّ وعاش ومات، إلا أن الرجل جمع حسنيي الفقيه الأديب الداعية، فما يغني قلمه عن لسانه، ولا لسانه عن قلمه، فلمّا استعاد بلسانه حياتَه، كان يمكنك أن ترى الصدق في عينيه النازعتين بالدمع والحنين الكامل إلى البدايات الصغيرة، القرية والكتاب.
لا ينزع الفقيه إلى بداياته الصغيرة، إلا وهو يضنّ بقلبه الأوّل على هذا العالم. قلب غَمَرَ العالم ولم ينغمر فيه، حجب العالمَ عنه، وهو يصبّ عطاءه وخيره في العالم، فإن لم تكن هذه حقيقة العارف، فلا حقيقة لعارف إذن. هذا والشيخ، الذي أسهم ببعض كتاباته في التزكية والتربية الروحية، لم تُعرف عنه الدعاوى الصوفية العريضة، بل قد عُرف عنه نقدها، في وسط من الأدب والشجاعة، لكنّ سخاء نفسه كان متاحاً، إلا لمن أبى وأعمته نوازع الخلود إلى الأرض.
القلب الأوّل، قلب الطفل، في القرية والكتاب.. كان يمكنك من خلف العقل الكبير، والعينين الذكيتين أن تغور إليه، فلا الفقه، ولا الانتماء لبعض جماعات المسلمين والاشتغال فيها والانحياز لها، ولا الشهرة، ولا الطيران في سماوات بلاد العالم وبينها، ولا تصدّر المؤتمرات، والانتشار في الشاشات، وشيوع الذكر والمؤلفات، لا شيء من ذلك، كان يمكنه أن يخفيَ هذا القلب، بل إنّ ذلك كلّه، كان يحمل هذا القلب إلى العالم، في مركب الشجاعة والأدب، والجرأة والإنصاف.
من هذا الذي جمع الشجاعة إلى الأدب، والجرأة إلى الإنصاف، فبثّ آراءه، وخالف بعض السائد والمألوف، لا عن رغبة في الامتياز، وإنما عن صدق توجّه لا يخفى بأدنى بصر صادق؟ فكيف إذا كان الشيخ في أدبه وإنصافه، لا يغفل عن السهام المغمّسة بسمّ الخسّة وفجور الخصومة، تأتيه من أقطاره كلّها، فلا يلتفت إليها، ولا يردّ بمثلها على مطلقها، وإنما يناقش ما يستحقّ النقاش، ويدلّ على الفضل الذي في مخالفيه، والذي قد تمتنع القدرة عن إدراكه لحجب العصبية والتحزّب.
وليس بالسهل على الرجل المشتهر في الناس، وقد ملك من الجاه ما ملك، ومن المواهب ما عُرِف، ومن الإسهام ما يصعب على الحصر، أن يلاحظ الناس بكلّيّتهم، فلا يتوقف كثيراً عند قصورهم، وإنما يكثّف إشارته إلى إحسانهم، بيد أنّ الأمر كان أسهل على الشيخ من رقرقة القطرة على فم القربة، فالأمر دفق تلك البراءة الطفولية، العابرة من سعة العقل.
ولا ينحصر ذلك في نقده للجماعة التي نشأ فيها، ولبعض رموزها، ومسارات عملها، دون أن يفترق عنها عاطفيّاً، أو يرى نفسه متفوّقاً عليها بما اختلف معها فيه. وهذه الأطروحة الأخلاقية، التي تجمع بين الشجاعة في الموقف وبين حفظ الفضل، عزيزة في المتصدّرين من الناس، فكيف وقد كان هذا حاله مع مخالفيه، ومبادئيه بالخصومة، وشانئيه، ومنكري فضله، والساعين بذمّه على مدار ثواني أعمارهم؟!
ولن يكون هذا حال رجل زكيّ النفس فحسب، وإنما كان رجلاً يعيش لقضية، هي أمّته، فانشغل من كل جانب لها، فكان همّ فقهه أمّته، وهمّ دعوته أمّته، وهمّ حركته وعمله ونشاطه وظهوره أمّته. فترشيده للصحوة، وتفكيكه للغلوّ والتطرف، وسعيه بالوحدة بين المسلمين، ونهجه الفقهي الساعي لتطبيب ضمائر المسلمين المكلومة في هذا العالم المعلمن، وبذله المضني لأجل فلسطين، وانحيازه للمستضعفين.. كان ذلك لأجل أمته، فكيف يمكنه بعد ذلك، أن يلتفت للسفه الذي لا يمكنه أن يدرك هذا الهمّ المسكون بالأمّة؟!
ولعلّه مما أريد له من الرِفعة، ألا ترى النفوس المرتكسة في صغائرها؛ منه إلا بعض لحظات هي من مئة عام دعوة وعملاً، فيختصره البعض في تصريح غير موفق في سياق الثورات العربية، أو محاولة هي بخلاف الأولى في العمل السياسي، ولكن كيف للأشياء أن تمتاز، إنْ لم يتسلّط الصغار على الكبار، والنفوس الملوّثة بضغائن العالم على القلوب التي لم تفارق القرية والكتاب؟! بل بلغ الجهل والسفه والفجور ببعضهم إنكار دوره لفلسطين، وهو الذي قال الشعر فيها منذ أوّل نكبتها، وألّف الكتب لها، وأفتى لمجاهديها، وأنشأ المؤسسات والجمعيات والمؤتمرات والمشاريع لتصبّ فيها، وتمسّك بأصولها وثوابتها أحسن من بعض أهلها!
وهل يمكن لرجل عاش هذا العمر، وقدّم هذا العطاء، ألا تختلف معه؟ أو ألا يندّ عنه خطأ، صغير أو كبير؟! ولكنّ الشأن شأن القلب والنفس والخلق، ومن ثمّ بعد ذلك، تبقى ميادين الفكر والفقه والسياسة مجالات للاختلاف والأخذ والردّ، ولكن من يحسن التزام هذا المسلك بلا التفات كالشيخ رحمه الله؟!
ولا يمكن لشابّ مثلي نشأ في بيئة يملؤها الشيخ، ويملأ ما فوقها وما حولها، ألا يقول إنه لم يتأثّر به، ولم يقرأ له، ولم يستمع إليه، هذا ضرب من النكران والتجنّي والادعاء وتجاوز القدر وتعدّي الحدّ. ولا يصحّ والحالة هذه أن نفسح الرثاء، لبيان مواضع الاختلاف مع الشيخ، وهو فسحة لاستعادة فضله وأدبه، إلا أنّ هذا الشابّ شافعيّ المذهب، الذي لا يقلّد الشيخ في منهجه الفقهي أو اختياراته الفقهية، لا يسعه إلا أن يقول إن هذا الرجل كان شيخه من كلّ وجه، وأنّه أحوج ما يكون إلى قلب هذا الرجل العظيم ونفسه الزكيّة وأدبه النوراني.
.....
- المصدر: عربي21، 27-9-2022



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين