في سنة 1980م دعيت إلى زيارة الهند من جهتين: الأولى: من العلامة الشيخ أبي الحسن على الحسني الندوي رئيس ندوة العلماء بالهند لزيارة «دار العلوم» التابعة للندوة، وما يتبعها من كليات ومعاهد، وإلقاء عدد من المحاضرات العامة على الأساتذة والطلبة جميعًا. وقد أرسل بذلك رسالة إلى أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حفظه الله، فوافق عليها مشكورًا.
والثانية: من جامعة الهند العريقة، أزهر الهند: جامعة «ديوباند» الشهيرة التي خرَّجت ألوف العلماء في شبه القارة الهندية: الهند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان وغيرها من بلاد الأقليات الإسلامية حولها. وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوي للجامعة، وقد دعوا لهذه المناسبة كبار علماء الدين من أنحاء العالم العربي والإسلامي. وجاءت رسالة الجامعة إلى الشيخ خليفة أيضًا، فلم يتردد في الموافقة عليها.
ولكني أحرص دائمًا على أن أجمع رحلاتي المتعددة ما أمكن، وأختصرها في سفرة واحدة، وهو ما فعلته هنا، فقد اتفقت مع أحبتي في ندوة العلماء: أن أربط زيارتهم باحتفال جامعة «ديوباند»، إما قبلها وإما بعدها، فرأوا الأنسب أن تكون قبلها.
تأشيرة زيارة الهند
فتأهبت للسفر إلى نيودلهي، ومنها آخذ الطائرة إلى لكهنو، ولكني في مطار نيودلهي فوجئت بشيء لم يكن في حسباني، وهو: أني لم آخذ تأشيرة لزيارة الهند.. ففي زحمة المشاغل والأعباء المتراكمة نسيت هذا الأمر البديهي؛ لأن جوازي القطري أدخل به إلى بلاد كثيرة في العالم العربي دون الحاجة إلى تأشيرة، بل أظن أن بريطانيا في ذلك الوقت لم تكن تحتاج إلى تأشيرة، كنت أدخل لندن بدون شيء، كما يدخلون هم قطر بدون شيء، ولم يكن لدي أي سكرتارية تعني بهذه الأمور الإدارية وتكفيني إياها... فلما سألوني في المطار: أين الفيزا؟ أسقط في يدي، وتحيرت ماذا أقول؟ وماذا أفعل؟ ورأيت نفسي في كربة دعوت فيها بدعاء ذي النون عليه السلام في بطن الحوت: {لّا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (الأنبياء: 87).
كشف الله الغمة
وقد لاحظ الموظفون حيرتي وارتباكي، فرقّق الله قلوبهم لي، وأشفقوا علي، وكان جوازي جوازًا خاصًا، فنظر بعضهم إلى بعض، أن يمشّوا الأمر، ويمنحوني تأشيرة من المطار، وأشار بعضهم: أليس معي «مَنِي»؟ وكان معي بعض الدولارات، فأعطيتهم إياها.
وأعتقد أنه لا مانع شرعًا من مثل ذلك، للخروج من هذا المأزق، للضرورة أو للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. وقد قال الله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة: 173).
وقد تنفست الصعداء حين خرجت من دائرة الجوازات، وحمدت الله تعالى أن كشف هذه الغمة، وسهّل هذه المهمة، وأنا أهوى الدعاء بتيسير كل عسير، وأحب دعاء سيدنا موسى: {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي} (طه: 25، 26)، وعلى لساني دائمًا: رب يسر وأعن. فالحمد لله الذي يسر أمري، وسهّل طريقي. وكم حدث لي في مطارات شتى مآزق مثل هذه وأخرجني الله منها.
إلى لكهنو
وحين خرجت من مطار نيودلهي، وجدت أحد الإخوة النّدويين ينتظرني، ليصحبني بالطائرة إلى مدينة «لكهنو» عاصمة الولاية الشمالية، والتي هي مقر ندوة العلماء. وفي مطار لكنهو وجدت عددًا كبيرًا منهم ينتظرونني، وقد تجمعوا لاستقبالي، وعلى عادتهم معهم عقود الورد والأزهار، يطوقونني بها. وذهبت معهم إلى الفندق الذي أقيم فيه، قبل أن يصحبوني إلى مقر الندوة.
ندوة العلماء
وفي دار العلوم: التقيت علماءها الذين تميَّزوا على غيرهم بأنهم يجمعون بين العلم والعمل، وأن الجانب الرباني حي في نفوسهم، ورثوه من آباء الندوة ومؤسسيها الكبار: الشيخ شِبلي النعماني، والسيد سليمان الندوي، والسيد عبد الحي الحسني، وعلَّامة الهند اليوم السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي، فكلهم نجوم هادية، ومنارات إيمانية، يعلّمون العلم يملئون به الرءوس، ويعلّمون الإيمان يزكون به النفوس؛ ولذا نرى طلاب الندوة طرازًا فريدًا من المؤمنين الصادقين، الذين يتعلمون فَيَعْلَمون، ويَعْلَمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، إن شاء الله.
ظللت نحو عشرة أيام في رحاب ندوة العلماء ألقيت فيها عددًا من المحاضرات في مختلف مجالات العلوم الإسلامية: في التفسير والحديث والعقيدة وأصول الفقه والفقه، والدعوة والفكر الإسلامي، وفي التصوف الإسلامي. وخطبت الجمعة في مسجد الندوة، كما زرت بعض المؤسسات الإسلامية في المدينة، وحاضرت فيها، وفي بعض المدارس التابعة للندوة.
وأذكر أني ألقيت محاضرة عن الجانب الرباني في حياة المسلم، وقد حفلت المحاضرة بآيات القرآن وأحاديث الرسول، وآثار السلف، وأقوال الصوفية... وقد دهش الإخوة في الندوة لهذه المحاضرة وتأثروا بها غاية التأثر، وقالوا: إننا اكتشفنا فيك ما كنا نجهله، وقد كنا نحسبك مجرَّد رجل علم وفكر، وليس رجل قلب وروح، ولكن ما سمعناه ولمسناه لم يكن مجرَّد كلمات يقولها اللسان، بل كانت من القلب إلى القلب.
وكان الشيخ أبو الحسن غائبًا عن الهند، فلم أحظ بوجوده، وأستمد منه روح القوة، وقوة الروح، لم ألقه إلا في نيودلهي بعد أن أمضيت المدة المقررة لي في لكنهو.
وعندما ودَّعت الإخوة في الندوة، وسافرت إلى نيودلهي متجهًا إلى ديوباند، لقيت الشيخ فيها، وقد تعانقنا بحرارة، وقال: أخبرني الإخوان: أنك أسرت القلوب، وسحرت العقول! قلت: إنما أستمد القوة بعد الله منكم! وما أنا إلا كبائع التمر إلى هجر!

وكان الطلاب يحيطون بي ويسألونني أسئلة مختلفة، بعضها في الفقه وأصوله، وبعضها في القرآن وتفسيره، وبعضها في الحديث وعلومه، وبعضها حول العقيدة بين السلف والخلف، وبعضها حول الفلسفة الإسلامية، وبعضها حول التربية وأصولها، وبعضها في اللغة العربية «النحو والصرف»، وكانوا بحمد الله يجدون عندي الجواب، وهو ما جعل بعض أساتذة دار العلوم ينوّه بهذه الثقافة «الموسوعية» كما سماها. والحمد لله على ما أعطى وأجزل.
إلى الاحتفال بالعيد المئوي لديوباند
من نيودلهي، انتقلنا بالسيارة مع بعض العلماء المدعوين إلى «ديوباند» للاحتفال بالعيد المئوي لهذه الجامعة العريقة، التي تخرج فيها ألوف العلماء في شبه القارة الهندية، فمعظم علماء الهند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان وسريلانكا ونيبال، والأقليات المختلفة حول الهند الكبرى من خريجي هذه الجامعة.
كانت هذه الجامعة في الهند أشبه شيء بالأزهر في مصر: كانت على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية في العقيدة، وعلى مذهب أبي حنيفة في الفقه، ويشوبها نزعة صوفية سنية أقرب إلى الاعتدال، وأبعد عن الشركيات والمبتدعات التي عُرفت بها بعض الفصائل في الهند.
وسُمِّيت الجامعة باسم القرية التي نشأت فيها «ديوباند» على بعد 150 كيلو مترًا من نيودلهي. وكانت الجامعة قد أسست منذ (115) مائة وخمسة عشر عامًا، ووجد علماؤها الكبار: أن الجامعات تحتفل بمرور مائة سنة، للتعريف بإنجازاتها، وجذب الاهتمام إليها، فقرروا أن يحتفلوا بهذه المناسبة، وإن كان العيد المئوي قد مر منذ خمس عشرة سنة، فدعوا علماءها وخريجيها خلال السنوات الماضية، كما دعوا علماء من أنحاء العالم ليشاركوهم هذه المناسبة، كما دعوا أبناء الهند الذين استفادوا من علمائها: أن يشهدوا هذا التجمع الإسلامي العالمي الكبير.
ولقد شهدت بعيني هذا الزحف الكبير على ديوباند من نيودلهي: فهناك من يركبون الحافلات «الباصات»، ومن يركبون سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي»، ومن يركبون سيارات النقل يكدسون فيها تكديسًا، ومن يذهبون بالقطارات إلى أقرب مسافة من «ديوباند» ومن يركبون الدراجات، ومن يركبون أرجلهم، أعني: يمشون على أقدامهم هذه المسافة. الطرقات كلها مشغولة ومزحومة: بالمواصلات وبالناس من كل حدّب وصوب. ولكن كيف تسع هذه القرية الصغيرة للناس وهي وسط المزارع والحقول؟!
الواقع أن المسئولين في الجامعة أحسنوا اختيار الوقت، حيث كان وقت حصاد، والأرض خالية من الزرع، وقد استأذنوا الأهالي أصحاب الأراضي من حولهم: أن يستخدموا أرضهم في الاحتفال، فأذنوا لهم، فنصبوا خيمة كبرى تسع نصف مليون أو أكثر، وخيامًا من حولها... وجاء كثيرون بخيام معهم فنصبوها في المنطقة، وظل كثيرون بغير خيام، وإنما يفترشون ما تيسر لهم وينامون عليه.
ورأيت بعيني رأسي أكبر تجمع بشري في حياتي بعد الحج: حوالي مليونين من البشر، فإن أكبر تجمع رأيته قبل ذلك: تجمع المصلين على جنازة الإمام المودودي في لاهور، في أكبر ناد رياضي (إستاد) بها. وكان حوالي مليون شخص. وهذا التجمع حوالي الضعف من ذاك. وقد تجمع فيه من العرب والعجم، والشرق والغرب، ومن إفريقية وأوروبا وأمريكا وأستراليا، ومن كل مكان في العالم.
وافتتحت هذا الحفل الكبير رئيسة وزراء الهند: أنديرا غاندي، بكلمة قوية، تحدثت فيها عن الإسلام والمسلمين بما يناسب المقام. وتحدّث رئيس الجامعة سماحة العلامة الشيخ الطيب القاسمي رحمة الله عليه. كما تحدث الداعية الكبير الشيخ أبو الحسن النَّدْوِي. وتحدث كثيرون عن بلدانهم وأقطارهم.
وتحدثت كذلك بكلمة ذكرت فيها المسلمين في الهند بواجبهم نحو إسلامهم، ونحو جماعتهم. وأذكر مما قلت في هذه الكلمة التي ارتجلتها:إن المسلمين في الهند أقلية بالنسبة للأكثرية الهندوسية، ولكن هذه الأقلية تمثل التجمع الثاني للمسلمين في العالم. بعد انقسام باكستان إلى دولتين: أصبح المسلمون في الهند التجمع الثاني للمسلمين بعد إندونيسيا.
ولكن هذه الأقلية الكبيرة للأسف الشديد غير متلاحمة ولا متماسكة، على عكس الأقليات في أنحاء العالم. كل الأقليات تتضام وتتلاحم وتتساند فيما بين بعضها وبعض، إلا الأقليات المسلمة كما نرى في الهند.
لماذا يجافي بعضنا بعضًا؟ بل لماذا يعادي بعضنا بعضًا؟
كن ديوبنديًا، أو كن ندويًا، أو كن إصلاحيًا، أو كن من أهل الحديث، أو من الجماعة الإسلامية، أو من البريلويين، كن سلفيًا أو صوفيًا، كن مذهبيًا أو لا مذهبيًا. ألست مسلمًا؟ ألسنا نلتقي في المسجد على الصلاة؟ ألسنا نلتقي في الحج والعمرة عند الكعبة؟ ألسنا نصلي إلى قبلة واحدة؟ ألسنا نقرأ مصحفًا واحدًا؟ ألسنا نؤمن بنبي واحد؟ ألسنا نجتمع على الحد الأدنى مما يصير به المسلم مسلمًا؟ ألسنا نشهد جميعًا: أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؟!
فلماذا نتفرق شيعًا وأحزابًا وفرقًا؟ وكتاب ربنا ينادينا: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (آل عمران: 103)، {وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (الأنفال: 46).
وأحاديث نبينا تنادينا: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(1)، «لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض»(2)، «يد الله مع الجماعة»(3)، «المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضًا»(4).
قلت هذا أو ما يشبهه، وأنصت الجميع لكلمتي، وقال كثيرون: صدقت ونصحت، ما أضاعنا وأضعفنا إلا التخاذل والتفرق.
د. علي السالوس في قطر
في سنة 1980م - 1981م الدراسية، وصل الأخ الكريم، والصديق العزيز الدكتور علي السالوس، إلى قطر متعاقدًا مع الجامعة، ليعمل مدرسًا في كلية الشريعة. ولم أكن أعرفه من قبل.
ومع هذا أوصيت اللجنة المسئولة في الجامعة بالتعاقد معه، بعد أن رشَّحه لي اثنان أثق بهما، وأعتز بشهادتهما: أولهما: الأخ الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله، الذي كان زميلًا له في كلية دار العلوم، وقال: عرفناه مجتهدًا وجيد التحصيل، حريصًا على طلب العلم، على رغم أنه لم يكن أزهريًا في الأصل مثل عبد العظيم ونظرائه من حملة الثانوية الأزهرية، الذين حفظوا القرآن، وتكوّنوا في معاهد الأزهر الابتدائية والثانوية، ثم دخلوا دار العلوم، وهي تنتقي المتميِّزين منهم.
ولكن السالوس كان من حَمَلَة الثانوية العامة، الذين لم يدرسوا ما درس الأزهريون، من القرآن وعلوم النحو والصرف والبلاغة والفقه والتفسير والحديث والمنطق والتوحيد وغيرها... ولكن «دار العلوم» كانت تنتقي من هؤلاء من تراه أصلح لدراسة علومها العربية والإسلامية. وكان السالوس من هؤلاء الذين تميَّزوا بجدهم وحرصهم ومثابرتهم، حسبما زكاه زميله الديب.
وثانيهما: الأخ العزيز، والمربي الكبير الدكتور يوسف عبد المعطي، الذي كان مديرًا لمعهد المعلمين في الكويت، الذي يعمل السالوس مدرسًا فيه. فقد ذكر لي: أنه لمس فيه عقلية فقهية واعدة، وخصوصًا في فقه المعاملات، فلديه استعداد طيب في هذه الناحية، كما أنه من الناحية السلوكية رجل ملتزم بدينه غير مفرط فيه، بل ربما كان أميل إلى التشدد.
فهذه شهادة من رئيس لمرءوسه، والأولى شهادة من زميل لزميله، وكلتاهما مؤسسة على معرفة وخبرة ومعايشة، ومن أناس لا يتهمون، فهي جديرة بأن تحوز القبول.

ووصل الشيخ علي إلى الدوحة واستقبلته بحفاوة وتكريم، ونظرًا لأن تخصصه في الفقه، فقد طلبت منه أن يركز على «فقه المعاملات المعاصرة». وهذا ما نصّت عليه مناهج كلية الشريعة.
فقد كان عيب الفقه الذي درسناه في معاهد الأزهر تسع سنوات، وما درسه إخوان لنا - زيادة على ذلك - في كلية الشريعة أربع سنوات، لا علاقة له بالواقع الذي يعيشه الناس، فهو يدرس «البيوع» ولكن لا يعرف أحكام البيوع المعاصرة، ويدرس أنواع الشركات القديمة وأحكامها: من شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة الوجوه... إلخ. ولكنه لا يعرف شيئًا عن الشركات المعاصرة وأنواعها وأحكامها... لا يعرف شيئًا عن الشركات المساهمة، وشركات التأمين، ولا عن البنوك وأعمال البنوك. ونحن نريد أن نربط طالب «كلية الشريعة» بما يدور في الحياة من حوله، بحيث يفهمه، ويعرف حكمه، ويفتي فيه إذا سئل.
وقد لاحظت أن الأخ الدكتور علي قد صار له نحو سبع سنوات، منذ حصل على الدكتوراه، وهو في درجة مدرس، ولا سيما أنه لم يأت إلينا من جامعة. وكنت حريصًا على أن يرتقي إلى درجة أستاذ مساعد، ولكن المشكلة أنه لم يكن لديه من البحوث ما يسنده في ذلك، فقد كان في أول الطريق، ومع هذا اتفقت معه على أن يقدم مقالة أو مقالتين له كتبهما في مجلة «الوعي الإسلامي» ردًا على فضيلة الداعية المعروف: الشيخ حسن أيوب رحمه الله، كما قد شارك بكتابة فصل عن الجانب الاقتصادي في الإسلام في كتاب كان مقررًا في مادة الثقافة الإسلامية بالجامعة... وقد تكونت لجنة التحكيم من الشيخ الغزالي، ومني، ومن ثالث نسيته، وحكمنا بترقية د. السالوس إلى درجة أستاذ مساعد.
وأصبح للدكتور السالوس مكانة ومكانة في قطر جامعيًّا وشعبيًّا، كما أن اشتهاره في فقه المعاملات جعل المصارف الإسلامية تحرص عليه في رقابتها الشرعية، ولا سيما في قطر، مثل مصرف قطر الإسلامي، والبنك الدولي الإسلامي.
والحق أنه كان له دور ملموس في تسديدها ووضع الضوابط لسيرها، ولا سيما في التدقيق الداخلي لها. كما غدا خبيرًا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ويُدعى إلى مؤتمرات البنوك الإسلامية، والندوات التي تتعلق بالاقتصاد الإسلامي.
كما أن للدكتور علي دورًا آخر، وهو دراسته لفقه الشيعة الإمامية وأصولها، وقد كانت رسالته في الماجستير حول هذا الموضوع، وقد توسع في ذلك فيما بعد، وأمسى خبيرًا يرجع إليه فيه، وألف في هذا المجال عدة كتب.
وقد اصطدم مع مفتي مصر «وشيخ الأزهر بعد ذلك» الدكتور محمد سيد طنطاوي في قضية فوائد البنوك وما يتعلق بها. وردَّ عليه في أكثر من كتاب، حتى إن الشيخ رفع عليه دعوى قضائية.
.....
(1) رواه البخاري في الخصومات (2410) عن ابن مسعود.
(2) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (121)، ومسلم في الإيمان (65) عن جرير بن عبد الله البجلي.
(3) رواه الطبراني في «الكبير» (12/447) عن ابن عمر.
(4) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (2446)، ومسلم في البر والصلة (2585) عن أبي موسى.



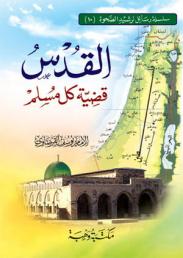 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






