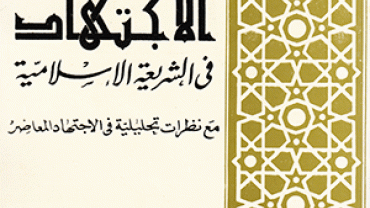د. وصفي عاشور أبو زيد
ظللت أقرأ كتب شيخنا وأبحث عنها وأقتنيها حتى جاء صيف عام 1999م؛ حيث كنت في بداية مرحلة الماجستير، وقررت أن أزوره مهما كانت الطريقة رغم أنه ليس معي أي طريقة تواصل، لا هاتف، ولا عنوان منزل، ولا أي شيء.
فاهتديت إلى الاتصال بدليل الهاتف في القاهرة لأسأل عن رقم هاتف ليوسف عبد الله القرضاوي، وبالفعل حصلت على رقم من الدليل، ثم اتصلت بالرقم فرد علي رجل وقال "النمرة غلط"، فقلت له: "طيب هل تعرف الدكتور يوسف القرضاوي؟" فقال "نعم"، فقلت "هل معك تليفونه"، فقال "نعم"، فأعطانيه وفرحت به، فقلت له: هل تعرف عنوان منزله، فقال نعم! وأعطاني إياه كذلك، ثم اتصلت بالرقم فإذا هو "مرفوع من الخدمة"، فقلت ليس هناك حل سوى الذهاب إلى بيته، وذهبت حسب العنوان الذي أخذته قبلا إلى بيت الشيخ في وقت الظهيرة في شهر أغسطس وهو قلب فصل الصيف، ثم دخلت بوابة البيت الواقع في حي مدينة نصر بالقاهرة، وسألت عن الشيخ، فقيل لي إنه نائم، ثم قابلت ساعيَ بريدٍ على باب البيت، ولمحتْ عيناي رقم هاتف على ظرف من الأظرف التي كانت مع ساعي البريد، فوقع في نفسي أنه رقم هاتف البيت، وفي لمح البصر حفظت الرقم، وانتحيت جانبا وكتبته، ثم انصرفت.
اتصلت في وقت لاحق ففوجئت بأن الشيخ نفسه هو الذي يرد، فعرَّفتْه بنفسي، وأبديت له رغبتي في زيارته لأعرض عليه موضوع رسالتي للماجستير، والواقع أنني كنت أريد أن أشبع رغبة قديمة وملحة وهي رؤية الشيخ والجلوس بين يديه والحديث معه، فتذرَّعت بموضوع الماجستير، فقال اتصل بي في وقت ما، لا أتذكره الآن، فاتصلت به فوجدته نائما.. فذهبت إلى البيت مرة أخرى فلم أجده؛ علما بأن بين إقامتي وبين بيت الشيخ ما يستغرق ثلاث ساعات بين المواصلات والحافلات المختلفة، وكنت أقطع على قدمي مسافات طويلة نظرا لقلة وجود مال يبلغني!
ثم ذهبت إليه في وقت الظهر وصممت أن ألقاه هذه المرة، فوجدت الحارس وقلت له أريد أن ألقى الشيخ، فقال هل هناك موعد، فقلت لا، ولكنني لن أبرح مكاني حتى ألقاه، فذهب الحارس ورجع وقال تفضل..فصعدت إلى حيث يقيم الشيخ وطرقت الباب فإذا الذي يفتح لي هو الشيخ نفسه!!
فخفق قلبي بشدة، وسلمت عليه سلامًا حارًّا، وقبَّلت رأسه، وجلست معه ما يقرب من ساعة، وكان يقدم الضيافة بنفسه مما سبب لي حرجًا كبيرًا - علمت لاحقًا أنها عادته مع ضيوفه - وسألته عن بعض القضايا الأصولية والفقهية والدعوية.
سألته عن قول الصحابي مثلا الذي رأى أنه ليس بحجة عند تحرير محل النزاع، وسألته عن القضايا الشرعية التي يجب أن يصرف الباحثون همتهم لبحثها والاشتغال بها، فذكر لي: الوصل بين الفقه والحديث، والموازنة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، والاهتمام بالفقه الحضاري مثل فقه السنن وفقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه المقاصد وفقه المآلات، وغيرها من أنواع الفقه الحضاري.
وسألته عن موجات الهجوم عليه والتجريح فيه من أبناء مدرسة (الظاهرية الجدد) كما أسماها هو، فقال: إنني لا أهتم كثيرا بالردود على من يهاجمونني إلا إذا وجدت مسوغا علميا لذلك؛ وهذا لأن العمر أقصر من أن أضيعه في الردود على من يهاجمونني ويجرّحون شخصي، وقضايا الأمة وواجبات الوقت أعظم وأكبر من أن أنشغل بغيرها.
وكانت إحدى الأسئلة في موضوع رسالتي للماجستير (نظرية الجبر في الفقه الإسلامي)، ففاجأني بجوابه حين قال: "لن أستطيع أن أجيبك قبل أن أبحث؛ لأنه سؤال يحتاج إلى بحث وتأمل"، وساعتها قلت في نفسي: إذا كان الشيخ ـ وهو من هو! ـ لا يتسرع في الجواب على سؤال ما قبل أن يبحث ويتأمل، فماذا يفعل مثلي؟!.
بعد أن سألته عما أريد التقطت معه صورًا تذكارية، وطلبت إليه في نهاية اللقاء أن ينصحني، فقال لي داعيًا، وكأنني أسمعها تتردد في أذني حتى الآن: "أسأل الله أن يشرح صدرك، وأن ينير بصيرتك، وأن ييسر لك الطريق".
كان قلبي يقفز من الخفقان والفرحة ساعتها، ووقع في نفسي أنه دعاء مستجاب، واستشعرت أن أبواب السماء مفتوحة لدعائه ورجائه، وخرجت من عنده طائر الفرح، وقلت في نفسي: "لأجتهدن في فعل الصالحات إن شاء الله بما يحقق فيّ هذا الدعاء"! ثم زرته بعد ذلك مرات في بيته؛ منفردا ومع آخرين.



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين