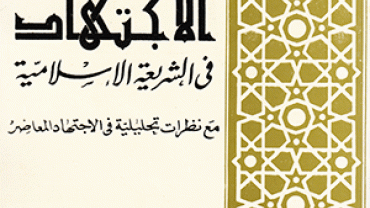د. يوسف القرضاوي
من حق العلم على صاحبه: أن يعمل بموجبه، فالعلم بالعبادات يقتضي أن يؤديها على وجهها، مستوفية شروطها وأركانها، خالصة لوجه الله تعالى.
والعلم بالمعاملات يقتضي أن يقوم بها في حدود الحلال، بعيدة عن الحرام، مستكملة الشروط والأركان، والعلم بالأخلاق يقتضي أن يتحلى بفضائلها ويتخلى عن رذائلها، والعلم بطريق الآخرة، يقتضي أن يعد لها عدتها، ويسعى لها سعيها، ويحذر من قواطع الطريق التي تعمل على أن تثبط إرادته، وتعوق حركته؛ وبهذا يكون العلم حجة له، لا حجة عليه، ويستطيع أن يجد للسؤال جوابا إذا سئل يوم القيامة "عن علمه: ماذا عمل فيه"؟
فعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره: فيم أفناه؟ وعن علمه" فيم فعل فيه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه: فيم أبلاه؟".
ولا يكون كذلك العالم الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، وأخلد إلى الأرض، واتبع هواه، فضرب الله مثلا بالكلب في أسوأ صورة له: "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ . وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث" (الأعراف:175-176)
وإنما ينتصر الدين، وترتقي الدنيا، بالعلماء العاملين، الذين يؤيد عملهم علمهم، وتصدق أفعالهم أقوالهم، فهم يؤثرون في الناس بسلوكهم وحالهم، أكثر مما يؤثرون بكلامهم، ولهذا قيل: حال رجل في ألف رجل، أبلغ من مقال ألف رجل في رجل!
وإن من شر ما تبتلى به الحياة، ويبتلى به الناس: العالم الذي يناقض عمله علمه، ويكذب فعله قوله، فهو فتنة لعباد الله، وهو الذي حذر القرآن من أهل الإيمان: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ"(الصف:2-3) ، ووبخ القرآن بني إسرائيل بقوله: "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ"(البقرة:44) ، ولا غرو أن استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، فعن زيد بن أرقم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها".
وعن أسامة بن زيد: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتابه (أي تخرج أمعاؤه من مكانها)، فيدور بها، كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه، فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف، ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه"!
قال أسامة: وإني سمعته ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول: "مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون"!
وصور النبي صلى الله عليه وسلم العالم الذي ينفع الناس بعلمه ولا ينتفع به تصويرا بليغا، حين قال: "مثل الذين يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل الفتيلة (يعني: السراج، أو الشمعة) تضيء للناس، وتحرق نفسها"! وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان"!
وسر هذا الخوف: أن هذا المنافق مزوق الظاهر، خرب الباطن، حلو اللسان، مر العمل، فهو يغر الناس بظاهر علمه، ويسحرهم بمعسول كلامه، وقلبه خاو من اليقين، فالمنافق الجاهل ليس من ورائه خطر يذكر، إنما الخطر في هذا المنافق العليم اللسان.
وعن عمر بن الخطاب قال: حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل منافق عليم اللسان؛ ولهذا كان عمر كثيرا ما يستعيذ بالله من المنافق العليم، وقد سئل: كيف يكون منافقا وعليما؟ قال: عالم اللسان جاهل القلب، وقال علي بن أبي طالب: قصم ظهري رجلان: جاهل متنسك، وعالم متهتك، ذاك يغر الناس بتنسكه، وهذا يضلهم بتهتكه!
.............
* من كتاب "الحياة الربانية والعلم" لفضيلة الشيخ.



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين