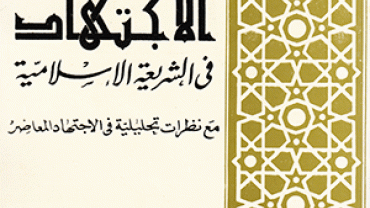أهمية الأمل في تحقيق السكينة والسعادة
ومن مصادر الأمن والسكينة لدى المؤمن: ما يغمر جوانحه من أمل ذلك الشعاع الذي يلوح للإنسان في دياجير الحياة فيضيء له الظلمات، وينير له المعالم ويهديه السبيل، ذلك هو الأمل، الذي به تنمو شجرة الحياة، ويرتفع صرح العمران، ويذوق المرء طعم السعادة، ويحس ببهجة الحياة.
الأمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل، وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب، وتبعث النشاط في الروح والبدن، وتدفع الكسول إلى الجد، والمجد إلى المداومة على جده، والزيادة فيه تدفع المخفق إلى تكرار المحاولة حتى ينجح، وتحفز الناجح إلى مضاعفة الجهد ليزداد نجاحه.
إن الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرق أمله في الحصاد، والذي يغري التاجر، بالأسفار والمخاطر، أمله في الربح، والذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله في النجاح، والذي يحفز الجندي إلى الاستبسال أمله في النصر، والذي يهون على الشعب المستعبد تكاليف الجهاد أمله في التحرر، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أمله في العافية، والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه أمله في رضوانه وجنته.
الأمل إذن هو إكسير الحياة، ودافع نشاطها، ومخفف ويلاتها، وباعث البهجة والسرور فيها. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!
والأمل -قبل ذلك كله- شيء حلو المذاق، جميل المحيا في ذاته، تحقق أو لم يتحقق. واستمع إلى الشاعر العاشق يقول:
أمـاني من ليلى عذاب كأنمــا سقتني بها ليلى على ظمأ بردا
مني إن تكن حقاً تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغـدا
وضد الأمل اليأس .. وهو انطفاء جذوة الأمل في الصدر، وانقطاع خيط الرجاء في القلب، فهو العقبة الكئود والمعوق القاهر الذي يحطم في النفس بواعث العمل. ويوهي في الجسد دواعي القوة، ورحم الله من قال:
واليأس يحدث في أعضاء صاحبه ضعفاً ويورث أهل العزم توهينا
وقال ابن مسعود: "الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب" ... والقنوط هو اليأس، والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور بما قدمته. قال الإمام الغزالي: (إنما جمع بينهما: لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب، والجد والتشمر، والقانط لا يسعى ولا يطلب، "لأن ما يطلبه مستحيل في نظره". والمعجب يعتقد أنه قد سعى وأنه قد ظفر بمراده، فلا يسعى، فالموجود لا يطلب، والمحال لا يطلب، والسعادة موجودة في أعتقاد المعجب حاصلة، ومستحيلة في اعتقاد القانط ... فمن ههنا جمع بينهما) .
ومصداق هذا الكلام في الحياة جلي واضح: إذا يئس التلميذ من النجاح .. نفر من الكتاب والقلم، وضاق بالمدرسة والبيت، ولم يعد ينفعه درس خاص يتلقاه، أو نصح يسدى إليه، أو تهيئة المكان والجو المناسب لاستذكاره، أو ... أو ... إلا أن يعود الأمل إليه.
وإذا يئس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب، والعيادة والصيدلية، وضاق بالحياة والأحياء. ولم يعد يجديه علاج، إلا أن يعود الأمل إليه.
وهكذا إذا تغلب اليأس على إنسان -أي إنسان- اسودت الدنيا في وجهه وأظلمت في عينيه، وأغلقت أمامه الأبواب، وتقطعت دونه الأسباب، وضاقت عليه الأرض بما رحبت:
وأصبح لا يدري وإن كان دارياً أقدامه خير له أم وراءه؟
ذلك هو اليأس: سم بطيء لروح الإنسان، وإعصار مدمر لنشاط الإنسان، وتلك حال اليائسين أبد الدهر: لا إنتاج للحياة، ولا إحساس بمعنى الحياة.
تلازم اليأس والكفر
وليس بعجيب أن تجد هذا الصنف من الناس بوفرة وغزارة بين الجاحدين بالله أو ضعاف الإيمان به: لأنهم عاشوا بأنفسهم فحسب -زعموا- وقطعوا الصلة بالكون ورب الكون، فلا غرو أن نجد هؤلاء الكافرين أيأس الناس. كما نجد اليائسين أكفر الناس، فهناك ارتباط بين اليأس والكفر، كلاهما سبب للآخر وثمرة له: اليأس يلد الكفر والكفر يلد اليأس: (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) (يوسف: 87) (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) (الحجر: 56).
وأظهر ما يتجلى هذا اليأس في الشدة ونزول الشر، وقد كرر القرآن ذمه لهذا النوع من الناس فقال: (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور) (هود: 9)، ثم استثنى من ذلك بعد: (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) (هود: 11)، وقال: (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يؤساً) (الإسراء: 83)، (وإن مسه الشر فيؤس قنوط) (فصلت:49) .
وليس اليأس من لوازم الكفر فحسب، بل من لوازم الشك أيضاً. فكل من فقد اليقين الجازم بالله ولقائه، وحكمته وعدله، فقد حرم الأمل والنظرة المتفائلة للناس والكون والحياة، وعاش ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود قاتم، ويرى الأرض غابة والناس وحوشاً والعيش عبئاً لا يطاق ... على نحو ما قال أبو العلاء:
هــــذا جناه أبي علي وما جنيت على أحـــد
وقال:
لا تبك ميتاً ولا تفرح بمولود فالميت للدود والمولود للدود!
الإيمان يلد الأمل
وفي الجانب الآخر نجد الإيمان والأمل متلازمين، فالمؤمن أوسع الناس أملاً، وأكثرهم تفاؤلاً واستبشاراً، وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر، إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء، ولا تعجز عن شيء، الاعتقاد بقوة غير محصورة، ورحمة غير متناهية، وكرم غير محدود، الاعتقاد بإله قدير رحيم، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، يمنح الجزيل، ويغفر الذنوب، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأبر بخلقه من أنفسهم.
إله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
إله يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وجد، والغائب إذا وفد، والظمآن إذا ورد.
إله يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو يزيد، ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو.
إله يدعو المعرض عنه من قريب، ويتلقى المقبل عليه من بعيد، ويقول: "أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وأن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وأن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" (حديث قدسي رواه البخاري وغيره) .
إله يداول الأيام بين الناس. فيبدل من بعد الخوف أمنا، ومن بعد الضعف قوة، ويجعل من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، ومع كل عسر يسراً.
المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله البر الرحيم، العزيز الكريم، الغفور الودود، ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد - يعيش على أمل لا حد له، ورجاء لا تنفصم عراه. إنه دائماً متفائل، ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك، ويستقبل أحداثها بثغر باسم، لا بوجه عبوس قمطرير.
فهو إذا حارب كان واثقا بالنصر، لأنه مع الله فالله معه، ولأنه لله فالله له (إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون) (الصافات:173،172) .
وإذا مرض لم ينقطع أمله في العافية (الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين) (الشعراء: 78 - 80) .
وإذا اقترف ذنباً لم ييأس من المغفرة، ومهما يكن ذنبه عظيماً فإن عفو الله أعظم (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم) (الزمر:53) .
وهو إذا أعسر لم يزل يؤمل في اليسر (فإن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراً) (الشرح: 5، 6). ولن يغلب عسر يسرين أبداً. قال ابن مسعود: لو دخل العسر جحراً لتبعه اليسر.
وهو إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن كان على رجاء من الله أن يأجره في مصيبته ويخلفه خيراً منها (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) (البقرة: 156، 157) .
وهو إذا عادى أو كره، كان قريباً إلى الصلة والسلام، راجياً في الصفاء والوئام، مؤمناً بأن الله يحول القلوب (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم) (الممتحنة:7).
وهو إذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال، وأن الحق إلى ظهور وانتصار (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) (الأنبياء: 18)، (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) (الرعد:17).
وهو إذا أدركته الشيخوخة، واشتعل رأسه شيباً. لم ينفك يرجو حياة أخرى فيها شباب بلا هرم، وحياة بلا موت، وسعادة بلا شقاء (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتياً * لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً) (مريم: 61، 62) .
إن الماديين يقفون عند السنن المعتادة، والأسباب الظاهرة، لا يطمعون في شيء وراءها، أما المؤمنون فيعلون على ظواهر الأسباب، وينفذون إلى سر الوجود، إلى الله خالق الأسباب والمسببات، الذي عنده من الأسباب الباطنة ما يخفى على إدراك عباده، فلماذا لا تتجه قلوبهم إليه حين تدلهم الأزمات، وتستحكم الحلقات، ويضيق على أعناقهم الخناق؟.
إنهم يجدون فيه الملاذ في الشدة. والأنيس في الوحدة، والنصير في القلة. يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء، ويدعوه آملاً الشفاء.
ويتجه إليه المكروب يسأله الصبر والرضا، والخلف من كل فائت، والعوض من كل مفقود.
ويتجه إليه المظلوم آملاً يوماً قريباً ينتصر فيه على ظالمه، فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب.
ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلاً أن يرزقه ذرية طيبة.
وكل واحد من هؤلاء آمل في أن يجاب إلى ما طلب، ويحقق له ما ارتجى، فما ذلك على قدرة الله ببعيد، وما ذلك على الله بعزيز.
طلب إبراهيم الولد وهو شيخ كبير (رب هب لي من الصالحين) (الصافات: 100) فاستجاب الله له وبعث إليه الملائكة، في صورة ضيوف من البشر فقالوا له (إنا نبشرك بغلام عليم * قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون * قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين * قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) (الحجر: 53 - 56).
وقد أثنى على ربه فقال: (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء) (إبراهيم: 39) .
ويعقوب بعد أن طالت غيبة ولده يوسف عنه، وبعدت مسافة الزمن بينه وبينه، وكان جديراً أن يفقد الأمل في لقائه، ثم فجع بحجز شقيقه من بعده في حادثة صواع الملك، لكنه مع هذا لم يتسرب إلى فؤاده اليأس، بل قال: (فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً، إنه هو العليم الحكيم) (يوسف: 83) .
وحين أبدى أسفه على ابنه يوسف قال له أبناؤه: (تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين * قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون) (يوسف: 85، 86). ثم ألقى إلى أبنائه بحقيقة ما في نفسه من أمل حلو تعززه الثقة بالله أن يجمع شمله بأبنائه فقال: (يا بني أذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) (يوسف: 87) .
(ذكر رحمة ربك عبده زكريا * إذ نادى ربه نداءً خفياً * قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً * وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً * يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضياً) (مريم: 2 - 6) فاستجابت له السماء: (يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً) (مريم:7) .
(وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين)(الأنبياء: 83، 84).
ويونس قد ابتلعه الحوت (فنادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين) (الأنبياء: 87، 88).
وموسى حين يسري بقومه لينجو بهم من فرعون وجنوده، فيعلمون بسراه ويحشدون الحشود ليدركوه (فأتبعوهم مشرقين * فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون) (الشعراء: 60، 61) وأي إدراك أكثر من هذا؟ البحر من أمامهم والعدو من ورائهم!! بيد أن موسى لم يفزع ولم ييأس، بل قال (كلا، إن معي ربي سيهدين) (الشعراء: 62) ولم يضيع أمله سدى … (فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم * وأزلفنا ثم الآخرين * وأنجينا موسى ومن معه أجمعين * ثم أغرقنا الآخرين * إن في ذلك لآية) (الشعراء: 63 - 67).
ومحمد يلجأ إلى غار ثور في هجرته مع صاحبه الصديق، ويقتفي المشركون آثار قدميه، ويقول قائفهم: لم يعد محمد هذا الموضع .. فإما صعد إلى السماء من هنا، وإما هبط إلى الأرض من هنا … ويشتد خوف الصديق على صاحب الدعوة وخاتم النبيين ويبكي ويقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له النبي:"ما ظنك باثنين الله ثالثهما"، وكانت العاقبة ما ذكره القرآن (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم) (التوبة:40).
وهذه وقائع عرفها التاريخ الذي لا شك فيه، وربما أنكر الماديون بعضها أو كلها، لأنها تخرج على الأسباب المعتادة للناس، غير أن المؤمنين يوقنون أن الأسباب المعتادة لا تحد قدرة الله المطلقة، وليس ثباتها واجباً عقلياً لا يقبل الانفكاك، ولو جمد العلماء والمخترعون على ما اعتاده الناس، وما تعارفوا عليه في عصرهم، ما تقدم العلم شبراً ولا فتراً، وما وصلنا إلى عصر الذرة والفضاء.
ضرورة الأمل في الحياة
الأمل لابد منه لتقدم العلوم، فلو وقف عباقرة العلم والاختراع عند مقررات زمنهم ولم ينظروا إلا إلى مواضع أقدامهم، ولم يمدهم الأمل بروحه في كشف المجهول، واكتساب الجديد من الحقائق والمعارف، ما خطا العلم خطواته الرائعة إلى الأمام ووصل بالإنسان إلى القمر.
والأمل لابد منه لنجاح الرسالات والنهضات، وإذا فقد المصلح أمله فقد دخل المعركة بلا سلاح يقاتل به، بل بلا يد تمسك بالسلاح، فأنى يرتقب له انتصار وفلاح؟
وإذا استصحب الأمل فإن الصعب سيهون، والبعيد سيدنو، والأيام تقرب البعيد، والزمن جزء من العلاج.
والمثل الأعلى للمصلحين سيدنا رسول الله صلوات الله عليه:
ظل في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو قومه إلى الإسلام، فيلقون دعوته بالاستهزاء، وقرآنه باللغو فيه، وحججه بالأكاذيب، وآياته بالتعنت والعناد، وأصحابه بالأذى والعذاب، فما لانت له قناة، ولا انطفأ في صدره أمل.
اشتد أذى المشركين لأصحابه، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم في ثقة ويقين: "تفرقوا في الأرض وإن الله سيجمعكم".
وجاءه أحد أصحابه "خباب بن الأرت" وكانت مولاته تكوي ظهره بالحديد المحمي فضاق بهذا العذاب المتكرر ذرعاً، وقال للرسول في ألم: ألا تدعو لنا؟ كأنه يستبطئ سير الزمن ويستحث خطاه ويريد حسم الموقف بين الإيمان والشرك بدعوة محمدية تهتز لها قوائم العرش، فينزل الله بأسه بالقوم المجرمين كما أنزله بعاد وثمود والذين من بعدهم.
وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العجلة من صاحبه. وألقى عليه درساً في الصبر على بأساء اليوم، والأمل في نصر الغد، فقال: "إن الرجل قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، وينشر بالمنشار فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه … ولكنكم تستعجلون!!".
وفي الهجرة من مكة، والنبي خارج من بلده خروج المطارد المضطهد الذي يغير الطريق، ويأوي إلى الغار، ويسير بالليل، ويختفي بالنهار … وفي الطريق يلحقه الفارس المغامر سراقة بن مالك وفي رأسه أحلام سعيدة بمائة ناقة من حمر النعم -جائزة قريش لمن يأتي برأس محمد حياً أو ميتاً- ولكن قوائم جواده تسوخ في الأرض ويدركه الوهن، وينظر إليه الرسول، ويكشف الله له عن الغيب المستور لدينه فيقول له: "يا سراقة كيف بك إذا ألبسك الله سواري كسرى؟" فيعجب الرجل ويبهت ويقول: كسرى بن هرمز؟ فيقول: "نعم".
ويذهب الرسول إلى المدينة، ويبدأ في كفاح دام مرير مع طواغيت الشرك، وأعوان الضلال، وتسير الحرب -كما هي سنة الله- سجالاً. حتى تأتي غزوة الأحزاب فيتألب الشرك الوثني بكل عناصره، والغدر اليهودي بكل تاريخه، ويشتد الأمر على النبي وأصحابه: قريش وغطفان ومن يحطب في حبلهما من خارج المدينة، واليهود والمنافقون من الداخل.
موقف عصيب صوَّره القرآن بقوله: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً) (الأحزاب: 10، 11) في هذه الساعات الرهيبة التي يذوي فيها عود الأمل، ويخبو شعاع الرجاء، ولا يفكر المرء إلا في الخلاص والنجاة ...
في هذه اللحظات والنبي يسهم مع أصحابه في حفر الخندق حول المدينة يصدون بحفره الغزاة، ويعوقون الطامعين العتاة - يحدث النبي أصحابه عن الغد المأمول، والمستقبل المرجو حين يفتح الله عليهم بلاد كسرى بفارس، وبلاد قيصر بالشام، وبلاد اليمن بالجزيرة، حديث الواثق المطمئن الذي أثار أرباب النفاق فقالوا في ضيق وحنق: إن محمداً يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء وحده! أو كما قال القرآن: (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) (الأحزاب:12).
ماذا تسمي هذا الشعاع الذي يبزغ في دياجير الأحداث من القلوب الكبيرة، فينير الطريق ويبدد الظلام؟ إنه الأمل، وإن شئت فهو الإيمان بنصر الله: (ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم * وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الروم: 5، 6).
---------- يُتبع ----------



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين