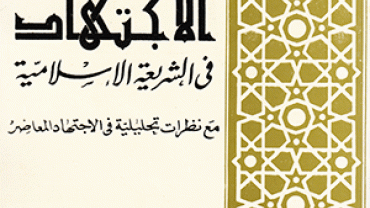د. يوسف القرضاوي
كان أول مبدأ قرره الإسلام: أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع، هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه، فإذا لم يكن النص صحيحا -كبعض الأحاديث الضعيفة- أو لم يكن صريحا في الدلالة على الحرمة، بقي الأمر على أصل الإباحة.
وقد استدل علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة، بآيات القرآن الواضحة من مثل قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} (البقرة:29) ، {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ} (الجاثية:13)، {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} (لقمان:20).
وما كان الله سبحانه ليخلق هذه الأشياء ويسخرها للإنسان ويمن عليه بها، ثم يحرمه منها بتحريمها عليه، وكيف وقد خلقها له، وسخرها له، وأنعم بها عليه؟ وإنما حرم جزئيات منها لسبب وحكمة سنذكرها بعد.
ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا. ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يجيء نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.
وفي هذا ورد الحديث "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}" (مريم:64) .
وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم" فلم يشأ عليه السلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ماعداه حلالا طيبا.
وقال رسول الله: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".
وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها "العادات أو المعاملات" فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقيد إلا ما حرمه الشارع وألزم به. وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (الأنعام:119) ، عام في الأشياء والأفعال.
وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي. وفيها جاء الحديث الصحيح "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده -كائنا من كان- فهي ضلالة ترد عليه. لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه.
وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها. بل الناس هم الذين أنشؤوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. الأصل فيه عدم الحظر. فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} (الشورى:21) . والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً} (يونس:59) .
وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم -كالأكل والشرب واللباس- فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.
وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون، ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة -وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروها- وما لم تحد الشريعة، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي"، ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعزل، والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن).
فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع. وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة: ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله.



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين