د. يوسف القرضاوي
حدثنا الشيخ (أبو الحسن الندوي) رحمه الله عن قصة كتابه (ماذا خسر العالم؟) بإفاضة، يحسن بنا أن نسجلها هنا، قال: لعل كثيرا من القراء الفضلاء لا يعلمون أن هذا الكتاب كان باكورة مؤلفاتي، وكان بداية تاريخ التأليف، وقد ألفت هذا الكتاب وأنا قد جاوزت الثلاثين من عمري قريبا ، وكان أضخم من أن يتناوله مثلي في مثل هذه السن المبكرة، وفي بلد بعيد عن مركز اللغة العربية وآدابها وثقافتها، وقد ولدت في الهند ونشأت وتعلمت فيها، ولم يقدر لي أي سفر خارج الهند، وكانت الرحلة الأولى المباركة التي وفقني الله لها هي الرحلة التي قمت بها لأداء فريضة الحج سنة 1366هـ (1947م)، يعني بعد تأليف هذا الكتاب بثلاث سنوات، فكانت في الحقيقة مغامرة علمية لم أكن متهيئا ولا مرشحا لها، وكان من الجسارة أن أتناول هذا الموضوع الذي كان جديرا بقلم أكبر من قلمي، وبعقل أوسع من عقلي، وبتجربة أطول وأوسع من تجربتي كمؤلف، ولكن الله يفعل ما يشاء.
لقد كنت أشعر برغبة غامضة ملحة لم أستطع أن أغالبها، كأن سائقا يسوقني إلى الكتابة في هذا الموضوع ولو استشرت العقل واعتمدت على تجارب المؤلفين، وعلى مقاديرهم ومكانتهم العلمية، لأحجمت، ولعدلت عن هذه الفكرة، ولو ذكرت ذلك لأحد العقلاء العلماء، والكُتَّاب الفضلاء، لأشاروا عليَّ بالعدول عن خوض هذه المعركة العلمية العقلية، ولكنه كان من الخير أنني لم أستشر أحدا.
وكانت المراجع العربية التي كان لا بد من أن استشيرها في الموضوع قليلة، لأن ذلك العهد كان قريبا بالحرب العالمية الثانية، وكانت الصلات تكاد تكون منقطعة بين الهند والبلاد العربية، فكانت الهند تستورد قيلا من البضاعة العلمية والمراجع التاريخية والثقافية باللغة العربية، التي كانت تزخر بها البلاد العربية بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، أما المراجع العلمية باللغة الإنجليزية والأردية فكانت متوفرة، وكانت بمتناول يدي وكانت في لكهنؤ ـ مدينة العلم والثقافة ـ مكتبات غنية فيها أحدث المطبوعات الإنجليزية والموسوعات العلمية وكنت على اتصال بها، أستعير منها الكتب وأطالعها وأستفيد من بعض المكتبات الشخصية، وكان من تيسير الله تعالى والإرهاص لتأليف هذا الكتاب، أني كنت طالعت قريبا تاريخ أوربا سياسة واجتماعا، وديانة وخلقا، وحضارة وثقافة، بنهامة وفي توسع وعمق، وعنيت بموضوع الصراع بين الديانة والعلم، والبلاط والكنيسة، دراسة اختصاصية وتاريخ الأخلاق في أوربا وتطورها، والعوامل التي صاغتها صياغة خاصة، انتهت بها إلى هذا المصير المادي، الذي أثر في مسيرة الشعوب الغربية والشرقية واتجاهاتها، تأثيرا عاما وحاسما.
هذا عدا تاريخ الأقطار الشرقية والإسلامية، ودياناتها وحركاتها وفلسفاتها، وتاريخ الإسلام والمسلمين، وتاريخ العرب في الجاهلية والإسلام، من خلال الكتب المختصة بهذا الموضوع، ومن خلال الشعر والأدب فكان أيسر لي نسبيا بفضل ثقافتي الدينية والأدبية والتاريخية ولأن موادها كانت متوفرة في مكتبة ندوة العلماء الكبيرة، ومكتبات شخصية، وبفضل الاتصال الدائم بحركة الترجمة والنشر في شبه القارة الهندية، ومطالعة المجلات والصحف العليمة الراقية، وما تنشره من بحوث ودراسات علمية.
زد إلى ذلك التكوين العقلي والنفسي الممتاز، المؤمن بخلود رسالة الإسلام، وقيادة محمد عليه الصلاة والسلام وإمامته للأجيال البشرية عبر العصور، وبالنقص الواقع في طبيعة الحضارة الغربية، ومزاج الأمم الغربية، الذي لا يفارقها في حال من الأحوال، وظهوره في شكل مجسم في قيادتها، وذلك نتيجة تربية أخي الأكبر الدكتور السيد عبد العلي الحسني أمين ندوة العلماء العام، الذي كان مثالا فريدا في الجمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية العصرية، وعمق فهمه للإسلام واتزانه الفكري البعيد عن كل غلو وتطرف، وقد جعلني كل ذلك أنتفع من دراساتي المتنوعة ـ المتناقضة أحيانا المشوشة لكثير من القراء الذين لا يزالون في سن المراهقة الفكرية ـ وأستخرج منها نتائج إيجابية معينة، و (من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين) وتزداد بها ثقتي بصلاح الإسلام للقيادة والسيادة في كل عصر، وإيماني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم، هو " خاتم الرسل، وإمام الكل، ومنير السُّبُل " وكنت أشعر بخطر الموضوع وأهميته، وبقلة بضاعتي وحداثة سني، وقلة أعواني، وجدة موضوع الكتاب وطرافته، ولكن لم أكن في الحقيقة مخيرا، بل كنت مسيرا، كأن هاجسا يهجس في ضميري، ويقول لي: لا بد من وضع كتاب في هذا الموضوع.
كان من أسباب استرعاء هذا الكتاب انتباه كثير من الناس وإثارته لدهشة الكثير منهم، أن الموضوع كان طريفا مبتكرا (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟) هل للمسلمين صلة وثيقة بالمصير الإنساني وبالأوضاع العالمية، حتى يجوز أن يقال: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أو ماذا سيربح العالم ويجنيه من الفوائد، بتقدم المسلمين وتسلمهم لقيادة البشرية؟.
كان الناس قد اعتادوا في ذلك العصر، وقبل العصر الذي ألف فيه هذا الكتاب، أن ينظروا إلى المسلمين من خلال التاريخ العالمي، أو ينظروا إلى المسلمين كشعب عادي وكأمة من أمم كثيرة، ولكن تشجع مؤلف هذا الكتاب وتخطي هذه الحدود المرسومة، وخرج من الإطار التقليدي الذي فرض على المؤلفين والكتاب في العرب والعجم، فأراد أن ينظر إلى العالم من خلال المسلمين، وشتان بين النظرتين، نظرة ينظر بها إلى المسلمين من خلال العالم ومن خلال الحوادث التي جرت في العالم، ومن خلال التطورات التي حدثت في التاريخ، المسلمون شعب من الشعوب، يخضعون لما يجري في العالم في إطار عالمي واسع، فكان المنهج الفكري العام وأسلوب البحث الدائم، ماذا خسر المسلمون بسبب الحادث الفلاني؟ وبسبب انقراض الحكومة الفلانية، ماذا خسر المسلمون بسبب الثورة الصناعية الكبرى التي حدثت في العرب؟ ماذا خسر المسلمون بفتح الغرب لكثير من قلاع الإسلام والمسلمين؟ وماذا خسر المسلمون بفقرهم في الاقتصاد، وفي السياسة، وفي القوة الحربية؟
كان ذلك الطريق المرسوم التقليدي الذي اعتاده الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمني وشرح صدري لأن أكتب في موضوع ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ كأن المسلمين هم العامل العالمي المؤثر في مجاري الأمور في العالم كله، ليس في بقعة جغرافية محددة، أو منطقة سياسية خاصة، هل المسلمون حقا في وضع يمكن أن يقال أن العالم يخسر شيئا بانحطاطهم، هل المسلمون على مستوى يجوز أن يقال أن العالم قد خسر شيئا بتقهقرهم، وبتخلفهم عن مجال القيادة العالمية، إنني أخاف وأخشى أن كثيرا من الكُتَّاب الإسلاميين الذين كانت لهم مواقف جليلة وكانت لهم سوابق عديدة، لم يفكروا هذا التفكير، إن تشويه التاريخ الإسلامي والنظر إليه من زاوية ضيقة، ومركب النقص الذي أصيب به الجيل الجديد المثقف، كان يعوق كثيرا من الباحثين عن أن يربطوا قضية المسلمين بقضية العالم وبقضية الإنسانية، أين المسلمون من القيادة العالمية؟ المسلمون فقراء، المسلمون ضعفاء، المسلمون محكومون من الغرب، المسلمون خاضعون للثورات الحديثة.. فهل يصح أن يُرْبَط مَصيرُ العالم أو مصير الإنسانية بمصير المسلمين وواقعهم؟، لا! إن كثيرا من الناس لم يكونوا يصدقون في ذلك الحين أن المسلمين لهم من الأهمية والخطر والتأثير ومن المكانة، ما يؤهلهم لهذا البحث، ويسوغ لمؤلف أن يؤلف كتابا فيبحث عن مدى خسارة العالم الإنساني والعالم المعاصر بانحطاط المسلمين، إن الموضوع كان خطيرا، وكان البحث فيه شبه مجازفة ومغامرة علمية، ولكن الله سبحانه وتعالى أعان على ذلك.
ألفت هذا الكتاب على تردد وتخوف، لأنني كننت جديدا في مجال التأليف خصوصا في اللغة العربية فقد كانت صلتي بها صلة دارس يولد بعيدا ويعيش بعيدا عن مركز الثقافة العربية وعن مركز العلوم الإسلامية الأصيل، وكان يساورني شك، هل ينال هذا الكتاب تقديرا في البيئات العربية والإسلامية البعيدة، فأرسلت قائمة محتوياته إلى الدكتور أحمد أمين بك رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر في مصر، ورئيس الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، وقد نالت كتبه خصوصا سلسلة " فجر الإسلام " و " ضحى الإسلام " إعجاب القراء الباحثين، وكان لها دوي في الأوساط العلمية، وكنت معجبا بها، وقد درستها دراسة عميقة، وعلقت على آرائه بالموافقة في الغالب، وبالنقد والاختلاف في بعض الأمكنة، وأعجبت بأسلوبه المركز الذي يجري مع الطبع، وآثرت أن يصدر هذا الكتاب من هذه المؤسسة العلمية التي كانت لها ولما يصدر منها قيمة علمية كبيرة في الشرق العربي، فيقبل على قراءته الشباب المثقف والمعنيون بالأبحاث العلمية والدراسات الموضوعية، وأنا لا أعلم مصير هذه الأوراق التي تعطي فكرة إجمالية عن الكتاب، ومؤلفه مجهول، ليس له أثر علمي ولا شافع ولا مزك.
وفوجئت بكتاب تلقيته منه يطلب مني فيه نموذجا من هذا الكتاب، فأرسلت إليه قطعة من الكتاب.
وقعت موضوعات الكتاب، والعناوين الجانبية التي كانت تدل على محتويات الكتاب، وما حوته من مادة وبحوث، من الدكتور موقعا حسنا، ولكنه تخوف أن يكون هذا الكتاب الذي صدر من قلم عالم ديني نشأ وتثقف بعيدا عن العالم الغربي يغلب عليه الطابع الديني واللغوي ـ شأن علماء الأزهر والمعاهد الدينية القديمة ـ فسأل هل استفاد المؤلف من المراجع الأجنبية؟ فما كان الجواب بالإيجاب وأرسل المؤلف ثبت المراجع الإنجليزية، اطمأن الدكتور وأخبر بأن اللجنة قررت طبع هذا الكتاب، وأبدى إعجابه بالكتاب سواء من الناحية الأدبية أو الناحية المعنوية، وكان اليوم الذي تلقى فيه المؤلف هذه الرسالة من الدكتور، من أعظم أيام العمر فرحا وسرورا، لا ينساه المؤلف حتى هذا اليوم.
ومضت على ذلك شهور وأنا لا أعلم مصير هذا الكتاب، وذلك في سنة 1329 هـ (1950م) وفوجئت بنسخة مطبوعة عند سفير سوريا الأستاذ جواد المرابط عضو المجمع العلمي بدمشق، كان قد استصحبها من القاهرة، وكان يبدي إعجابه بعمق فكر علماء الهند وأصالته، مستشهدا بهذا الكتاب، الذي وقع إلى يده في زيارته القريبة لمصر، وهو لا يعرف أنه يتحدث إلى مؤلفه ومن السهل الميسور تقدير فرح المؤلف الشاب المغمور، الذي يفاجأ بأثره العلمي التأليفي الأول الصادر من أكبر دور النشر، فاستعاره من سعادة السفير ليرده إليه بعد مطالعته، ولكنه فوجئ كذلك بأن المقدمة الصغيرة التي قدم بها الدكتور أحمد أمين هذا الكتاب، لم تكن فيها تلك القوة التي كان يتوقعها المؤلف من كاتب إسلامي كبير كالدكتور أحمد أمين، وكان متحفظا شديد التحفظ في إبداء انطباعاته عن الكتاب ومؤلفه.
ولم يكن الأمر غريبا ـ وإن كان ثقيلا على المؤلف ـ فليس كل من يقدم كتابا يتحمس للموضوع الذي كتب فيه، فلا يكون ذلك إلا إذا كان المقدم يتجاوب مع فكرة المؤلف ويؤمن بها إيمانا عميقا، وليس كل باحث علمي وكاتب كبير ـ وإن كان في درجة الدكتور أحمد أمين بك ـ يرى أن العالم قد خسر حقا، والإنسانية قد نكبت نكبة كبيرة بانحطاط المسلمين، وانسحابهم عن ميدان القيادة والتوجيه العالمي، فذلك نمط خاص للتفكير والتفسير للتاريخ، ليس من اللازم أن يقتنع به كل مؤلف ودارس، وليست التَّبِعَة على الدكتور أحمد أمين ـ وفضله لا ينكر في نشر هذا الكتاب من لجنة التأليف والترجمة والنشر الموقرة ـ ولكن التبعة على مؤلف الكتاب الذي أَمَّل فيه الآمال البعيدة، وحمله ما لم يتهيأ له فكريا وعلميا، ولم تساعد ظروفه التربوية والدراسية الخاصة على انتهاج هذا المنهج، ثم لعل الدكتور أحمد أمين الذي كان يعتبر من أساتذة الجيل الجديد ومن كبار المؤلفين والأدباء، خاف ـ وله الحق ـ أن يعطي المؤلف الذي لا يعرفه معرفة شخصية ولم يتحقق مستواه العلمي والنظرة التي ينظر بها إليه مواطنوه وعلماء بلاده، أكثر مما يستحق، فيقال: إنه كساه ثوبا سابغا فضفاضا أكبر من قامته وقيمته، وسامحه الله وجزاه عن المؤلف والقراء أحسن الجزاء، فقد كان السبب في وصول هذا الكتاب إلى الأوساط العلمية المتنورة التي لا تعير كتابا يصدر عن مؤسسة دينية، شيئا من العناية والاهتمام.
واتفقت رحلة المؤلف إلى مصر في يناير سنة 1951م بعد ما مضى على صدور هذا الكتاب شهران أو أكثر، فوجد أن الكتاب قد شق طريقة إلى الأوساط العلمية والدينية وحل منها محلا لم يكن يتوقعه المؤلف بل يحل به، وقد قرئ في نطاق أوسع من المثقفين والمعنيين بقضية الإسلام وانتفاضته، وصحوة المسلمين، وكان نشاط " الإخوان المسلمون " قد بدأ يدب، وخفف الخناق عليهم بعض التخفيف، وكأن هذا الكتاب قد جاء في أوانه ومكانه، وتناغم مع شعورهم وما يدعو إليه، وكان الجرح عميقا وداميا شهادة الإمام الشهيد وحل حركة الإخوان، فجاء هذا الكتاب مسليا معزيا، بل كسلاح علمي يدافعون به عن فكرتهم، وشحنة جديدة وزادا ومددا " لبطاريتهم " فقرأوه في المعتقلات، وقرروه في منهج الدراسة والمطالعة، واستشهدوا ببعض عباراته في المحاكم، واستقبلوا ـ بطبيعة الحال ـ مؤلفه بحماس وحب، وكان الكتاب خير معرف للمؤلف الزائر الجديد، وممهدا للثقة به والحديث معه.
وكان الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ سيد قطب في مقدمة من رحب بهذا الكتاب، وعني به، وشجع تلاميذه وإخوانه على مطالعته، وفي يوم من الأيام تلقى المؤلف دعوة من الأستاذ سيد قطب لحضوره ندوة تجتمع في منزله بحلوان كل جمعة، وتبحث في موضوع إسلامي، أو تستمع إلى تلخيص كتاب بقلم أحد الحاضرين وتتناول البحث فيه، وكان الموضوع ذلك اليوم كتاب (ماذا خسر العالم) وقد لخصه أحد تلاميذه من خريجي جامعة فؤاد الأول، فلبى المؤلف هذه الدعوة الكريمة الحبيبة، التي هي رمز لتقدير مجهوده العلمي الكتابي المتواضع وتشريف له، فحضر هذه الندوة وساهم في ابحث، وأجاب عن بعض الأسئلة الموجهة إليه كمؤلف.
وهناك بدت له فكرة الطلب من الأستاذ سيد قطب ليقدم هذا الكتاب بقلمه المؤمن القوي، وأسلوبه العلمي الهادف، وقَبِلَ الأستاذ سيد قطب هذه الدعوة بسرور وحماس، وكتب تلك المقدمة القوية التي زادت في قيمة الكتاب، وقوته .
وصادف ذلك طلب الأستاذ الفاضل والعالم المؤمن الدكتور محمد يوسف موسى، أستاذ كلية أصول الدين في الأزهر، ورئيس جماعة الأزهر للتأليف والترجمة والنشر ـ الذي كان من كبار المعجبين بهذا الكتاب المنوهين به، والحافزين على قراءته ـ إصدار الطبعة الثانية المنقحة من جماعة الأزهر فسمح له المؤلف شاكرا مسرورا، وأخذ الدكتور التصريح والموافقة من الدكتور أحمد أمين، وكتب مقدمة يتجلى فيها إخلاصه وحبه، واستجابته للفكرة، حلى بها جِيدَ الكتاب وفاجأ المؤلف صديقه الدكتور أحمد الشرباصي أحد علماء الأزهر وأساتذته، في إحدى زياراته، فاختلس منه معلومات عن أسرته وبيئته ونشأته، ودراسته وحياته، لا يعلم المؤلف ماذا سيصنع بها، فَكَوَّن بها مقالا عن المؤلف عَنْوَنَه بـ " أخي أبو الحسن " (صورة وصفية) وضمه إلى الكتاب، ولم يعلم به المؤلف إلا حين صدرت الطبعة الثانية سنة 1953م، وتلت هذه الطبعة طبعات وترجمات في لغات الشرق والغرب وها هي ذي الطبعة الثالثة عشرة القانونية.
وهذه قصة الكتاب في إيجاز وصدق وصراحة، ولله المَنُّ والفضل أولا وآخرا.
ــــــــ
- عن كتاب "الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته" للشيخ القرضاوي.


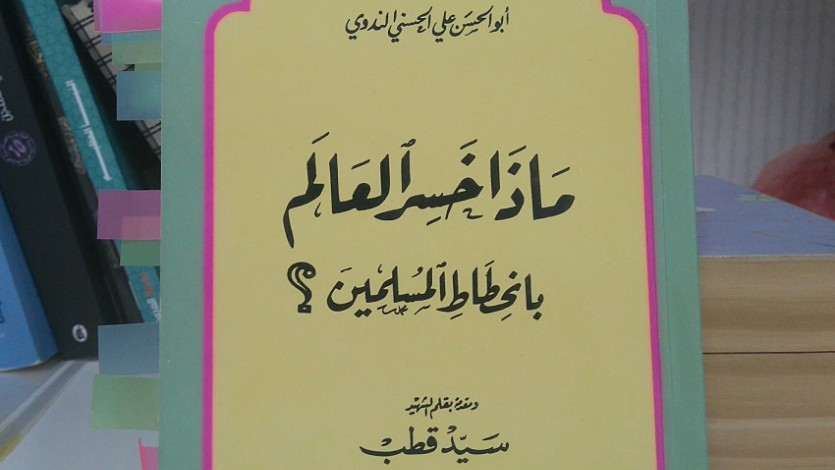
 عالم وطاغية (مسرحية تاريخية)
عالم وطاغية (مسرحية تاريخية)  الناس والحق
الناس والحق  السنة والبدعة
السنة والبدعة  الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته
الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته 






