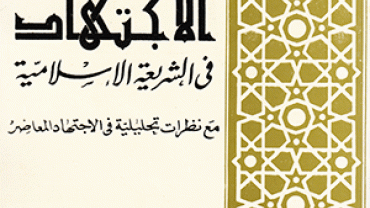معتز الخطيب
على مدى الأسابيع القليلة الماضية تابعت - باهتمام شديد - ما يُكتب ويُعلَّق على المسألة الشيعية - السنية (تصريحات العلامة القرضاوي وردود الفعل عليها)، وهو أمر يبرهن - من جديد وبوضوح - على أن أطروحة «التقريب» التي طُرحت في أواخر الأربعينات من القرن الماضي لم تنجح، أو هي على الأقل في محنة!
ومعيار الفشل والنجاح هنا هو الفاعلية في وقت الأزمات، فأوقات الرخاء ليست معياراً للنجاح، وكذلك الأدبيات المتعاظمة والمتكاثرة حول «التقريب» ليست برهان وعيٍ أو تَقدمٍ في هذا الموضوع.
أما ملامح المحنة فهي ليست جديدة، بل هلّت بوادرها منذ حرب أميركا على العراق عام 2003، ذلك أن مواقف إيران (الدولة الدينية الشيعية) من الحرب، وتعاطيها مع جرائرها والترتيبات التي أقيمت بعدها، والدور والنفوذ الكبيرين اللذين لعبتهما فيه، كلُّ ذلك جعل من أطروحة التقريب محل اشتباهٍ وتشكيكٍ من جديد، فالفكرة قامت ابتداءً بجهود المرجع الشيعي الإيراني تقي الدين القمّيّ، وغُرست ثمرتُها (دار التقريب) في بلاد الأزهر الشريف السنية، وقد كُتب العديد من المقالات من الطرفين لترسيخها، صدرت في ما بعد في مجلة ضخمة، ثم جُمّدت الدار نحو خمسين سنة، إلى أن عُقد اجتماع في القاهرة عام 2007، لمحاولة إعادة إحيائها، شاركت فيه محمد خاتمي الرئيس الإيراني السابق. فالفكرة بدت - نظريّاً - فكرة إيرانية شارك فيها رموز سنية كالشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في حينها. وعليه فإن أبرز ملامح المحنة أن إيران نفسها راعية المشروع لم تقم بجهود «ملموسة» تؤكد صدقية هذه الأطروحة أو جديتها، ولذلك ألقى الكثيرون بالتبعة عليها وعلى نفوذها في العراق الذي بلغت فيه العلاقة السنة - الشيعية مبلغاً دمويّاً!.
إلا أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل انضم إليه كلام كثير حول حقيقة الموقف الشيعي من «المقاومة العراقية» بالمقارنة مع «المقاومة اللبنانية»، الأمر الذي أضفى مزيداً من الاشتباه والالتباس، وصولاً إلى الصراعات السياسية اللبنانية التي انتهت بغزو «حزب الله» لبيروت لفرض مطالبه السياسية والطائفية.
هذا المشهد العصيب بكل أبعاده، ربما حمل على الاعتقاد بصواب المواقف القديمة المشكِّكة في جدّيّة الأطروحة، كموقف الإمام محمد زاهد الكوثري شيخ الإسلام في المشيخة العثمانية مثلاً، ومن بعده التيار السلفي عامة وآخرون. بينما نرى بالمقابل القفز على هذا الواقع ليقول الشيخ محمد علي التسخيري (الأمين العام لمجمع التقريب - طهران) عام 2003: «إن ما جرى من تعدٍّ خلال تاريخنا الطويل، ناشئ عن عدم الالتزام بقواعد الحوار المطلوبة»، وهكذا جعل المسألة مسألة «أخلاقية» أو «آداب حوار»!.
وفي الواقع التاريخي، لم تكن هذه أول محنة لهذه الفكرة، فقد شهدت الأطروحة تراجعاً عنها أكثر من مرة، وكانت هناك رموز تاريخية سارت في ركب التقريب وقدمت فيه جهوداً كبيرة ثم تَكَشّف لها عدمُ جديته أو فاعليته فتراجعت عن الفكرة، وكان من بينهم الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي عضو جماعة كبار العلماء بمصر، والمفكر الإسلامي د. محمد البهي، والعالم د. مصطفى السباعي وآخرون، واليوم يكاد العلامة د. يوسف القرضاوي ينضم إلى ذلك الركب وهو الذي مضى في التقريب شوطاً بعيداً وعمراً مديداً.
والمطلوب من زعماء التقريب اليوم أمران: أولهما: أن يعيدوا اكتشاف مدى جدية هذه الأطروحة ولماذا تفشل عند الاختبار العملي؟ وثانيهما: أن يدرسوا تلك التراجعات التي حصلت عبر التاريخ بجدية، ويعرفوا ملابساتها، والسياقات التي جاءت فيها وأين الخلل؟.
وفي تقديري أن الخلل الآن في ظل دولة ولاية الفقيه يعود إلى الأطروحة نفسها من جهتين: الأولى جهة السياق، والثانية جهة المفهوم نفسه.
ففيما يخص الجهة الأولى: بدا لي أن الأطروحة نفسها هي أطروحة استراتيجية كان الهدف منها تحقيق الاعتراف بالمذهب الشيعي داخل الفضاء السني الشاسع، وإلا فما معنى أن تقوم الأطروحة ومشروعها في مصر التي لا يوجد فيها شيعة أصلاً، وعليه فلا توجد مشكلة تقارب أو تباعد سني - شيعي! وكان الأولى أن يتم إحياؤها في بغداد أو بيروت مثلاً، بخاصة مع وجود النفوذ الإيراني الكبير فيهما.
ويبدو أن هذا هو المعنى المضمر في تلك التراجعات التي حصلت عبر التاريخ من بعض رموز الأطروحة بعد أن خاضوا فيها. ويبدو أن ثمة شعوراً قويّاً لدى الكثير من أهل السنة الآن أن التقريب المطلوب هو من جانب السنة فقط، فعلى سبيل المثال، كلما تحدث أحد من علماء الشيعة عن التقريب يذهب ويستشهد أو يستقوي بفتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري وعدِّه مذهباً خامساً يضاف إلى المذاهب السنية الأربعة، لكن لا أحد يقول لنا: بماذا أفتى الشيعة بالمقابل؟ وحين سألتُ السيد محمد حسين فضل الله (خلال برنامج الشريعة والحياة بتاريخ 18-11-2007) هل يجوز التعبد بالمذهب السني عند الشيعة؟ لم يُجب وراح يتحدث عن المشترك بين السنة والشيعة، وعن الاجتهاد الفقهي، وعن الخطوط الاجتهادية، ولم يتجرأ على إصدار فتوى مقابلة، على رغم أنه سُئل هذا السؤال ثلاث مرات في تلك الحلقة نفسها، وفي كل مرة كان يتكلم في العموميات!
فالفكرة غدت فكرة مسيسة، سواء من إيران التي رأت أنها «دولة الشيعة» في العالم ولها واجب المرجعية والولاية، أم من الدول التي فيها كثافة سكانية شيعية فدخلت في عملية التقريب لقطع الطريق على اللعب بالورقة الشيعية. على حين أننا نجد في التاريخ - قبل نشوء «دولة شيعية» وقبل ميلاد دار التقريب - ممارسات تقريبية ناجحة بامتياز، وقد حكى ابن كثير عدداً من تلك الممارسات في تاريخه، منها مثلاً أحداث عام 442هـ التي قال فيها: «اصطلح الشيعة والسنة ببغداد، وذهبوا كلهم لزيارة مشهد علي ومشهد الحسين، وترضوا في الكرخ على الصحابة كلهم وترحموا عليهم»، في حين أننا لا نجد إنجازاً ذا قيمة لأطروحة التقريب التي مضى عليها عقود وتوفر لها نخب وإمكانات واجتماعات!
أما الجهة الثانية وأعني بها الخلل من جهة المفهوم نفسه، فأطروحة التقريب كانت - ولا تزال - يكتنفها الكثير من الالتباسات والضبابية بحيث لا يمكن الإمساك بمفهومها بدقة، ولذلك فإن معظم الكتابات التي قُدمت فيها تعرّفها بالنفي لا بالإثبات، ومرة باسم التقريب، وأخرى باسم الوحدة، وثالثة باسم التعايش، إلى غير ذلك. وقد بقي خطاب التقريب يدور في فلك «أدبيات الخلاف والحوار»، وأن المشترك بين الفريقين أكثر من المختلف فيه، وأن بعضهم يريد تحويل «فقه الاختلاف» إلى «فقه ائتلاف»، وأن الظروف الآن توجب التقريب، ما يعني أن خطاب التقريب لا يزال يراوح مكانه منذ سنين إن لم يكن عقوداً!
والأهم هنا، أن أدبيات التقريب كانت مسكونة في كثير من الأحيان بهاجس الخوف من توحيد معتقدي الفريقين، وغالباً ما كان ينضم إلى ذلك الخوف من أن يكون هذا «التقريب» مدخلاً لشرعنة «التبشير» بمعتقد كلٍّ من الطرفين بين صفوف الآخر، وهو ما وجدناه في كتابات كل من الشيخ محمد مهدي شمس الدين ود. محمد سعيد رمضان البوطي ود. يوسف القرضاوي عام 2003 على الخصوص، وهم جميعاً من رموز الاعتدال.
بل أكثر من ذلك، فقد اعتبر الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله أن التبشير الذي يقوم به أي من الفريقين في ديار الآخر يضاد «الوحدة»، بينما اعتبره د. البوطي ينافي مبدأ «عدم العصبية» الذي يحافظ على نسيج الأمة الإسلامية الواحدة، وكما أنه كتب عام 2003 أنه في شمال سورية وجنوبها أناس حُملوا على التشيع بوسائل شتى، وبحث هو وتتبع: هل حصل العكس؟ فلم يجد! وجاء القرضاوي في تلك السنة نفسها واعتبر أن التبشير ينافي «فقه الموازنات».
وهذا كافٍ في بيان أن تصريحات القرضاوي الأخيرة، ليست مفاجئة، ولا معزولة عن الواقع التاريخي، بل لقد كان واضحاً في مؤتمر التقريب الذي عقد في قطر عام 2007 الذي كان مؤتمر «المصارحة والمكاشفة» بامتياز ولأول مرة، بعيداً من المجاملات التي وسمت المؤتمرات الكثيرة السابقة على مدى عقود. والسبب في ذلك يعود إلى أن المؤتمرات السابقة كانت تدور حول عالم الأفكار والتصورات، وأن التقريب كان يتم في الجلسات وعلى الأوراق فقط، لكن الجديد في مؤتمر الدوحة أنه جاء مثقلاً بوطأة الوقائع والأحداث، بل والدماء التي سالت تحت لافتات مذهبية وبالاستناد إلى الانتماءات الطائفية، وفي ظل هيمنة شيعية (عراقية وإيرانية) على السلطة في العراق المحتل، الذي اعتُبر نموذجاً للدراسة، وامتحاناً لفكرة التقريب وجدّيتها، وهو ما دفع د. القرضاوي في جلسة الافتتاح إلى القول بوضوح: «فكرة التقريب على المحك، وتواجه امتحاناً كبيراً، إما أن تنجح وتؤتي أكلها، وإما أن نفضّ السيرة».
لكن المستغرب، هو موقف كلٍّ من الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني والشيخ محمد علي التسخيري، فالأول اعتبر في حواره مع القرضاوي عبر الجزيرة عام 2007 أن التبشير الشيعي هو من باب «فعل الخير»، بينما اعتبره الثاني من باب «التبليغ»، ومعناه أنه وظيفة النبوة!
وفي الواقع أن هذا الموقف الإيراني هو استمرار قديم لمشروع «تصدير الثورة الإسلامية» ليس بمعناها التحرري، بل بمعناها الأيديولوجي، فهو يوظف التشيع السياسي في التشييع العقدي لكسب مناطق نفوذ جديدة لإيران، دولة عقيدة ولاية الفقيه التي ظهر حسن نصر الله في خطابه أخيراً يجاهر بها مفتخراً! ومن ثم فإن هذه الأيديولوجيا الأصولية مشكلتها مزدوجة: مشكلة عقدية دينية، وسياسية وطنية، وهنا مصدر فتنتها وضررها على وحدة الأمة، إذ من شانها أن تحوّل الولاء من رباط المواطنة إلى رباط الطائفة أولاً، ثم من رباط المدني إلى رباط الديني الذي يتجسد في ولاية الفقيه الإيراني ثانياً.
وهنا في هذه «الخلطة» يكمن السر في التعاضد أو التلاحم العضوي بين تنظيم الإخوان المسلمين وبين إيران، وهو ما يفسر لماذا جاءت تصريحات مرشد الإخوان ونائبه مخالِفة لموقف القرضاوي، فدولة ولاية الفقيه التي قامت عام 1979 هي النموذج الذي حلم به الإخوان المسلمون واستبشروا بقيامه، كما أن الفارق الرئيس بين نظرية التشيع السياسية ونظرية التسنن السياسية أن النظرية الشيعية تعتبر مسألة الإمامة (السياسة) من أصول الاعتقاد، وينبني عليها إيمان وكفر، بخلاف النظرية السنية التي تعتبر الإمامة من مسائل الفروع وليست من أصول الاعتقاد، وهذه هي النقلة التاريخية التي أحدثها الإمام البنا في التاريخ السني حين اعتبر مسألة السياسة من أصول الاعتقاد فتوافق مع النظرية الشيعية، وتجاوز موروث كتب الاعتقاد السنية الأشعرية.
إن هذا التاريخ يبين بوضوح أن منطق الردود العنيفة على تصريحات القرضاوي الأخيرة، المنطق القائل: إن التوقيت غير مناسب، منطق معزول وغير واعٍ بهذا المسار، فمنطق القرضاوي منطق منسجم ومتسق مع ذاته ومع شرط عملية التقريب التي مشى فيها وهو وقف التبشير من الطرفين، بل يؤيده فيه الشيخ مهدي شمس الدين رحمه الله.
في حين أن الردود الإيرانية أو المحسوبة عليها، شديدة التشنج من أي نقد في هذا الخصوص، فمثلاً حين دعا القرضاوي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة إلى وقف محاولات تشييع السنة، واتهم الجانب الشيعي بعدم السعي للقيام بمبادرة للتقريب مع الجانب السني، راح التسخيري في الجلسة نفسها يطالب السُّنة بـ «وقف عمليات التبشير السني»، وبالتوقف عن وصف الشيعة في إيران بـ «الصفويين» أو «القرامطة الجدد» أو «تكفيرهم، وأن يكون القتل على الهوية»، واصفاً إيران بأنها «عدو وهمي» للسنة! وكذلك الأمر حين علق على تصريحات القرضاوي الأخيرة واعتبرها «تدعو إلى الفتنة»، وذهب البعض الآخر إلى اعتبارها «تصريحات طائفية».
هذا التشنج (والتسخيري مجرد مثال) يجد تفسيره في الوظيفة الاستراتيجية التي تقوم بها أطروحة التقريب بين المذاهب، كما شرحناها، لأنه لا يخفى أن التبشير الشيعي (والسني كذلك) هو في حد ذاته فتنة يجب تجنبها، وليس انتقاده هو الفتنة! ثم إن هذا التحزب ضد أي نقد لممارسات إيران - و «حزب الله» تبعاً - يستبطن عقيدة العصمة التي تتنافى مع البشرية، تارة باسم «وحدة الأمة» التي غدت لوناً من ألوان الابتزاز لكمّ الأفواه، وأخرى باسم «الطائفية» وثالثة باسم أن «التوقيت غير مناسب».
وفي الواقع أن هذه الثلاثة نفسها تُحطمُها ممارسات التبشير الشيعي التي تواتر الحديث عنها هنا وهناك، كما أن التساؤل حول مفهوم «الطائفية» أمر أصبح شديد الأهمية، إذ ماذا تحمل ممارسات التبشير من معنى سوى الوظيفة الطائفية وتكثير الطائفة؟! وما دلالة هذا التحزب ضد أي نقد للسلوك الإيراني أو التبشيري سوى أنه لون من ألوان الطائفية؟! تأمل الردود العنيفة على القرضاوي والتي تفوح منها رائحة الطائفية البغيضة التي تجعل التبشير الشيعي من «معجزات آل البيت» وأن أي نقد لشيعيٍّ هو عداء لآل البيت! بل إن الحساسية المفرطة في التعاطي مع المسألة السنية - الشيعية تبرهن بوضوح على أن الحس الطائفي يسكن العقول والقلوب!
إن فشل أطروحة التقريب ليبدو كذلك من ملاحظة القضايا التي طُرحت خلال المؤتمرات كافة، فبعيداً عن الكلام المعسول في أهمية الوحدة، والأمة الواحدة، وتقبل الاختلاف، والتآخي، كان هناك دوماً حديث عن قضيتين اثنتين: عدم التبشير المذهبي من قبل الطرفين، وعدم سبّ الشيعة للصحابة، ثم جاءت أحداث العراق فأضافت قضية ثالثة وهي: وقف القتل المذهبي! وهذا كله لم يتحقق في ظل وجود دار للتقريب ودولة شيعية، ولكنه - وللمفارقة - وقع تاريخيّاً مرات عدة قبل هذا التاريخ!
إن واجب الوحدة ودرء الفتنة واجب على الجميع من دون تمييز، كما أن السعي إلى تصدير نموذج ولاية الفقيه، ستكون آثاره كارثية على مجتمعاتنا، لأنه يعني أن الدولة الدينية ستذهب بأنفاسنا، ولأنه يعني انتكاسة في مجال الإصلاح والتجديد الذي نسعى إليه منذ عقود، كما أن المنطق القائل بأن أي نقد من شأنه أن يُضعف المقاومة أو يجلب التمدد الصهيوني أو الأميركي منطق مزيف قد جربناه مع أنظمة دامت عقوداً، حرّمت علينا النقد لأنها كانت تكافح الاستعمار وتخوض معارك التحرير التي لم تحصل بعد ولا أمل بحصولها تحت رعايتها!
ويبقى التساؤل ماذا بعد فشل أطروحة التقريب؟
لا شك في أن العداء والشحن الطائفي لا يُجْدِيان شيئاً سوى أنهما يُدخلانِنا في دائرة مغلقة، ومن مهمتنا وواجبنا الوعي بجملة من الأفكار والكليات الشرعية التي يجب مقاومة تغييبها في ظل سيادة منطق المقاربات الطائفية، وهي أن الاصطفافات الطائفية تودي بكلية من كليات الشريعة وهي وحدة الأمة، وأن الإغراق في المذهبية من شأنه أن يلغي فكرة عالمية الإسلام، وأن الانتماء المذهبي يجب أن لا يتحول إلى انتماء قبَلي يستبيح كل المحرمات والقيم الدينية المتوافرة في كل المذاهب الإسلامية.
.......
- نقلا عن موقع دار الحياة



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين