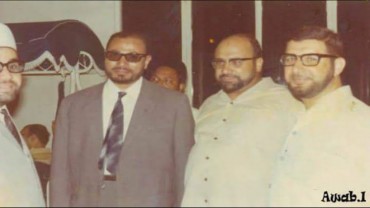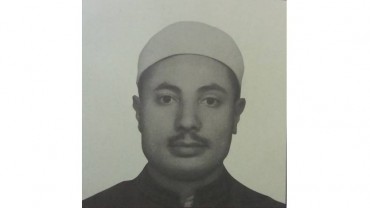د. يوسف القرضاوي
بعد صغائر المحرمات تأتي الشبهات، وهي ما لا يعلم حكمه كثير من الناس، ويشتبهون في حله وتحريمه، فهذه ليست كالمحرمات المقطوع بها.
فمن كان من أهل الاجتهاد وأداه اجتهاده إلى رأي في إباحتها أو تحريمها فعليه أن يلتزم به، ولا يسوغ له أن يتنازل عن اجتهاده من أجل خواطر الآخرين، فالله إنما يتعبد الناس باجتهاد أنفسهم إذا كانوا أهلا لذلك، ولو كان اجتهادهم خطأ فهم معذورون فيه، بل مأجورون عليه أجرا واحدا.
ومن كان من أهل التقليد وسعه أن يقلد من يثق به من العلماء، ولا حرج عليه في ذلك ما دام قلبه مطمئنا إلى علم مقلده ودينه.
ومن اضطرب عليه الأمر، ولم يستبن له الحق، كان الأمر شبهة في حقه ينبغي أن يتقيها استبراء لدينه وعرضه كما جاء في الحديث المتفق عليه: "إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه".
ويجب على الجاهل في الأمر المشتبه فيه أن يسأل فيه العالم الثقة، حتى يقف على حقيقة حكمه منه، قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، وفي الحديث: "ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال".
والناس في موقفهم من الشبهات جد مختلفين، نظرا لاختلاف أنظارهم من ناحية، ولاختلاف طبائعهم من ناحية، واختلاف مواقفهم من الورع وغيره، فهناك الموسوسون الذين يبحثون عن الشبهات لأدنى ملابسة حتى يجدوها، كالذين يشككون في الذبائح في بلاد الغرب لأوهى سبب، ويفترضون البعيد قريبا، وشبه المستحيل واقعا، ويظلون يسألون حتى يضيقوا على أنفسهم ما وسع الله عز وجل، والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) وليس المسلم مطالبا بهذا التدقيق.
وفي الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. قال: "سموا الله عليه وكلوا"، أخذ الإمام ابن حزم من هذا الحديث قاعدة: أن ما غاب عنا لا نسأل عنه.
وقد روى أن عمر رضي الله عنه مر في طريق فوقع عليه ماء من ميزاب، وكان معه رفيق، فقال هذا الرفيق: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا فقد نهينا عن التكلف.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أو في المسجد، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"؛ ومن هذا أخذ العلماء قاعدة: أن اليقين لا يزال بالشك، وأنه يعمل بالأصل، ويطرح الشك، وهذا قطع لدابر الوسوسة.
وقد أجاب الرسول الكريم دعوة يهودي، وأكل طعامه ولم يسأل: أهو حلال أم لا؟ وهل آنيته طاهرة أم لا؟ وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب عليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها، وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة (قربة) مشركة.
وفي المقابل من أجاز ذلك وجد من تشدد مستدلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب، الذين يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر، فقال: "إن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها".
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض، والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.
قال العلامة ابن رجب: ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام، فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا، أو شيئا لا يعرف، واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرم؟ على وجهين.
وإن كان أكثر ماله الحلال، جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
وإن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركه، قال سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إلي، وقال الزهري ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه، ولكنه علم أن فيه شبهة، فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد في رواية حنبل، وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روى عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روى عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضى من الربا والقمار، نقله عنه ابن منصور.
وقال الإمام أحمد في المال المشبته حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرا، أخرج منه قدر الحرام، وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا، فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير، ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي.
ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، كما تقدم عن مكحول والزهري، وروى مثله عن الفضيل ابن عياض.
وروى في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه ويدعوه إلى طعام، قال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه، وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، فقال: أجيبوه، وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روى عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب.
وبكل حال، فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام، لما عنده من ذلك من مزيد علم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان:
أحدهما: من يتوقف فيها، لاشتباهها عليه.
والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه، ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، ويكون مأجورا على اجتهاده، ومغفورا له خطؤه لعدم اعتماده.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام" قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو من لا يعلمها.
فأما من كان عالما بها، واتبع ما دله علمه عليها، فذلك قسم ثالث، لم يذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس، واتبع علمه في ذلك.
وأما من لم يعلم حكم الله فيها، فهو قسمان:
أحدهما: من يتقي هذه الشبهات، لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى "استبرأ": طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد: "أن من وقى به المرء عرضه، فهو صدقة".
القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة، لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر، فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك، كان تركها حينئذ استبراءا لعرضه، فيكون حسنا، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية: "إنها صفية بنت حيي"، وخرج أنس إلى الجمعة، فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا، ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: "من لا يستحي من الناس، لا يستحي من الله".
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال، إما باجتهاد سائغ، أو تقليد سائغ، وكان مخطئا في اعتقاده، فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان الاجتهاد ضعيفا، أو التقليد غير سائغ، وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى، فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه.
والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، وهذا يفسر بمعنيين:
أحدهما: أنه يكون ارتكابه للشبهة ـ مع اعتقاده أنها شبهة ـ ذريعة إلى ارتكابه الحرام ـ الذي يعتقد أنه حرام ـ بالتدريج والتسامح، وفي رواية في "الصحيحين" لهذا الحديث: "ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان".
والمعنى الثاني: أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده، لا يدري: أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام.
والله عز وجل حمى هذه المحرمات، ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، فكذلك من تعدى الحلال، ووقع في الشبهات، فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض، ويقع فيه، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا.
وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبدالله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس"، وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد، حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال، خشية أن يكون حراما، حجابا بينه وبين الحرام.
وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام.
وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، وروى عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها.
وقال ميمون بن مهران: "لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال".
وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه.
وهنا ينبغي أن يعامل كل إنسان في حدود مرتبته، فمن الناس من لا ينكر عليه الوقوع في الشبهات، لأنه غارق في المحرمات وربما في كبائرها، والعياذ بالله، كما يجب أن تظل الشبهة في رتبتها الشرعية، ولا نرفعها إلى رتبة الحرام الصريح أو المقطوع به، فإن من أخطر الأمور تذويب الحدود بين مراتب الأحكام الشرعية، مع ما جعل الشارع بينها من فروق في النتائج والآثار.
....................
* من كتاب "في فقه الأولويات.. دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة" لفضيلة العلامة.
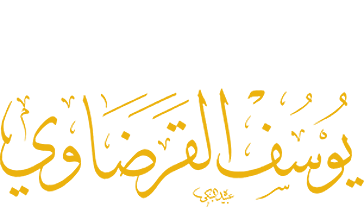
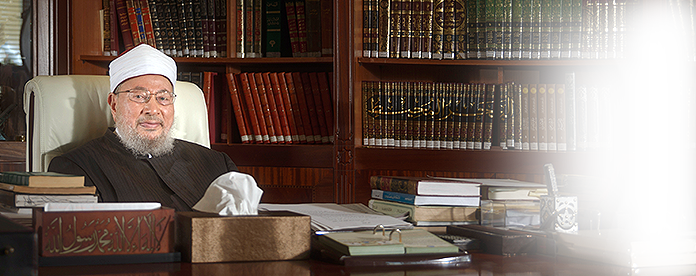

 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين