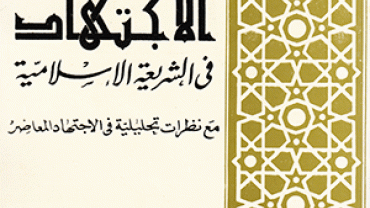السؤال: دار حوار طويل في المجلات الإسلامية، حول جواز نقل مقام إبراهيم من مكانه الحالي إلى مكان آخر داخل المسجد الحرام نفسه… لأن المطاف الحالي حول الكعبة يزدحم بالطائفين ازدحاما شديدا أيام الحج، ويراد توسعة المطاف… وإذا اتسع المطاف شملت دائرته مقام إبراهيم… ويراد نقل المقام إلى مكان آخر ليخلص المطاف الجديد من كل عائق… فهل في هذا مانع شرعي؟ نرجو البيان.
جواب فضيلة الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
قبل أن نبدي الرأي في هذا الموضوع، نذكر كلمة تبين المراد بمقام إبراهيم:
أولا: روى أن إبراهيم عليه السلام قدم مكة فاستقبلته زوجة ابنه إسماعيل، وأرادت أن تصب له الماء ليغسل رأسه، فقدمت له حجرا وضع عليه رجله اليمنى، ومال إليها بشق رأسه فغسلته له… ثم حولت الحجر إلى الناحية الأخرى فوضع عليه رجله، ومال إليها بشق رأسه الآخر فغسلته له. هذا الحجر هو الذي سمي فيما بعد: "مقام إبراهيم".
ثانيا: وروى آخرون أن إبراهيم عليه السلام كان يبني الكعبة، وإسماعيل يناوله الحجارة فلما ارتفع البناء عجز إبراهيم عن رفعها، فاتخذ حجرا قام عليه ليتسنى له ذلك، واستمر في البناء… وقالوا بعد تقرير هذه الرواية: إن هذا الحجر هو "مقام إبراهيم" وهو الذي اختاره أكثر العلماء.
ثالثا: قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحج كله مقام إبراهيم… فالوقوف بعرفة مقام إبراهيم، ورمي الجمار مقام إبراهيم، والطواف والسعي وغير ذلك من المناسك كلها مقامات إبراهيم… وهو كلام طيب صادر عن ذهن مشرق، وفقه أصيل.
ومقامات إبراهيم عليه السلام هي مواقفه التي أدى بها لله في وادي مكة حقه كاملا، إذ هاجر إليها بابنه، وإذ بنى البيت لله بأمره، وإذ قدم ولده للذبح. إلى آخر ما هو معروف من سيرته عليه السلام… وهذا الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة أحد هذه المواقف، ويطلق عليه لذلك اسم "مقام إبراهيم". وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى ركعتين. قرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل يا أيها الكافرون).
وكان الحجر أول أمره ملتصقا بجدار الكعبة بحكم قيام إبراهيم عليه لبنائها، وظل كذلك أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيام أبي بكر رضي الله عنه، وطائفة من أيام عمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن الحجر يعوق الطواف بعض الشيء، وأنه لا يمكن الناس من جدار البيت، وأن الطائفتين مع ذلك يشوشون أثناء طوافهم على الذين يصلون عنده ركعتي الطواف، فأمر عمر رضي الله عنه بنقله من مكانه إلى جهة الشرق حيث هو الآن. (أي قبل نقله منذ سنوات).
واليوم قد اتسع المطاف حول الكعبة، ودخل الحجر المذكور أو "مقام إبراهيم" في المطاف مرة أخرى، وسيشوش الطائفون -بطبيعة الحال- أثناء طوافهم على من يصلون عنده ركعتي الطواف، وكذلك سيعوق المقام طواف الطائفين بعض الشيء، وحينئذ نجد أنفسنا مضطرين إلى التفكير فيما فكر فيه عمر رضي الله عنه: هل ننقل المقام للضرورة كما نقله رضي الله عنه للضرورة؟
وهنا يذهب الورع بفريق منا فيقول: أين نحن من عمر؟ إن عمر فعل ما فعل، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله يرون فعله، ويقرونه عليه، ولم يحفظ أن أحدا منهم عارضه، فكان ذلك إجماعا تلقته منهم الأمة بالرعاية جيلا بعد جيل إلى اليوم، فلا يجوز لنا أن نغير وضعا رضيه الصحابة لمقام إبراهيم وظل عليه -على رغم ما تعرض له البيت من أحداث جسام- فلم يمسسه أحد بتغيير إلى الآن...
وهو قول جميل وغيرة محمودة، ولكنا نحب أن نقول: إن عمر رضي الله عنه، نقل المقام لعلة ظاهرة، وضرورة واضحة، ووافقه الصحابة على ما رأى. والعلة اليوم هي العلة بالأمس، فهل إذا كان عمر اليوم حيا وعرضت له علة اليوم أكان يتحرج أن ينقل المقام مرة أخرى كما نقله بالأمس؟
أليس من حقنا بداهة أن نأتسي بالصحابة، فنفعل فيما يعرض لنا من ضرورات مثل فعلهم عندما عرضت لهم نفس هذه الضرورات؟
إن المطاف ضيق بلا شك، وكل من سعد بالحج يذكر ما عانى من الزحام والضيق، ويذكر حرج النساء في ضغطة الزحام، وما يتعرض له من الدفع والرد… ويذكر أن الهرولة في الطواف، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تكون معطلة من شدة الزحام… ولا شك أن ديننا السمح يرحب بتوسيع المطاف تيسيرا للطائفين، ولرفع الحرج عن المحرجين، وتحقيقا لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من الهرولة.
ولكن هذا الفعل الجميل، سيعترضه المقام إذا بقي مكانه، وإذا بقي المقام مكانه ألقينا أنفسنا بإزاء مفسدة متوقعة لا محالة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) والطواف في المطاف الجديد سيعطل أمر الله بالصلاة، أو سيجعل صلاة المصلين -على الأقل- خالية من روح الخشوع والطمأنينة، وكلا الأمرين مفسدة لا يقرها الشرع إلا دفعا لمفسدة أشد وأكبر. ولا يستطيع أحد أن يدلنا على وجه الفساد الذي يلحق المناسك بنقل المقام إلى موضع آخر.
ويجب أن نذكر أمرين لهما شأنهما:
الأول: أن عمر رضي الله عنه نقل الحجر وهو ملتصق بجدار الكعبة، وهو وضع له هيبته، فأبعده عنها، وليس في فعلنا اليوم شيء من ذلك.
والأمر الثاني: أن عمر إذ أقدم على نقله، إنما نقله من المكان الذي وضعه فيه إبراهيم بيده، وقام عليه فيه بالبناء، فغير وضعا تحفه ذكريات مقدسة، ووضع مقام إبراهيم في غير مقام إبراهيم.. وليس في فعلنا اليوم شيء من ذلك.
ذلك كله إلى أن الموضع القديم للحجر كان معروفا للناس بأنه "مقام إبراهيم" من قبل أن ينزل قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فلما نزل هذا القول الكريم لم يكن له من مفهوم في أذهان الناس إلا مكانه الملتصق بالكعبة. روى جابر وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف ومر بالحجر، قال له عمر رضي الله عنه: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم، قال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا قليلا حتى نزل قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
ومن هذا يعلم أن الآية الكريمة حين سمت هذا المكان "مقام إبراهيم" لم تسمه إلا وهو معهود في أذهان الناس بشارات وحدود معينة… وحين أمرت بالصلاة، أمرت بها في المكان المعهود لهم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وصلى الصحابة والناس من بعدهم بصلاته عليه السلام فيه… ومعنى هذا كله أن عمر إذ نقل الحجر، إنما نقله من المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية الكريمة به… ولا شك أننا إذ ننقله اليوم، لا نغير مدلولا لابسه الوحي حين نزوله، ولا نصرف الناس عن مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يباح لنا ما أبيح لعمر؟
وهناك أمر أخير يجب أن نذكره في هذا المقام، ذلك أن العرب في الجاهلية حين أعادوا بناء الكعبة، قصرت بهم النفقة، فلم يبنوها على مساحتها وأسسها الأولى، ثم رفعوا بابها بعد أن كان ملتصقا بالأرض إلى العلو الذي هو عليه اليوم، وظل الجزء الذي تركوه من مساحتها منكشفا، وهو الذي يسمى اليوم: "الحجر" بكسر الحاء.
روى مسلم عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: "نعم".
قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟
قال: "إن قومك قصرت بهم النفقة".
قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟
قال: "فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا".
وكان عليه السلام يريد أن يهدم الكعبة، ويدخل فيها الجدر أو الحجر، ويعيد بناءها على أسسها الأولى، أسس إبراهيم عليه السلام، التي أخبر بها القرآن الكريم، لولا أنه خشي أن تتغير قلوب بعض الناس، لقرب عهدهم بالجاهلية، فينكروا ما صنع، وذلك قوله عليه السلام لعائشة: "يا عائشة، لولا حداثة عهد قومك بالكفر، لنقضت الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم" وفي رواية أخرى: "لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألزق بابه الأرض".
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الجاهلية قد غيرت، وبدلت في صميم أوضاع الكعبة -وهي ما هي في القداسة والحرمة- فلا يرى في هذا التغيير إلا أنه تغيير لأوضاع حسية، لا يمس عقيدة من العقائد، ولا يغض من قداسة المعنى الرمزي الذي يتحقق به للكعبة أنها "بيت الله"… فهي "بيت الله" سواء كان بابها ملتصقا بالأرض أو مرتفعا عنها… وهي "بيت الله" سواء شملت أركانها المساحة الأولى أو ضمت بعضها فقط… وسماها رسول الله "بيت الله" على رغم ما بها من تغير… ونزل الوحي يقرر أنها "بيت الله" على رغم ذلك أيضا، فإن ما بقي من أوضاعها كاف لأن يتمثل به المعنى الرمزي الدال على نسبتها إلى الله سبحانه.
وإذا، فقيمة الكعبة إنما هي في معناها الرمزي، وقدسية صلتها بالله… وما فيها من بركة لا يرجع إلى طبيعة حجارتها، ولا معدن بنائها، بل يرجع إلى ما يفاض عليه من جلال المعنى الروحي الذي يصله بالله سبحانه.
لهذا لم ير الرسول عليه السلام أن يبطل حتما ما غيرته الجاهلية بالكعبة من حيث أن المساس ببعض الأوضاع لا يتعلق بعقيدة من العقائد، ولا يسلخ عنها الأسرار التي صارت بها "بيت الله" فأبقى فعل الجاهلية على ما كان عليه، إبقاء على استقرار قلوب حديثة عهد بالجاهلية.
ونريد أن نقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعث لغير ما ألفته قلوب الناس من الوثنية الجاهلية، وعبادتها، ومعتقداتها، وعاداتها في الأنصاب والأزلام ونحوها وكم أبطل عليه السلام من ذلك، دون أن يبالي ما تنكر القلوب من فعله، ولو أنه خشي إنكار القلوب لما تقدم شيئا في رسالته… فلو أن لأوضاع الأركان والمباني قدسية ذاتية، أو حرمة متصلة بعقيدة ما لمضى رسول الله إلى ما يريد من إعادة الكعبة على أسس إبراهيم غير عابئ بما تنكر القلوب، ولكنه عليه السلام لم يفعل، وآثر الرفق بالناس في أمر غير ذي خطر.
ولا شك أن الحجر الذي هو مقام إبراهيم لا يبلغ في حرمته أن يكون مثل الكعبة قداسة ورعاية، فهي "بيت الله" وهي "أول بيت وضع للناس" وهي "الكعبة البيت الحرام" وليس حجر المقام في شيء من ذلك، فإذا لم نجد للرسول عليه السلام عزيمة في الاستمساكبالأوضاع الأولى لبيت الله، فأولى أن يكون هذا شأننا فيما هو أقل من البيت جلالة وقدسية..
ومما يرفع احتمال العزيمة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إعادة البيت على أسسه الأولى، قوله لعائشة في رواية مسلم: "إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك، أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي، أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا… فأراها قريبا من ستة أذرع". فقوله عليه السلام: "فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه" ينفي احتمال العزيمة، ويرد الأمر إلى مجرد الاختيار، أو يجعله على أحسن الوجوه من قبيل فعل الأفضل..
إن رسول الله ينظر إلى هذه الأمور على أنها ذات حقائق روحية، لا تتأثر بما يمس الشكل من تغيير لبعض هيئاته.. وبهذا النظر الكريم نظر عمر رضي الله عنه إلى حجر إبراهيم حين نقله من مكانه الأول إلى مكانه الحالي، دون أن يرى في ذلك ما يمس نسبته إلى إبراهيم عليه السلام، فهو مقام إبراهيم إذا كان ملتصقا بالكعبة، وهو مقام إبراهيم إذا اقتضت الضرورة إبعاده عنها بعض الشيء… وهو هو مقام إبراهيم؛ إذا نحن نظرنا إلى القيمة الروحية بمثل ما نظر إليها عمر، فنقلناه بحكم الضرورة كما نقله رضي الله عنه بحكم مثل هذه الضرورة، توسعة على الطائفين، وتوفيرا لدواعي الخشوع والسكينة لمن يصلون عنده… والله سبحانه وتعالى أعلم، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين