أعتبر نفسي بدأت الكتابة والتأليف متأخرًا نسبيًّا؛ ذلك أني كنتُ مشغولًا بالدعوة الشفهية، وبالخطاب الارتجالي، طوال المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية بالأزهر. فكنت أخطب وأدرّس وأحاضر ارتجالًا، إلا ما قد أعده من محاور ونقاط رئيسية في مذكرات خاصة.
ولم ينبهني أحد - ممن هم أكبر مني - أن لديّ ما يمكن أن يكتب ويحرر، وأن من المهم للداعية أن يستخدم القلم، كما يستخدم اللسان، وقد قال العرب قديمًا: القلم أحد اللسانين. وأقسم الله تعالى في كتابه الكريم بالقلم: {نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ} (القلم:1)، وكان من دلائل ربوبيته تعالى أنه: {ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ} (العلق:4)، ولعل هذا كان مما اختاره الله لي: ألا أبدأ الكتابة إلا بعد النضج سنًّا وتحصيلًا. والخير فيما اختاره الله جل ثناؤه.
ولقد كتبت بعض رسائل صغيرة أشرت إليها من قبل، مثل رسالة: «قطوف دانية من الكتاب والسنة»، ومثل: «رسالتك أيها المسلم» التي صودرت في المباحث العامة، ولم ترجع إليَّ، ومثل: «رسالتكم يا شباب الأزهر» التي نشرتها بعد بعنوان: «رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد»، ولكن الكتاب الذي أعتبره بدايةً حقيقيةً للتأليف، والذي دخلت به سوق الكُتّاب والمؤلفين؛ هو كتاب: «الحلال والحرام في الإسلام»؛ ولهذا الكتاب قصة يحسن بي أن أحكيها لقرائي هنا؛ لما فيها من فائدة وعبرة إن شاء الله.
لم يكن يخطر في بالي في سنة (1379هـ - 1959م) أن أكتب في أمر الحلال والحرام، بل كانت الكتابة في الفقه لا تحتل منزلة أولية عندي، وإن كنت قد بدأت شيئًا من ذلك فيما كتبته في مجلة «منبر الإسلام» من فتاوى وأحكام تحت عنوان: «يستفتونك» باسم: يوسف عبد الله، دون التوقيع باسمي الكامل: «القرضاوي»؛ لما يثير من حساسيات لدى جهات الأمن التي تقف بالمرصاد لأي نشاط لي ولأمثالي يتعلق بالجماهير.
وكانت كتابة هذا الباب بتوجيه من أستاذنا «البهي الخولي» مراقب الشئون الدينية في وزارة الأوقاف في ذلك الوقت، الذي لاحظ عقليتي الفقهية من مناقشاتي معه في الدروس واللقاءات الخاصة، ومع هذا لم أكن أنوي أن تكون بداية تأليفي في «الفقه»، ولكن هكذا قدَّر الله أن يكون أول كتاب حقيقي أدخل به ميدان التأليف العلمي هو: «الحلال والحرام في الإسلام» وهو كتاب فقهي، فكيف تم ذلك؟
إن لتأليف هذا الكتاب قصة طريفة جديرة أن تحكى، فقد وردت إلى وزارة الخارجية المصرية من بعض سفاراتها في أوروبا وأمريكا؛ أن المسلمين في تلك البلاد يحتاجون إلى كتب علمية ميسرة معاصرة في ثلاثين موضوعًا من الموضوعات حددوها، بعضها في العبادات، وبعضها في المعاملات، وبعضها في الآداب والأخلاق، وكان من هذه الموضوعات الثلاثين؛ موضوع تحت عنوان: «ما يحل للمسلم وما يحرم عليه».
وقد كتبت الخارجية المصرية مذكرة بالموضوعات المطلوبة إلى كل من مشيخة الأزهر في عهد إمامه الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، الذي أحال الموضوع برمته إلى الأستاذ الدكتور محمد البهي المدير العام لإدارة الثقافة الإسلامية بالأزهر في ذلك الوقت... وإلى وزارة الأوقاف المصرية باعتبارها المؤسسة الدينية الثانية في مصر، في عهد وزيرها الشيخ أحمد الباقوري. وكلفت الجهتان كلتاهما - إدارة الثقافة بالأزهر، ووزارة الأوقاف - عددًا من العلماء بالكتابة في تلك الموضوعات.
وكان الموضوع الذي كلفني به أستاذنا الدكتور محمد البهي رحمه الله؛ هو: «ما يحل للمسلم وما يحرم عليه»، وهو موضوع لم يخطر ببالي أن أكتب فيه من قبل. ولا سيما أن مفرداته مبعثرة في أبواب الفقه الإسلامي، ومن الصعب نظمها في عقد واحد؛ إلا على من شرح الله له صدره، ويسّر له أمره؛ ولهذا دعوت بما دعا به سيدنا موسى عليه السلام: {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي} (طه:25-26).
وكان أصعب شيء عليَّ هو نقطة البداية: من أين أبدأ؟ وكيف أبدأ؟ وفي ليلة من الليالي - وأنا مشغول بالموضوع - وفقت إلى تقسيم الموضوع، بما يشبه الإلهام، فقد انقدح في ذهني: أن أبدأ الباب الأول من الكتاب بمبادئ عامة في شأن الحلال والحرام، والباب الثاني يتناول: الحلال والحرام في الحياة الشخصية للمسلم بما يشمل المأكل والمشرب والملبس والزينة، والمسكن والكسب، والباب الثالث يتناول: الحلال والحرام في الحياة الأسرية، من الزواج وما يتعلق به، وعلاقة الآباء والأمهات بالأولاد، والعلاقة بذوي الأرحام، وما يتعلق بذلك من أمور التبني والتلقيح الصناعي وغيرها، والباب الرابع يتناول: الحلال والحرام في الحياة الاجتماعية والعامة للمسلم، بما يشمل المعتقدات والتقاليد والمعاملات، واللهو والترفيه، وعلاقة المسلم بغير المسلم، وما إلى ذلك.
وحينما هديت إلى هذا التقسيم؛ اعتبرتني قد وفقت إلى تأليف الكتاب، فما عليَّ إلا أن أبحث في هذه المفردات في مظانها من كتب الفقه -وخصوصًا الفقه العام- والحديث والتفسير، ونحوها، وهو ما هُديت إليه بالفعل، وجمعت مادة الكتاب من مظانها، وكتبت له مقدمة بينت فيها منهجي الذي اخترته ورجحته، وهو منهج يقوم على التوسط والاعتدال بين الغلاة والمقصرين، أو بين المتشددين والمتسيبين.
ومما أذكره هنا في هذه المناسبة: أني كنت أتردد كثيرًا على مكتبة الأزهر، التي هي أحد مباني الجامع الأزهر القديم، وكانت قريبة من مقر عملي في «المكتب الفني لإدارة الدعوة والإرشاد». وكانت مكتبتي الخاصة محدودة في ذلك الوقت، كان فيها: «نيل الأوطار» للشوكاني، و«سُبل السلام» للصنعاني، و«المحلي» لابن حزم، وغيرها، لكن كان ينقصها مصادر أصيلة لم أستطع شراءها، ودخلي محدود في ذلك الحين، فكان لا بد من الاستعانة بالمكتبات العامة، وأقربها إليَّ مكتبة الأزهر.
كان مدير المكتبة فضيلة الشيخ أبو الوفا المراغي، شقيق الأستاذ الكبير الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر، وأحد أفذاذ العلماء في زمنه، وكان الشيخ أبو الوفا رجلًا عالِمًا باحثًا، وكنت على مودة وصلة طيبة به، فلما رآني أتردد كثيرًا على المكتبة، وأجمع أمامي عددًا من المراجع كل يوم سألني: فيم تبحث هذه الأيام يا قرضاوي؟ قلت: أبحث في موضوع كُلفت به من مشيخة الأزهر، قال: وما هو؟ قلت: ما يحل للمسلم وما يحرم عليه، قال: وقعت في مَطَب يا قرضاوي، ودخلتَ امتحانًا عسيرًا دون أن تعرف!
قلت: أي امتحان؟
قال: هذا الموضوع نفسه كُلِّف بالكتابة فيه من قبل وزارة الأوقاف الشيخ فلان عضو هيئة كبار العلماء. فماذا تفعل في هذا الرهان؟
قلت له: يا فضيلة الشيخ، ما يدريك لعل الله سبحانه يضع سره في أضعف خلقه! لقد شرعت في الموضوع ولن أتراجع عنه، وما توفيقي إلا بالله.
ومرت الأيام، وقد فرغت من الموضوع في حوالي أربعة أشهر على ما أذكر، وقدمته بخط يدي في كشكول أو كراسة للأستاذ الدكتور محمد البهي؛ فما كان في قدرتي المالية أن أعطيه لمن يكتبه على الماكينة.
ولما كنت أمسك قلبي بيدي خوفًا على هذه النسخة المبيضة الوحيدة أن تضيع مني، كما ضاعت رسائل لي أخرى من قبل، ولم يكن التصوير معروفًا في ذلك الوقت؛ فقد احتفظت بمسودتها عندي؛ لأستفيد منها عند اللزوم، وأرسل الدكتور البهي مشروع الكتاب إلى الأستاذ الجليل محمد المبارك عميد كلية الشريعة في الجامعة السورية بدمشق، وأحد القلائل الذين يجمعون بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية العصرية، ويدركون ما يحتاج إليه المجتمع الغربي المعاصر ويلائمه من ثقافتنا الإسلامية؛ وهذا سر اختياره لمراجعة الكتاب.
كما أرسل بعض الكتب الأخرى إلى مراجعين آخرين، منهم: الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، وقد رد الأستاذ الزرقا الكتاب الذي أُرسل إليه بأنه دون المستوى المطلوب. قلت: ربنا يستر ولا يرد كتابي، وبعد مدة لم تطل أرسل الأستاذ المبارك إلى إدارة الثقافة، يثني على الكتاب، وينوّه بحسن أسلوبه وطريقة معالجته، وتوخيه للاعتدال فيما يختار من آراء، وقد تضمن تقريره بعض أسئلة واستفسارات أجبت سيادته عنها، وبعض مقترحات استجبت لبعضها، ولم أستجب للأخرى، مبينًا وجهة نظري في ذلك، وقد قبلها الأستاذ المبارك رحمه الله.
ومن اللطائف: أني حين لقيت الأستاذ المبارك بعد ذلك في إحدى زياراته للقاهرة في أيام الوحدة مع سوريا؛ أخبرني بقصته مع كتابي، قال لي: كنت أقرأ مسودة الكتاب، فيعجبني تناوله للموضوع، وبيان الحكم والحكمة، وربطه بتعاليم الإسلام العامة، فأقول في نفسي: هذا الشخص واعٍ فاهم لما يكتب، ولكن الغريب أنه غير معروف، وكان شقيقي مازن المبارك يحضّر الدكتوراه في جامعة القاهرة، فعاد يومًا إلى دمشق، فسألته: هل تعرف شخصًا اسمه يوسف القرضاوي؟
قال: كيف لا أعرفه، وكم صليت وراءه الجمعة في جامع الزمالك بالقاهرة؟ وهو كذا وكذا وكذا؟ وظل يعدد لي من مناقب القرضاوي ما لم أكن أعلمه.
قلت له: الآن زدتني اطمئنانًا إلى هذا الشخص الذي قرأت له ما عرفت به أني قد تعرفت على عالِم جديد له مستقبله إن شاء الله.
تسلمت الإدارة العامة للثقافة الإسلامية الكتاب، واختار الأستاذ الدكتور محمد البهي أحد المترجمين المعروفين ليبدأ في ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وكلما ترجم فصلًا أرسله إلى الإدارة ليراجع، ثم يشرع في الفصل الثاني وهكذا، وبعد مدة أعاد المترجم الفصل الذي ترجمه، ولم تقبل إدارة الثقافة هذه الترجمة، ورأت أن المترجم غير مؤهل لترجمة هذا النوع من الكتب؛ فسحبت مسودة الكتاب منه؛ بحثًا عن مترجم غيره.
ولما رأيت أن هذا الأمر قد يطول، خطرت لدي فكرة نشر الكتاب بالعربية، عسى أن ينتفع به قراؤها، وبالفعل بيضت المسودة التي عندي، وأعددتها للنشر، وسلمتها إلى دار عيسى الحلبي للطباعة والنشر، لتنشره ضمن كتبها، فسلمت الإدارة الكتاب للجنة المكلفة بمراجعة الكتب، وكانت برئاسة الشيخ طاهر الزاوي العالِم اللغوي الشرعي الليبي، الذي كان يعيش في مصر، وقد عُيّن مفتيًا للجمهورية الليبية بعد ذلك، وكان من المصححين معه الأخ الباحث الأزهري مصطفى عبد الواحد (د. مصطفى بعد) فأثنى على الكتاب خيرًا، وأوصت اللجنة بطباعته.
وصدر الكتاب بعد نحو ثلاثة أشهر في طبعته الأولى، وتسلمت - لأول مرة - حقوق تأليفه (60) ستين جنيهًا مصريًا، كانت بالنسبة لي ثروة لها قيمتها. وبدأت أوزع بعض النسخ من الكتاب هدايا إلى العلماء الذين أعرفهم ويعرفونني، وأول نسخة أهديتها إلى شيخنا الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، الذي تصفح الكتاب طويلًا، ومدحه بكلمات شجعتني، وسررت بها.
والنسخة الثانية ذهبت بها إلى الشيخ أبو الوفا المراغي مدير مكتبة الأزهر الذي كان قد قال لي: إنك دخلت امتحانًا عسيرًا دون أن تدري. وقلت له: هذا هو الكتاب الذي حدثتك عنه من قبل، فأخذه وقرأ فهرسه، وتصفح مقدمته، ونظر فيه طويلًا، ثم قال: لقد نجحت يا قرضاوي في الامتحان، ما أظن صاحبنا الذي حدثتك عنه، سيوفق إلى مثل ما وفقت إليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
والنسخة الثالثة، ذهبت بها إلى أستاذي الذي أحبه وأقدره: الشيخ الدكتور محمد يوسف موسى، أستاذ الفلسفة من قبل، وأستاذ الشريعة اليوم، الذي كان لا يمكن لأحد زيارته إلا بموعد سابق، ولكنه كان يستثنيني من هذه القاعدة، ويعزني كثيرًا، وسلمت إليه نسخة من الكتاب، وسألني عن سبب تأليف هذا الكتاب، فأخبرته بقصة تكليفي به من الأزهر، فقال: عجيب، هذا الموضوع كُلِّف به زميلنا الشيخ فلان عضو جماعة كبار العلماء، وقد كان محتارًا: ماذا يكتب في هذا الموضوع المبعثر المشتت؟ واقترحت عليه بعض الأشياء، ولكن ما أحسبه يهتدي إلى ما هداك الله إليه، بورك فيك يا يوسف، وقد علمت أن الشيخ الكبير كان قد أرسل مشروع كتابه إلى الأوقاف قبل أن يظهر كتابي، فلما ظهر الكتاب سحبه من الوزارة، ولم أر له أثرًا ولم أسمع له خبرًا بعد ذلك. ولله الفضل والمنة.
والنسخة الرابعة: سلمتها لفضيلة الشيخ أحمد علي الأستاذ بكلية أصول الدين، والذي اختارته الكلية مشرفًا على رسالتي للأستاذية «الدكتوراه». تصفح الشيخ رحمه الله الكتاب، وأطال التصفح فيه، ثم قال لي: لماذا بادرت بطبع هذا الكتاب ونشره؟
قلت له: حفظك الله، وما المانع في ذلك؟
قال: كان يمكنك أن تقدم هذا الكتاب باعتباره أطروحة أو رسالة للدكتوراه، وهو جدير بذلك، كل ما في الأمر بعض الجوانب الشكلية، كأن تهتم بذكر المراجع وتوثيقها، وهذا أمر سهل عليك.
قلت له: يا فضيلة الشيخ، أنا أريد أن أقدم للدكتوراه رسالة في موضوع أتعب فيه، ويكون من خصائصه كذا وكذا...
قال لي: يا عبيط، المهم أولًا أن تأخذ «رخصة» حتى يسموك: «الدكتور» يوسف القرضاوي، ثم ألف بعد ذلك ما تشاء.
ولقد تبين لي بعد ذلك صدق نصيحة الشيخ أحمد علي رحمه الله، حين رفض مشايخ بكلية أصول الدين كتابي الذي أعددته عن «الزكاة» لتكون رسالتي للدكتوراه، فقالوا: إن هذا فقه، وليس بتفسير ولا حديث، ولا يدخل في علوم القرآن ولا السنة.
قلت لهم: إنه يدخل في فقه القرآن، وفقه الحديث.
قالوا: هذا أقرب إلى كلية الشريعة منه إلى كلية أصول الدين، وكتب أحد المشايخ رحمه الله إلى الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود عميد كلية أصول الدين يعتذر إليه من عدم الإشراف على رسالتي عن «الزكاة»؛ لأن بها «آراء دينية خطيرة لا يستطيع أن يتحمل مسئوليتها».
وأخيرًا قَبلَ أحدهم أن يشرف على الرسالة بعد أن الزمني بحذف عدد من فصولها، وإخراجها من صلب الرسالة.
والنسخة الخامسة أهديتها لشيخنا البهي الخولي، الذي سُرَّ بظهور الكتاب سرورًا بليغًا، وقال: لن أحكم له أو عليه حتى أقرأه، أو أقرأ ما يكفي منه للحكم عليه. فلما قابلته بعد ذلك قال: هذا الكتاب صدق نبوءتي. قلت له: وما نبوءتك، حفظك الله؟
قال: اختلفت أنا والشيخ الغزالي بعد نشر قصيدتك: «السعادة» في مجلة «منبر الإسلام»، وكان من رأي الشيخ الغزالي ومعه بعض الحاضرين، أنك لديك قابلية أن تكون شاعرًا عظيمًا إذا تفرغت للشعر وأديت له حقه، وكان من رأيي أن يتفرغ القرضاوي للعلم أولى من تفرغه للشعر، وهب أنه بلغ مرتبة شوقي في الشعر، فالذي آمله إذا تفرغ للعلم أن يكون - إن شاء الله - فقيه العصر، وأحسب أن هذا الوليد الجديد «الحلال والحرام» يحمل البشارة بتصديق نبوءتي، وأدعو الله أن يحقق أملنا فيك، وألا يقطعك عن الطريق بأي آفة من الآفات.
والنسخة السادسة، كانت لشيخنا الشيخ محمد الغزالي مدير المساجد في ذلك الوقت، وقد تصفحها بسرعة، وقال: هذا نهج جديد في كتابة الفقه بروح الداعية. والنسخة السابعة، أهديتها إلى مدير مجلة الأزهر والعالِم والكاتب الأزهري الأستاذ الشيخ عبد الرحيم فودة.
ومما أذكره هنا: أن الأستاذ الشيخ عبد الرحيم فودة لقيني مرة في إدارة الأزهر بعد صدور كتاب: «الحلال والحرام» وقال لي: أود أن أهنئك يا شيخ يوسف على أمرين:
الأول: على منهجك الرائع، وأسلوبك السلس، وترجيحاتك الموفقة في كتابك: «الحلال والحرام».
والثاني: مخالفتك بصراحة لرأي شيخك وشيخ الأزهر الشيخ شلتوت في مسألة فوائد البنوك الربوية ونحوها. وهذه شجاعة قلما تتوافر إلا لمثلك.
قلت له: منهج الشيخ شلتوت هو التحرر من الجمود والتقليد، وأظنه لن يطالبنا بالتحرر من تقليد أبي حنيفة ومالك لتقليده هو. إني أعتقد أني وإن خالفت الشيخ شلتوت في بعض آرائه؛ فإني على منهج شلتوت في اتباع الدليل الراجح حيث لاح للباحث، والنظر إلى القول لا إلى قائله، فإن الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.
وأرسلت أربع نسخ إلى سوريا مع أحد الأخوة السوريين الذين يدرسون في مصر، لكل من الدكتور مصطفى السباعي، والأستاذ مصطفى الزرقا، والدكتور معروف الدواليبي، بالإضافة إلى الأستاذ محمد المبارك الذي نشرت خلاصة من تقريره في آخر الكتاب.
وقد كان صداه طيبًا عند الأساتذة الأربعة، حتى قال الشيخ الزرقا لتلاميذه: إن اقتناء هذا الكتاب فرض على كل أسرة مسلمة، والحق أن علماء الشام كانوا أكثر احتفاء بالكتاب من علماء مصر. وكان من مظاهر ذلك: أن الشيخ ناصر الدين الألباني خرَّج أحاديثه، وهذا لا يحدث عادة إلا للكتب التي لها قيمة علمية، كما أن الأستاذ الكبير علي الطنطاوي رحب به وزكاه، وقرر تدريسه في مادة «الثقافة الإسلامية» التي كان يدرسها في كليتي الشريعة والتربية بمكة المكرمة، على حين لم يأخذ الكتاب حقه من الاهتمام في مصر. ولعل ذلك لأني انقطعت عن مصر تسع سنوات لم يطبع فيها الكتاب داخل مصر.
وحين قدمت إلى قطر سنة 1961م وجدت الكتاب قد سبقني إلى قطر، وأوصله بعض المصريين إلى العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس قضاة قطر؛ ففرح به وأثنى عليه، ومهّد لي الطريق إلى لقائه، فالتقاني بحفاوة وتكريم بالغ؛ ولهذا أراد بعض شيوخ آل ثاني في قطر «الشيخ فهد بن عليّ» أن يطبع الكتاب ليوزعه مجانًا على أهل قطر، فطبعه المكتب الإسلامي في بيروت لصاحبه الشيخ زهير الشاويش، الذي لم أكن عرفته بعد، وأرسل كمية منه إلى قطر، وعرض الأخرى للبيع، واستمر ينشره بعد ذلك إلى اليوم.
ومن الطريف هنا: أن أخانا الشيخ مصطفى جبر - وهو أحد المصريين الذين وصلوا إلى قطر قديمًا مع الأستاذين كمال ناجي، وعليّ شحاتة - قرأ الكتاب فأعجب به إعجابًا شديدًا، فاستأذنني أن يرسل مجموعة من النسخ مع أحد الإخوة المسافرين إلى باكستان، فأرسل نسخة إلى العلامة أبي الأعلى المودودي، وعليها إهداء مني، ونسخة إلى جامعة البنجاب بلاهور، وأخرى إلى جامعة كراتشي.
وقد أرسل إليَّ الأستاذ المودودي يشكرني على إهداء الكتاب له، ويقول في رسالته: إني أعتز بهذا الكتاب، وأعتبره إضافة جليلة إلى مكتبتي، أما جامعة البنجاب فقد اهتمت بالكتاب اهتمامًا لم أكن أتوقعه، فقد تناولته إحدى طالبات الدراسات العليا في دراستها للماجستير ليكون البحث المكمل للحصول على درجة الماجستير، واسمها: جميلة شوكت - الأستاذة الدكتورة جميلة شوكت بعد ذلك - وقد أرسلت تطلب مني خلاصةً عن سيرتي الذاتية، وكانت رسالتها بإشراف العلامة الأستاذ الدكتور علاء الدين الصديقي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية، ومدير الجامعة بعد ذلك.
وكذلك حصل طالب آخر - لا أذكر اسمه - بجامعة كراتشي على الماجستير ببحث عن الكتاب. لقد اهتم أساتذة الجامعات في باكستان بالكتاب، حيث اعتبروه نهجًا جديدًا في كتابة الفقه الإسلامي بما يلائم روح العصر، وثقافة العصر، ولغة العصر، مع الحفاظ على الأصول، والاستمداد من التراث.
ومن الطرائف: أني حينما زرت باكستان، وزرت مدينة لاهور بصفة خاصة لأول مرة سنة 1969م، وكنت في أوائل الأربعينات من عمري، ولم يكن في لحيتي ولا في رأسي شعرة بيضاء، وقد لقيني بعض العلماء الباكستانيين واحتفوا بي احتفاءً حارًّا، ومما أذكره في تلك الزيارة: أن أحدهم سألني: أنت الشيخ يوسف القرضاوي؟ قلت: نعم أنا هو! قال: أنت صاحب «الحلال والحرام»؟ قلت: نعم أنا هو، قال: الحمد لله، الحمد لله. قلت له: الحمد لله على كل حال، ولكن لماذا تحمد الله هنا خاصة؟ قال: كنت أظن أن مؤلف «الحلال والحرام» في الستين أو السبعين من عمره، والحمد لله أراك في شرخ الشباب، فحمدت الله أنك في هذه السن، وعسى الله أن ينفع المسلمين بك في مستقبل السنين. قلت: أدعو الله أن يجعلني عند حسن ظن المسلمين بي، وأن يغفر لي ما لا يعلمون بفضله وعفوه، إنه عفو كريم.
وقد تُرجم الكتاب إلى عدد لا يمكن حصره من اللغات الإسلامية والعالمية، وأعتقد أن أول ترجمة له كانت إلى «التركية» حتى إنني حين زرت تركيا لأول مرة في صيف سنة 1967م، وجدت الكتاب طُبع مرتين، طبعة «دار الهلال» التي يملكها الأستاذ صالح أوزجان، عضو رابطة العالَم الإسلامي. ثم طبعة دار أخرى، وتنازعت هي ودار الهلال أنهما أحق بالكتاب من الأخرى.
وتُرجم الكتاب إلى الأوردية في باكستان وفي الهند، وتُرجم إلى عدد من لغات الهند، ومنها «الماليبارية» لغة إخواننا مسلمي ولاية كيرلا في الهند، وتُرجم إلى الماليزية والإندونيسية، ولما ذهبت في أوائل الثمانينات إلى «كمبالا» عاصمة أوغندا، في اجتماع مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، وصلينا الجمعة هناك، وقدموني لألقي كلمة بعد الصلاة؛ قال مقدمي: هذا يوسف القرضاوي صاحب كتاب: «الحلال والحرام» الذي قرأتموه بلغتكم «السواحلية». ولم أكن أعلم ذلك.
ومنذ بضعة عشر عامًا كنت أزور الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد؛ فقال لي مدير الجامعة أخونا وصديقنا الدكتور حسين حامد حسان ونائبه أخي الدكتور العسال: إن هنا مجموعة من الطلاب والطالبات من الصين يريدون أن يلتقوا بك لقاءً خاصًّا بعد المحاضرة العامة، فرحبت بذلك والتقيت بهم لقاءً كان طيبًا ونافعًا، حول الإسلام في الصين ورسالة المسلمين هناك.
ثم بعد اللقاء جاءني كثير منهم يطلب مني توقيعًا على كتاب، فسألتهم: ما هذا الكتاب؟ قالوا: هذا كتابك: «الحلال والحرام» مترجمًا إلى اللغة الصينية، كما تُرجم الكتاب إلى عدد من اللغات الأوروبية، مثل: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية وغيرها، كما تُرجم إلى البوسنية والألبانية.
ومنذ سنوات أصدر وزير الداخلية الفرنسي قرارًا بمنع نشر الكتاب في فرنسا باللغة الفرنسية أو العربية، وكان قرارًا جائرًا غير مبرر، احتج عليه كثير من الفرنسين أنفسهم، حتى إن اتحاد الناشرين في فرنسا كان ضد الداخلية في ذلك، وقد انتهى الأمر باعتذار وزير الداخلية، وسحب قراره، وقال: إنه خطأ إداري! ولما سُئلت عن ذلك قلت: بل هو خطأ حضاري وثقافي وسياسي، قبل أن يكون خطأ إداريًا.
ولا أزعم أن كتاب: «الحلال والحرام» قد حاز رضا جميع الناس، فهذا غير صحيح، وغير ممكن، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. والكتاب ينهج المنهج الوسط في الأخذ بالأحكام، والوسط لا يعجب الطرفين: طرف اليمين، وطرف اليسار. كما أنه لم يلتزم مذهبًا معينًا من المذاهب السائدة، فلا يُتصور أن يعجب المقلدين المتمسكين بمذاهبهم.
وهو يتبنى «التيسير» فلا غرو أن يقف ضده المتشددون؛ حتى قال عنه من قال: هو كتاب «الحلال والحلال في الإسلام» إشارة إلى تضييق دائرة الحلال. وقد رددت على هؤلاء قائلًا: أنصحكم أن تؤلفوا كتابًا تسمونه «الحرام والحرام في الإسلام»!
وقد ظهرت بعض الردود على الكتاب، منها:
رد الشيخ عبد الحميد طهماز من أفاضل علماء حلب، ومن تلاميذ الشيخ محمد الحامد رحمه الله. ومنها: رد الشيخ صالح الفوزان، من كبار علماء المملكة السعودية، المسمى: «الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام»، ومنها: تعليق «دار الاعتصام» التي طبعت الكتاب سنة 1972م وعقبت عليه بالمخالفة في نقاط عدة. وكان الأخ أسعد السيد رحمه الله طلب مني أن يطبع الكتاب؛ لأنه ينوي إنشاء دار نشر إسلامية جديدة، يكون الكتاب باكورتها، ولما لم يكن له دار بعد؛ أعطى الكتاب لدار الاعتصام، فتصرف الإخوة القائمون على الدار هذا التصرف، وردوا على الكتاب الذي نشروه في قلب الكتاب، ودون علم مؤلفه أو إذنه.
والحقيقة أني لم أعقب على هذه الردود؛ لأنها ركزت على الأمور الخلافية التي سيظل الناس يختلفون فيها إلى ما شاء الله، وقد ملت فيها إلى جانب التيسير وفق منهجي الذي اخترته لنفسي، واطمأننت إلى صوابه، وهو: التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة؛ اتباعًا للأمر النبوي الكريم: «يسِّروا ولا تُعسِّروا، وبشِّروا ولا تُنفِّروا» متفق عليه.
ولأن منهجي العام: ألا أضيع الوقت في الرد، ورد الرد، ولا سيما في القضايا التي لا ينتهي الخلاف فيها؛ نظرًا لتعدد زوايا النظر، بين المقاصديين والْحَرْفيين، وبين من يأخذون بالأيسر ومن يأخذون بالأحوط، وبين من يعيشون في الماضي ومن يعيشون في الحاضر، والأعمار أقصر وأنفس من أن ننفقها في جدال ليس له ثمرة عملية في النهاية.
ولكني عنيت فقط بالرد على تعليق «دار الاعتصام»؛ لأنه نشر مع كتابي وفي جلده، ولم يكن تعليقًا منفصلًا، وقد نُشر كذلك دون إذن مني، وهو لا يليق، وقد أغضبني وضقت به، وأبرقت إلى الأخ أسعد السيد: أن يوقف توزيع الكتاب حتى أكتب ردًّا عليه لينشر مع الكتاب، ولكن سبق السيف العَذَل، فقد نُشر الكتاب، ووزع في الأسواق، ولم يعد يجدي طبع الرد معه، مع أن الرد قد جمع بالفعل وصححت «بروفته» وهو عندي إلى الآن لم يُنشر.
وحين أعطيت الكتاب بعدها لمكتبة «وهبة»، واقترحت عليها أن تنشر تعقيب دار الاعتصام وردي عليها: أقنعني الأخ الحاج وهبة صاحب المكتبة: أن هذا سيزيد الكتاب في الحجم والسعر، ولا أرى ضرورة لذلك، فآراؤك واضحة ومدللة ومقنعة.
وفي نيتي - إذا مد الله في العمر ورزقني البركة والتوفيق - أن أنشر طبعة تتضمن هذا الرد، وبعض الردود على الانتقادات الأخرى، وعلى بعض تعقيبات الشيخ الألباني على الأحاديث.
ومما أذكره هنا: كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إليَّ في أواسط السبعينات، حول كتاب: «الحلال والحرام»، وكان كتابًا يفيض بالمودة والتقدير من الشيخ رحمه الله، ومما قاله في مقدمته: إن كتبك لها وزنها وثقلها في العالم الإسلامي، وتأثيرها في مثقفيه وشبابه؛ ولذا تحتاج منك إلى مزيد من التحري والتثبت، وهذه شهادة من الشيخ الجليل أعتز بها، ثم ذكر الشيخ أن وزارة الإعلام عرضت عليه كتاب «الحلال والحرام» لينظر فيه: أيفسح له أم يمنع؟ ويرى الشيخ أن في الكتاب ثمانية مسائل انتقدها المشايخ في المملكة.
من هذه المسائل: قضية تغطية وجه المرأة، ومنها: قضية الغناء، بآلة وبغير آلة، ومنها: قضية التصوير، ومنها: مودة المسلم للكافر، ومنها: قضية التدخين، إلى آخر المسائل الثمانية، التي لا أذكرها الآن بالتفصيل، ويرجو مني الشيخ - عليه رحمة الله - في نهاية كتابه أن أعاود النظر في هذه المسائل، لعلي أغير اجتهادي فيها، وأوافق المشايخ فيما انتهوا إليه من رأي.
وقد رددت على الشيخ برسالة قابلت فيها مودته بأحسن منها، أو بمثلها، وذكرت له أن من أحب الناس إليّ أن أوافقهم في اجتهادي هو الشيخ ابن باز، لما أكن له من محبة وإجلال، ولما اعتقد فيه من صدق وإخلاص وغيرة على الإسلام والمسلمين، ولكن سنة الله أن يختلف أهل العلم بعضهم مع بعض منذ عصر الصحابة وإلى اليوم، وما ضر الصحابة ولا الأئمة من بعدهم أن اختلفوا، فقد اختلفت آراؤهم؛ ولم تختلف قلوبهم، وقد قال العلامة ابن قدامة في آخر «لمعة الاعتقاد»: اختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. وكذلك قال في مقدمة: «المغني».
وقد رجوت سماحة الشيخ ألا يكون خلافي في بعض المسائل سببًا في منع دخول كتابي إلى القراء الأشقاء في المملكة... فقد قال العلماء: لا إنكار في المسائل الاجتهادية، والشيخ الألباني يخالف المشايخ في بعض الآراء ولا تمنع كتبه. على أن بعض هذه المسائل قد أخطأ المشايخ فيها فهمهم عني، مثل مسألة «التدخين» فأنا من المتشددين فيه، وقد ذهبت إلى تحريمه بالدليل.
وبعض المسائل أطلقوها، وأنا أقيدها، فأنا لم أقل بمودة الكافر بإطلاق، فالكافر المعادي للمسلمين المحاد لله ولرسوله لا يواد كما نطق القرآن، أما الكافر المسالم فلم نُنه عن بره والإقساط إليه، كما قال الله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الممتحنة:8)؛ ولهذا أجاز القرآن للمسلم تزوج الكتابية، كما تقرر سورة المائدة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} (المائدة:5)، ومن مقتضى الزواج: المودة بين الزوجين، كما قال تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم:21)، وأحسب أن الشيخ قد استجاب لرسالتي، ولم يمنع الكتاب في تلك المدة من دخول المملكة.
هذه قصة كتابي: «الحلال والحرام» عسى أن يجد القارئ الكريم فيها منفعة وذكرى.


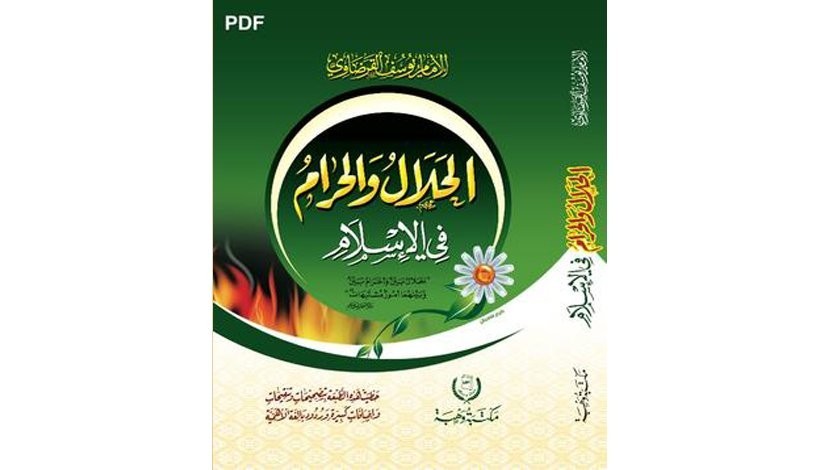
 فقه الصيام
فقه الصيام  موجبات تغير الفتوى في عصرنا
موجبات تغير الفتوى في عصرنا  ثقافة الداعية
ثقافة الداعية  تاريخنا المفترى عليه
تاريخنا المفترى عليه 






