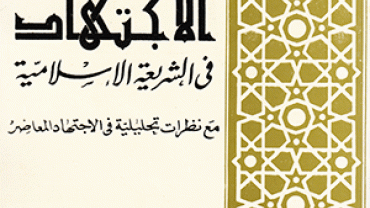وائل قنديل
هناك، في الصفّ الأول، على يمين خطيب المنبر، يجلس الإمام العالم الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، فوق مقعدٍ أبيض اللون من البلاستيك المقوّى، مُنصتًا إلى الخطبة في خشوع، متكئًا على عصاه، إذ يحضر مبكرًا قبل الجميع.
يتوافد المصلون على مسجد "أوجاب الرجا" في الدوحة، كلٌّ يبحث عن مكانٍ قريبٍ من الشيخ، ليصافحه بعد أداء الصلاة. وعلى مدار أعوام كنت أحظى بالسلام عليه كل جمعة، حيث أتشرّف بأن أضع ذراعي بديلًا للعصا التي يتوكّأ عليها، ونسير معًا، يسألني عن الأحوال، العمل والأسرة والأولاد، حتى نصل إلى سيارته الواقفة في ساحة المجلس، ولا أتركه حتى يستقرّ على مقعده بجوار السائق، ثم أغلق الباب مودّعا، على موعد باللقاء في مكتبه، في اليوم الذي يريد.
كان ذلك أجمل طقوسي الأسبوعية طوال سنوات إقامتي في الدوحة تقريبًا، وكذا في أيام الجمعة في فترة إجازاتي عند العودة من لندن، وأيضًا في ليالي رمضان بالمسجد ذاته، حيث كان الشيخ وقد تجاوز التسعين يقف، بعد انتهاء الصلاة في المسجد، يمد يده لكل مصافح، طفلًا كان أو شيخًا أو شابًا أراد أن يلتقط صورة تذكارية، وخصوصًا من القادمين خصيصًا من بلاد في أقصى شرق آسيا، من إندونيسيا وماليزيا، يعرفون الإمام وقدرَه ومكانته في إقامة الدين. وفي عشرات المرّات كنت أقوم بدور المصوّر، إذ يقفون حول الإمام ويطلبون مني أن أصوّرهم معه بجوالاتهم المحمولة.
في ثلاث سنوات فيروس كورونا اللعين، كان المكان الذي يضيء بفقيه الأمة شاغرًا كل يوم جمعة. وعلى الرغم من ذلك كنت أتوجه إليه عقب أداء الصلاة، وأقف دقائق خلف المقعد الغائب للشيخ الغائب، مكذّبًا عيني وأقول في نفسي"لعله هنا" لكني لا أراه.
بساطة الشيخ وتواضعه مع السائل الذي لا يعلم، ومع المحتاج الذي لا يسأل، هما السمتان الغالبتان على رجل استثنائي في علمه الموسوعي وفكره العميق، وفرادته في دنيا الفقه والفتوى.
قابلت الشيخ القرضاوي للمرّة الأولى في حياتي، مصادفة حين توّقف محرّك الطائرة القادمة من القاهرة إلى الدوحة في يوم 17 يوليو/ تموز 2013 حيث وقفت فور الإعلان عن الوصول وإمكانية أخذ الأمتعة الخفيفة من الرفوف العلوية لألمح رفيقي في الرحلة، أستاذ العلوم السياسية، المنحاز لسلطة الانقلاب العسكري في مصر، حدّ التعصّب، ألمحه ينحني مقبلًا رأس شيخ عجوز فوق كرسي متحرّك، كان يجلس في الصف الأول بالطائرة، كان ذلك هو الشيخ القرضاوي الذي لمحني واقفًا على مسافة ثلاثة صفوفٍ فناداني بإسمي كي أسلم عليه، فوجئت بأن الشيخ الجليل يعرفني أصلًا، فما بالك لو علمتَ أنه حدّثني عن كتاباتي التي يحرص على قراءتها؟
كان ذلك أمرًا مزلزلًا بالنسبة لي، فهذا الرجل ليس فقط العالم الفقيه الذي لا يشقّ له غبار، بل هو الأديب المثقف الناقد، فأية جائزةٍ يمكن أن يحصل عليها كاتبٌ أكبر من التفاتة ثناءٍ من إمام الأئمة؟
في أيام كورونا اللعينة، كنت ألتقي مدير مكتبه وسكرتيره الخاص الدكتور حسن في المسجد وأطمئن منه على أخبار الشيخ، وأحمّله السلام عليه، وأرجوه أن يتصل بي فورًا إن تهيأت الظروف وتوفرت دقائق يمكنني فيها من زيارته، فقط للسلام عليه.
كنت طوال السنوات الست الماضية أفكّر في كيف أردّ ديْنًا في رقبتي للشيخ، وهو ديْنٌ لو تعلمون فادحٌ وعظيم، بل أعتبره ذنبًا أدعو الله أن يغفره لي، حيث كان محبّو الشيخ قد قرّروا إصدار كتابٍ خاص لمناسبه بلوغه التسعين من عمره، وطُلب مني المساهمة بمقالة في هذا الكتاب التذكاري.لا أدري لماذا لم أستطع أن أكتب حرفًا كلما هاتفني أحدهم يذكّرني أو يستعجلني في كتابة المقال، ربما كانت نفسي تأبى أن تكتب عن الشيخ من باب الذكرى، إذ كان شعورٌ بالانقباض يداهمني، حيث ترتبط معي الكتابات التذكارية دومًا بالنهايات، وقد كنتُ لا أريد أن أتصوّر حياتنا بدون هذا الإمام، حتى كرهت فكرة إصدار كتاب تذكاري عنه، من الأساس، بينما هو حاضرٌ ومضيءٌ في حياتنا.
يمكنك أن تعتبر هذه السطور اعتذارًا عن واجبٍ تخلفت عنه، لكني بالفعل كنت أقاوم دائمًا هاجس الكتابة عن هذا العالم العلم العلامة، باعتبارها ذكرى.
.....
- المصدر: العربي الجديد، 30-9-2022



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين