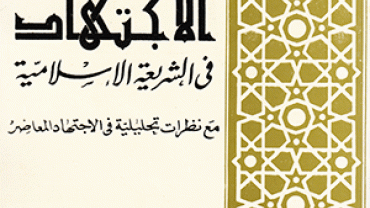سليم عزوز
لا أعرف ماذا فيّ من خصال، جعلت الشيخ يوسف القرضاوي يحتفي بي هذه الحفاوة، لكني أعرف سلوك «الكبار»، الذين يُقيمون الناس على مواقفهم، وإخلاصهم لهذه المواقف، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني!
فالرجل الذي حزن لتحول ابن الجمعية الشرعية الشيخ خالد محمد خالد، إلى معاد لفكرة الدولة الإسلامية في كتابه «من هنا نبدأ»، لم يمنعه هذا من أن يذكره بما فيه من خصال، عندما كتب في مذكراته أنه «صاحب قلم رشيق وأنيق، وأسلوب شائق رائق أخّاذ..»، ثم ينصفه بذكر شهادة من يعرفه بأنه صاحب قلم لا يباع ولا يشترى. وكذلك كان خالد محمد خالد فعلا!
لقد ذهبت لبيت الشيخ في قطر أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يوجد عشرات المدعوين، حتى يمتلئ بهم البيت على اتساعه، وكانوا تقديراً للرجل وإجلالا لقيمته يقبلون رأسه، وهو سلوك خليجي مع الكبار. يبدأ تقبيل الرأس أو ينتهي بالانحناء وتقبيل يده، لكني وإن كنت لا أجيد تقبيل الرؤوس، مع تقديري لهذا السلوك عظيم الشأن، إلا أنني لم يحدث أن قبلت يده مثلهم، فهذا السلوك كنت أمارسه مع والدي رحمة الله عليه. لكني مع هذا لا أخفي خجلاً ريفياً كان يتملكني في كل لقاء، والشيخ الجليل يحرص على أن أكون قريباً منه في مجلسه، نفس خجلي في حضرة الوالد، الذي كان يمنعني من الانخراط في حديث مع ضيوفي عندما أسافر إلى بلدتنا، حتى يتلقى نصيحة من قريب: «اتركه حتى يأخذ راحته»! ومع هذه المصافحة العادية إلا أنه يستقبلني هاشا باشاً وبترحيب شديد!
ولا أنسى يوم أن دعانا في بيته العامر بالدوحة، لمجلس عزاء لتأبين المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الشيخ مهدي عاكف، الذي وافته المنية في سجنه، وكيف تبادل على الكلمة الخطباء، وعقب كل كلمة لمتحدث، يسأل عني، وينادي على بصوت جهير، بينما أجلس في الخلف بعيداً عنه بين واقفين، حتى لا يراني، ومع ذلك لم ينس في كل مرة أن يسأل، ولما خشيت من أن يشيروا له علي غادرت لخارج المنزل، حتى انتهت هذه الليلة، فلست خطيباً مفوهاً، في يوم تحدث المفوهون من الخطباء مثله ومثل خالد مشعل، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه!
وقد كنت لا أشرف بالجلوس في حضرته إلا بدعوة، على عشاء، أو إفطار في رمضان أو نحو ذلك، وفي حضور كثير من المدعوين، وددت لو أن إقامتي في الدوحة كانت في سن له يسمح بذهابي المتكرر إليه، فلدى الشيخ ما يقوله، ولما يثير اهتمامي.
وقد كنت أجلس مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل بالساعات، لكني كنت أرفق به في هذا السن، من هذا الشغف، مكتفياً بما قرأته في مذكراته، والأجزاء الأربعة التي حرصت على أن تكون في مكتبي. لكن الرجل ولكونه من الكبار، الذين يعرفون «الأصول» ويدرك أنني وإن طالت إقامتي إلا أنني ضيف، وهو المقيم، فيفاجئني باتصال هاتفي يسألني عن الحال والأحوال، وهل ينقصني شيء؟ ثم تبدو حدة في أسلوبه وهو يسأل لماذا لا أسأل عنه وأتواصل معه، وما منعني سوى الإشفاق عليه. لكني كنت منتبهاً دائماً إلى أن «الأصول» تفرض أن من يسأل هو الصغير!
إنه -يا إلهي- يتذكر آخر مرة دعاني لتناول العشاء ولم أحضر، وما منعني إلا خشيتي من عدم التمكن من الوصول، فذاكرتي لا تحفظ عناوين الأماكن بسهولة، وكنت في كل مرة أذهب مع صديقي محمد القدوسي، لكنه كان في هذه المرة مسافراً خارج الدوحة!
وقدمت له مبرري، وعلق بأن القدوسي حضر، فلماذا لم تحضر؟ واتصلت بالقدوسي الذي أفادني بصحة الرواية، فقد عاد في يوم الدعوة من الخارج وذهب إليه مباشرة، ظناً منه أنني رتبت طريقة وصولي لمقر الدعوة!
وأدهشني أن رجلاً في هذا السن، ومع كل هذه المسؤوليات، ولا تزال ذاكرته تحفظ أنني لم أحضر دعوة له منذ بضعة شهور، وتحفظ أن القدوسي حضر، ومثل هذا اللقاء يكون دائماً مزدحماً بالمدعوين، من وجهاء القوم، وكبار الناس، والعلماء!
لكنه الشيخ يوسف القرضاوي، الرجل الكبير الذي يهتم بأحوالنا، والذي يرفع الحرج فيتصل هو بنا إذا قصّرنا في الاتصال به، والذي وددت لو جلست طويلاً في حضرته، لو كان سنّه يسمح بذلك، وكانت الأحوال غير الأحوال. وقدره عندي ليس فقط في كونه عالماً جليلاً، وفقيهاً كبيراً، ورمزا لسماحة الإسلام وإسلام السماحة، ولكنه، مع هذا، قبله وبعده، مفتي الثورة الذي حمانا، وكان له ولقناة الجزيرة الفضل في نجاح ثورتنا، في يوم الفزع الأكبر!
لقد كان هو اليوم الأقل عدداً في ميدان التحرير، بعد خطاب مبارك العاطفي، دخلت الميدان صباحاً بصحبة صديقي الأستاذ محمد منير رحمه الله، فوجدت جدلاً بين من يرون ضرورة مغادرة الميدان وقلة تطلب بعدم التسليم بصدق مبارك أنه سينهي حكمه في أيلول/ سبتمبر المقبل مع نهاية دورته. وهنا تم حصار الميدان بجحافل البلطجية الذين يشهرون السلاح الأبيض، وزجاجات المولوتوف، ودخلت البغال والحمير والجمال الميدان، وجاء مدير المخابرات الحربية عبد الفتاح السيسي يطلب من الثوار مغادرة الميدان للسماح لأنصار مبارك بالدخول وممارسة حقهم في تأييده، وبدأت دبابات الجيش في الزحف، وقد أوقفها الشباب الذين ناموا تحت عجلاتها، كان الميدان يقصف طوال اليوم بالحجارة!
وفي هذه اللحظة كانت الثورة على موعد مع مفتيها، تحرك الشيخ إلى قناة الجزيرة، وعلمت بعد ذلك أنه كان على فراش المرض، لكن عزّ عليه أن يبلغ من تلاميذه بأن الثوار يذبحون في الميدان ولا يتحرك، فكانت فتواه، التي ظلت الجزيرة تعيد إذاعتها طوال اليوم، بأن نصرة المحاصرين في ميدان التحرير فرض عين على كل قادر، وبدأت الحشود في الزحف المقدس، على الأقدام، لأن حظرا للتجول كان مفروضاً، وغادرتُ الميدان بعد منتصف الليل، بينما الآلاف في زحف لا يتوقف، فلم يأت صباح اليوم التالي إلا والميدان مكتظ بالناس، فحمت فتوى القرضاوي الثوار من مذبحة محققة!
والحال كذلك، فقد كان طبيعياً أن يأتي في الجمعة التالية لتنحي مبارك، ليلقي الخطبة بالميدان فيما عُرف بجمعة النصر، ووجدت أن الحد الأدنى لرد جميل الرجل علينا أن أذهب لأصلي هناك، فوجدت الميدان وقد انفجر بأعداد من فيه، فلم يجد أحد من قوى الثورة الأصيلة حرجاً في أن يكون الخطيب هو الشيخ القرضاوي، ومسيحيون كانوا يقفون فوق أسوار الجامعة الأمريكية للقيام بدور البوصلة للقبلة، وكنا واقعيا خارج الميدان فلم يكن بالإمكان معرفتها في أطرافه إلا بالنظر إلى قلبه!
الحرج تملّك من لم يكونوا في الثورة، وكانوا يرون أن عدم وجود زعامات لها سيسهّل مهمتهم في أن يكون لهم قيمة فيها، فحتى رجال الأعمال الذين هم رموز الفساد في عهد مبارك، كانوا ينافقونها. وانبعث هيكل بعد ذلك ليقول ما لم يكن مطروحاً على بال أحد من أنه شعر بالانزعاج لوجود القرضاوي خطيباً للجمعة لأنه بدا له كالخوميني، بعد الثورة الإيرانية، وكأن الخوميني يمثل له مشكلة وهو الذي جلس تحت قدميه في الأيام الأولى للثورة الإيرانية ليخرج بمادة كتابه «مدافع آيات الله«!
إن موقف القرضاوي المنحاز للثورة، والرافض للانقلاب العسكري، هو وراء الدعاية المجرمة بأنه مفتي الدم، إنهم يحجبون عنه صفته الحقيقية وهي أنه «مفتي الثورة» وعلم من أعلامها الكبار، ومن أفتى بسفك الدماء، هم رجال الدين الأحذية في قدم كل مستبد، ومن سفك الدماء هم حكام ظلمة، يقتلون القتيل ويمشون في جنازته!
ولا بأس فلكل وجهة هو موليها، فهيكل صنيعة الانقلاب العسكري الأول والقرضاوي أحد ضحاياه.
رحم الله شيخنا الكبير رحمة واسعة.
.....
- المصدر: عربي21، 27-9-2022



 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين