من قطر إلى الجزائر:
في أواخر خريف أو أوائل شتاء سنة 1989م جاءتني دعوة من الجزائر لإلقاء عدد من المحاضرات في عدد من جامعاتها، في الجزائر العاصمة وفي وهران بالغرب الجزائري. وكان الذي ينسّق هذه المحاضرات هو وزارة الشئون الدينية في الجزائر.
كما جاءتني دعوة أخرى في نفس التوقيت من «جامعة القاضي عياض» بمدينة مراكش في المملكة المغربية. ورتّبت سفري على أن يكون ذلك في رحلة واحدة، وهذا ما أحاول أن أفعله دائمًا اختصارًا للوقت.
وتمّ الترتيب على أن أبدأ بالجزائر لأبقى فيها يومًا واحدًا، ثم أترك فيها حقيبتي الكبيرة. وآخذ معي إلى مدينة مراكش حقيبة صغيرة، حيث إني لن أقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام. ولكن إقامتي الأطول ستكون في الجزائر. وكان وصولي إلى الجزائر عن طريق القاهرة.
من الجزائر إلى الدار البيضاء:
وحين وصلت إلى الجزائر حططت فيها رحالي لليلة واحدة، ثم حملت حقيبتي الصغيرة في الصباح، وركبت الطائرة المتجهة إلى الدار البيضاء، وكان اعتقادي: أني سأجد بعض الإخوة من جامعة القاضي عياض، ينتظرونني بالمطار، ثم يصطحبونني إلى مراكش. وهو ما أرسلت به عدّة برقيات إليهم، وما طمأنتني سفارة المغرب في الدوحة: أن كل شيء على ما يرام.
في مطار الدار البيضاء:
وصلت مطار الدار البيضاء، وخرجت منه لأبحث عمّن ينتظرني من إخواننا في مراكش، فلم أجد أحدًا... تلفّت يمينًا وشمالًا، فلم أشعر بأن أحدًا في استقبالي، وأنا بهيئتي وزيي لا يخطئ مَن ينتظرني. قلت: لعلهم تأخروا في الوصول، فلأنتظر قليلًا، لنعطيهم فرصة في الوصول، ولو متأخرًا، ولكن كان ذلك كله بدون جدوى.
التماس المعاذير:
راودني خاطر أن أعود إلى الجزائر. فهؤلاء القوم الذين لم يهتموا باسقبالك، وأنت قادم من أقصى المشرق العربي، إلى أقصى المغرب العربي: لا يستحقون أن تذهب إ ليهم! وسرعان ما انقشع هذا الخاطر، حين أرجع إلى نفسي، وأقول: لا يمكن أن يتعمّد القوم ذلك، والشاعر العربي يقول:
تأنّ ولا تعجل بلومك صاحبًا لعل له عذرًا وأنت تلوم
والمؤمن دائمًا يلتمس المعاذير، والمنافق يتطلب العثرات. وأنا أحمد الله تعالى: أن من أخلاقي الثابتة: التماس الأعذار للآخرين.
قلت في نفسي: لا بد أن برقياتي لم تصل إليهم، ودائمًا الخدمات في المدن الإقليمية، غير العواصم، تكون رديئة وغير منتظمة، ولا سيّما في بلادنا العربية. ليس لنا إلا الرضا بما قدّر الله، فهو الذي يشفي صدورنا، ويريح ضمائرنا: أن نقول: قدّر الله وما شاء فعل.
ولكن ترى ماذا أفعل؟ وهذه مدينة لم أزرها من قبل، ولا أعرف عنها أي شيء، إلا أنها مدينة عريقة، وكانت عنوانًا من قبل على القطر المغربي كله، فكنا نقول دائمًا: قضايا تونس والجزائر ومراكش.
وجامعة القاضي عياض لا أعرف عنها شيئًا غير اسمها، وهي تنتسب إلى إمام كبير، له قدره ودوره في خدمة الثقافة الإسلامية: في السيرة النبوية، وعلوم الحديث، والفقه وأصوله، ولكن ما بال الجامعة التي تنتسب إليه تضيع ضيوفها، وتتركهم مكشوفين في العراء؟
من الدار البيضاء إلى مراكش:
كان لا بد لي من أن أفكر جديًا: ماذا أعمل للوصول إلى مراكش، وقيل لي: ليس أمامك إلا أن تذهب إلى القطار، وهذا يحتاج منك إلى أن تعرف مواعيده. ونظن أنه في الصباح أو المساء، أو تأخذ سيارة «تاكسي» إلى مراكش.
قلت لهم: كم تأخذ المسافة من هنا إلى مراكش؟
قالوا: حوال أربع ساعات.
وبحثت عن سيارة تاكسي لتوصيلي، فوجدت إحداها وإن لم تكن كما أحب، واتفقت مع سائقها أن يوصلنا إلى جامعة القاضي عياض بمراكش.
ومضت السيارة في طريقها، وكان الطريق ضيقًا، ومزدحمًا بالسيارات الذاهبة والآتية، وطالت الساعات الأربع، كأنها أيام، وزاد طولها ما أعانيه من كدر وقلق نفسي، لا يسلم منه البشر في مثل هذه الأحوال. ولم تكن جلستي في السيارة مريحة كما ينبغي، وقد جئت من سفر طويل من الدوحة إلى الجزائر عن طريق القاهرة، ثم من الجزائر إلى الدار البيضاء.
وبعد أربع ساعات، وربما أكثر قليلًا، وصلنا إلى مراكش، وبقى أن نصل إلى جامعة القاضي عياض، والسائق من الدار البيضاء، ولا يعرف شيئًا في مدينة مراكش، ولذا ظلَّ يدور بي ويدور، حتى إننا مررنا قرب الجامعة المنشودة ولم يشعر! قلت له: يا أخي اسأل، المثل عندنا يقول: الذي يسأل لا يتوه.
إلى جامعة القاضي عياض:
وبالسؤال دلونا على طريق الوصول إلى الجامعة، وأخيرًا وصلنا إليها بعد لأى، وكانت الشمس تقترب من الغروب. وكان بعض الطلاب لا يزالون بالجامعة، فأشار بعضهم إلى بعض: القرضاوي، القرضاوي. وأقبل عدد منهم يريدون مصافحتي ومعانقتي، فرجوتهم أن يدعوني الآن، فإني في غاية من المعاناة والتعب، وأن يدلوني على مكتب أي مسئول في الجامعة، وخصوصًا الداعين إلى مؤتمر الغد.
في مكتب عميد كلية الآداب:
وأوصلوني إلى مكتب عميد كلية الآداب، وهو في الدول الثالث من المبنى، وكنت أجر رجلي جرًا، وقد بلغ بي الإعياء ما بلغ، حتى وصلت إلى مكتب العميد، ففوجئ بي، ومَن معه من الأساتذة، وقالوا: كيف وصلت؟ وأُسقط في أيديهم، ولم يدروا ماذا يقولون. قالوا: نأسف غاية الأسف، ونعتذر كل الاعتذار: أن تأتي إلى جامعتنا، ولا يستقبلك منا أحد، هذا عيب كبير في حقنا، وتقصير ليس بعده تقصير... وحلفوا بالأيمان المغلّظة: أنهم لا يعرفون عن وصولي شيئًا، ولقد استقبلنا من هو أقل منك شأنًا، فكيف لا نستقبلك، والمغرب كله يحبك ويقدرك قدرك؟
قلت: ما عاد الاعتذار ولا التلاوم يُجدي فتيلًا، وقد وقع ما وقع. والخير فيما اختاره الله، لعله دفع بذلك بلاء أكبر كان سيقع لنا، ونحتسبه عند الله.
وطلبوا لي فنجانًا من القهوة. قلت لهم: أرى الشمس تتهبأ للغروب، وأنا لم أصلّ ظهرًا ولا عصرًا، دلوني على دورة الميار لأتوضأ وأصلي الظهر والعصر جمع تأخير، قبل أن ينتهي وقتهما.
فذهبت إلى حمام قريب، وتهيأت للوضوء، وصليت الفرضين الظهر والعصر، وأنا في غاية الإعياء، صلّيتهما جالسًا، ولا حرج في ذلك، فالله تعالى يقول: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ} [التغابن: 16]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ} [الحج: 78]، ونحن نعلّم هذا للناس فلماذا لا نطبقه نحن؟
وعدتُ إلى الإخوة، وشربت القهوة، وقالوا: يجب أن نأخذك إلى الفندق لتستريح من وعثاء السفر، ومتاعب الطريق، وفي الصباح نأتي إليك لنرتب معك موضوع المؤتمر.
قلت: أحسنتم، وجزاكم الله خيرًا.
إصابة مفاجئة في رجلي اليسرى:
ونزلنا من الدور الثالث، إلى حديقة الجامعة، لنصل إلى السيارة التي تقلني إلى الفندق، وفجأة شعرت برجلي اليسرى تتوقف، ولا أستطيع أن أحركها، وشعرت بألم شديد فيها.
نظر إليّ الإخوة المرافقون: عميد الكلية ومن معه، وقالوا: ألا تستطيع أن تمشي ولو ببطء إلى السيارة؟!
قلت لهم: لا أجد نفسي قادرًا على أن أخطو خطوة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قالوا: نحملك، لنوصلك إلى السيارة، ومنها إلى الفندق!
قلت: وماذا أفعل في الفندق، وأنا لا أقدر أن أذهب إلى الحمام، أو أقضي أي شيء؟
قالوا: وما العمل؟ وما الحل؟
قلت: ليس هناك حل إلا أن تذهبوا بي فورًا إلى مستشفى خاص، ينظر في حالتي، ويصف لي العلاج السريع المناسب، الذي يخفّف - على الأقل - الألم عني، وأنا الذي سأدفع المصاريف.
وكان من فضل الله علي أني حملت معي قدرًا من الدولارات احتياطًا، على قلة ما أفعل ذلك، ولكن الله هداني في هذه المرة إلى هذا. وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله.
إلى مستشفى خاص للعلاج:
وفعلًا أوصلوني إلى مستشفى خاص، وفحصني الطبيب المسئول في الحال، وقال لهم: إنه يتطلب ألا يتحَرَّك من سريره لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل، وأن يعطى إبرة مسكنة، وتجري له بعض التدليكات الخفيفة، ويأخذ بعض الأدوية، حتى يمكن أن يقف على رجليه.
وودّعني الإخوة وتركوني ممددّا على سريري. قالوا: نأتي بعشاء خفيف تقيم به أودك، فلعلك منذ الصباح لم تتناول شيئًا.
قلت لهم: شكر الله لكم، ليس عندي شهيّة لأيّ طعام، ولا أشعر بالجوع، على رغم أن جوفي لم يدخله شيء منذ الصباح الباكر.
وكانت نيتي ألا آكل شيئًا، حتى لا أضطر إلى البراز، وأنا على السرير، وهو شيء يؤلم النفس، مع أنه ليس على المريض حرج.
وقضيت ليلتي نائمًا على ظهري، لا أجد سلوى إلا في الذكر والدعاء، وبخاصة دعاء سيدنا أيوب: {إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ} [الأنبياء: 83]، ودعاء سيدنا يعقوب حين قال: {إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ} [يوسف: 86]. ودعاء سيدنا يونس ذي النون، حين نادى في الظلمات: {أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ} [الأنبياء: 87]. وقد جاء في الحديث: «دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه»(1) فلعل الله الرحمن الرحيم يفرج عني بفضله ورحمته.
ما أصعب المرض في الغربة:
لقد خلق الإنسان ضعيفًا، وأظهر ما يكون ضعفه حين يصيبه المرض، ولا سيما في حال الغربة، وقد قيل: الغربة كربة.
أن تمرض بين أهلك وعيالك شيء، وأن تمرض ولا أحد من أهلك حولك: شيء آخر.
وقد قدّر عليَّ أن أصاب بأمراضي الكبيرة وأنا في السفر، أُصبت في فقرات ظهري، وأنا في فندق في مطار كراتشي وأنا عائد من ماليزيا، وبعد أن ودعني الإخوة الذين استقبلوني، وتركوني وحدي.
واليوم أصاب برجلي اليسرى، وأنا في هذه المدينة المغربية، بعيدًا عن وطني وأهلي. ولله في ذلك حكمة، عَلِمَها من عَلِمَها، وجَهِلَها من جَهِلَها. فهو لا يخلق شيئًا باطلًا، ولا يقضي أمرًا اعتباطًا ولا عبثًا: {رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ} [آل عمران: 191]. أدعو الله تعالى أن يجعل كل ما يصيبني في رحلاتي هذه كفارة لسيئاتي، وما أكثرها، وزيادة في حسناتي، وما أقلها!
بقيت إلى الصباح، وانقضى الليل الطويل، الذي ذكرني بليل امرئ القيس، وهو يقول له:
ألا أيها الليل الطويل ألا انْجَلِ بصبح، وما الإصباح منك بأمثلِ!
طلاب الجامعة يتساءلون عن غيابي:
وابتدأ المؤتمر الذي دُعيت إليه بعقد جلسته الافتتاحية، ولم أحضرها، ولم يعرف أكثر الناس أني في مدينة مراكش، كل ما عرفوه أني دُعيت واعتذرت. ولكن بعض الطلاب الذي شاهدوني بالأمس، تهامسوا فيما بينهم: أين القرضاوي؟
والإخوة المسئولون لا يريدون أن يعلنوا عن حضوري، وعمَّا حدث لي، حتى لا يتكاثر الناس، ولا سيما الطلاب عليّ، ويزعجونني، وأنا في حاجة إلى الراحة.
وفي جلسة المساء، تلفّت الطلاب يَمْنة ويَسْرة، فلم يجدوني، وهم مستيقنون أني قد وصلت إلى البلدة، ورأوني بأعينهم، وسلّموا علي، فأين ذهبت أو ذُهِب بي؟!
لقد ظهرت إشاعة: أني وصلت إلى مركش، وأن السلطات الأمنية حجزتني عن المشاركة! وإلا فأين أنا؟
وبدأ تهامس الطلاب وتخافتهم، يقوى شيئًا فشيئًا، حتى تحوّل إلى صيحات داخل القاعة! أين القرضاوي؟ أين القرضاوي؟
وأحسب أن المسئولين اضطروا إلى أن يعرفوهم بما جرى لي من إصابة في رجلي عطّلتني عن الحركة والمشي، واضطرتني إلى الدخول في مستشفى خاص للعلاج، وهذا قدر الله، ولا حيلة لنا فيه، ولا نملك إلا أن ندعو الله جميعًا له بالشفاء العاجل.
في منزل د. العبادي:
وفي المساء وبعد أن أنهيت الأربع وعشرين ساعة، التي فرضها الطبيب علي ألا أتحرك فيها: جاءني بعض الإخوة الأحبة من أهل المدينة، وعلى رأسهم أخونا الحبيب العالم الداعية د. أحمد العبادي، وطلب إليّ أن أذهب معه إلى داره، ليكون هو وأهله وإخوانه في خدمتي، وأن النزول في الفندق لا يقوم بكل ما أحتاج إليه. فأنا ما زلت في حاجة إلى مساعدة ومساندة للوصول إلى دورة المياه، وعنده دور أرضي يعينني على ذلك. وقال: تبقى عندنا ليلتين حتى تستطيع النهوض بنفسك، وتعود إلى الجزائر كما هو مقرّر في رحلتك.
وافقت على ذلك، وبقيت يومين في منزل الأخ الكريم، وفي رعاية بالغة منه ومن أهله، ومن بعض إخوانه، الذين كانوا يزورونني بين الحين والحين. وقد اجتمعت في مساء اليوم التالي بنخبة طيبة منهم، وسمعوا مني وسمعت منهم، وسألوني وأجبتهم.
وقد رتَّبوا لي العودة إلى الدار البيضاء عن طريق القطار، ويستقبلني الإخوة هناك من محطة القطار، وأبيت عندهم ليلة، ومن هناك أستقل في الصباح الطائرة إلى الجزائر.
العودة إلى الدار البيضاء والمبيت فيها:
وفعلًا في الصباح الباكر، أخذني الإخوة بالسيارة إلى محطة القطار، ولم يكن في ذلك مشقة، ولكن المشقة كانت في السير على الرصيف، حتى أصل إلى العربة التي فيها مقعدي، وكل خطوة عندي لها حساب.
وركبت القطار بعد أن ودّعت الإخوة الأحبة، شاكرًا للأخ الدكتور العبادي ما قام به نحوي، مما لا أنساه، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي الحديث: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تقدروا، فقولوا: جزاك الله خيرًا»(2)، وأنا أقول للدكتور العبادي وإخوانه: جزاكم الله خيرًا، وأكرمكم كما أكرمتموني.
وصلت إلى محطة الدار البيضاء، ووجدت بعض الإخوة في انتظاري، وأخذوني إلى منزل أحدهم، وقالوا: وجدنا هذا أفضل من الفندق حتى نكون رهن إشارتك فيما تطلب من معونة. ثم هي فرصة لندعو لك بعض الإخوة ليلتقوك ويستمعوا إليك، فهذه فرصة لا تعوض.
وبالفعل حضر عدد من الإخوة العاملين في حفل الدعوة الإسلامية، وكان لقاء طيبًا من لقاءات الأُخوّة في الله، والحب في الله، الذي نرجو أن يظلّنا الله ببركته في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
ومن الدار البيضاء إلى الجزائر:
وفي الصباح استقللت الطائرة من مطار الدار البيضاء إلى الجزائر، ووجدت الإخوة في استقبالي بمطار هواري أبو مدين، وهو الاسم الرسمي لمطار الجزائر. وقد آلمهم كثيرًا ما رأوني أعانيه من ألم الإصابة برجلي، ودعوا الله لي بعاجل الشفاء، وتمام العافية.

وكنت وأنا في مدينة مراكش، اتصلت بالإخوة في الجزائر، وأبلغتهم لما حدث لي من إصابة في رجلي اليسري، عاقتني وأقعدتني عن الحركة والنشاط، ورجوتهم أن يعفوني من المحاضرات والأنشطة التي رُتّبت من قبل، فما كنت أعرف ما يخبئه لي القدر، {وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗا} [لقمان: 34]، وكما قيل: العبد يفكر، والرب يقدّر. ولا ريب أن تقدير الرب هو النافذ، وكما قال شوقي:
قدّرت أشياء، وقدّر غيرها قدرٌ يحطُّ مصاير الإنسان!
وقال لي الإخوة: إنَّ هذه الأنشطة والمحاضرات قد أُعلن عنها بكثافة في الصحف والإذاعة والتلفزيون، وغدا الناس يترقّبونها ويسألون عنها، ومن الصعب جدًا إلغاؤها. كل ما نستطيع أن نعمله: أن نهيِّئ لك كل الوسائل التي تريحك، ونجند لك من الإخوة من يرافقك في هذه المحاضرات، ولا يحوجك إلى المشي الكثير، وحتى هم مستعدون أن يحملوك على أكتافهم إذا لزم الأمر. فنرجو ألا تخيب رجاء الناس فيك، وأهل الجزائر أمسوا يحبونك ويهرعون إليك، ويصغون لكل ما تقول، وهذه نعمة تستحق الشكر، ومن شكرها ألا تخذل المحبين لك.
قلت: والله ما طلبت هذا إلا من شدة ما أعاني، وخشيتي أن يتضاعف الألم عليَّ.
قالوا: توكَّل على الله، والله يعينك. ونحن في انتظارك.
محاضرات في جامعات الجزائر ومعاهدها:
وأنا رجل أضعف كثيرًا أمام الإلحاح، وإن كلفني ما كلفني، فلم أجد بدًّا من الاستجابة إلى ما طلبوا، وتوطين نفسي على أن أقوم بالمحاضرات المطلوبة. وكان عدد منها في جامعات العاصمة ومعاهدها. وقد نسيت أسماءها، ولكن الذي أذكره: أن بعضًا منها اضطرني إلى أن أصعد على رجلي - برغم وجعها - سلمًا من دورين. وكان هذا في غاية المشقة علي، ولكن المعين هو الله.
كانت عودتي بهذه الصورة، وأنا لا أقدر أن أحمل رجلي: مشهدًا مؤلمًا لأحبتي الذين ودّعتهم، وأنا في غاية النشاط، فإذا بهم يفاجئون بمنظري الذي لم يتوقعوه أبدًا.
محاضرة في جامعة وهران:
وكانت هناك محاضرة في جامعة وهران، وقد ذهبت إليها بالطائرة، واستقبلوني هناك استقبالًا حافلًا، وقالوا: نشكرك مرتين: مرة على استجابتك، ومرة على استجابتك على رغم تعبك وألمك. ونحن سنساعدك بقدر ما نستطيع على توفير الراحة لك، وأجرك على الله.
ولكن هناك أشياء تفرض نفسها لا حيلة فيها: مثل الدَّرَج في مدخل الجامعة، حين تصعد نحو عشر درجات أو أكثر، فهم لم يحسبوا حساب الضعفاء والمرضى.
وبقيت هناك يومين على ما أذكر ثم عدت إلى العاصمة، لأبقي بها يومًا أو يومين، ثم أسافر منها إلى القاهرة، ومنها إلى الدوحة.
وودّعت إخواني وأحبتي على الرغم مني، وهم يبكون وأنا أبكي، فقد كان المأمول أن أبقى مدة أطول، ولكن الظروف التي ألّمَّت بي تحتِّم عليّ أن أسرع بالعودة، لاستكمال علاج ما أصابني من قَرْح.
درس وعبرة:
سبحان الله: ما أعظم غرور الإنسان حين يعجب بقوته! وما أعجزه وأضعفه حين يفقدها، أو يفقد شيئًا منها! ثم ما أشد عجزه مرة أخرى حين لا يعرف متى يفقدها، فيفاجأ بفقدها أشد ما يكون حاجة إليها!
لقد كنت قبل هذه الحادثة مُعجبًا بما آتاني الله من قدرة على الحركة والنشاط، ومواصلة الأسفار في الشرق والغرب والشمال والجنوب، معتقدًا أن ما منحني الله من تكوين جسمي يساعدني على أداء مهمتي، فقد ساعدتني نشأتي الريفية البسيطة على تعوّد المشقات، فلم أولد وفي فمي ملعقة من ذهب ولا فضة، وربما ولا من حديد. ولكنا كنا نأكل الأكل الطبيعي الذي لم تمسه الكيمياويات، ونشرب اللبن الطبيعي، ونأكل اللحم الطبيعي، والبيض الطبيعي. فكل شيء فيه بركة. لم أتعود الحركات الرياضية المنظمة، فلم يكن في قريتنا ناد رياضي، ولكن كنا نلعب لعب أبناء القرى من الركض والقفز والتسابق في مثل هذه الألعاب، وكنا نمشي المسافات الطويلة ولا نكل ولا نمل.
ونشأنا نشأة مستقيمة؛ فلم نعرف طريق المسكرات ولا المخدرات، وحتى التدخين، لم أدخن سيجارة في حياتي لا جادًّا ولا لاعبًا؛ فحفظ الله شبابنا بالاستقامة والطهارة... ولما انضممت إلى جماعة الإخوان المسلمين: علمتنا بعض السلوكيات الرياضية، وربّتنا على بعض الأعمال التي تزيدنا قوة على قوة. وما شكوت في شبابي من أمراض خطيرة، إلا ما أصابني في الصبا من البلهارسيا والإنكلستوما، وهما من الأمراض المتوطنة في مصر. وقد عولجت منهما في صباي، والحمد لله.
وكنت أحس أن تكويني العظمى قوي، وكنت قبل أن أصاب برجلي، أصعد السلّم وثبًا، وأنزله ركضًا، وكان خالي رحمه الله ، ينظر إليّ وأنا أفعل ذلك في منزلنا بشبرا، ويقول: الحمد لله، الذي حفظ عليك صحتك!
ولكن كل بناية وإن شمخت، وكل ماكينة وإن أتقن صنعها، لها عمر افتراضي... وكذلك الإنسان، وأحمد الله أننا أفضل كثيرًا من أبناءنا وأحفادنا، فإني أراهم يشكون صغارًا، مما نشكو منه كبارًا. يشكون من عظامهم وأسنانهم وأضراسهم، وأنا بفضل الله لم أخلع إلا ضرسين أو ثلاثة، ولا تزال أظافري قوية صلبة إلى اليوم، حتى إني لا أستطيع أن أقص أظافر رجليَّ، إلا بعد أن أنفعلها في الماء مدّة من الزمن حتى تلين، ويسهل قصّها.
من الجزائر إلى القاهرة:
سافرت من الجزائر عائدًا إلى مصر، وكنت مدعوًا إلى محاضرة في جامعة القاهرة بدعوة من نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي السلمي. ولكني قبل أن أذهب إلى الجامعة، طلبت من إخواني في القاهرة أن يرشحوا لي طبيبًا مختصًا، يراني، ويصف لي بعض ما يخفف وجعي. فأرسلوا إلي الأخ الدكتور عزت كامل طبيب العظام، وزوج ابنة الدكتور أحمد الملط رحمه الله .
وجاء د. عزت حفظه الله وقال: هناك ماء يتجمع في الرجل، لا تستريح إلا بشفطه. وقد فعل ذلك، واسترحت إلى حين.
منعي من المحاضرة في جامعة القاهرة:
وبعد ذلك ذهبت إلى جامعة القاهرة في الجيزة، لأقوم بأداء محاضرتي، فوجدت الحرس الجامعي، يحيط بي من كل جانب، وقد منعوني من الدخول، فأطلعتهم على الدعوة التي وصلتني من نائب رئيس الجامعة، فجاء رئيس الحرس، وأذكر أن اسمه الدكتور محمد عبد اللطيف، وقال لي: يا دكتور قرضاوي: إن عندنا أمرًا مباشرًا من وزير الداخلية نفسه «زكي بدر» بمنعك من الدخول. قلت: وإن كانت معي دعوة رسمية من الجامعة؟ قال: هذه الدعوة لا تعترف بها الداخلية. وأنا والله من قرائك والمستفيدين من كتبك، والمحبين لك، ولكن لا أملك من الأمر شيئًا.
وكان الطلاب قد سمعوا بمجيئي عند باب الجامعة، فتجمهروا، وأرادوا أن يحدثوا ضجَّة، فأشرت لهم: أن لا ضرورة لذلك، وإن مع اليوم غدًا، وإن غدًا لناظره لقريب.
محاضرة في مسجد آل عزام بحلوان:
وفي نفس الليلة، دعاني أخونا الكريم، المحامي الوطني الكبير الأستاذ محفوظ عزام: أن أذهب إلى مسجدهم في حلوان لإلقاء محاضرة هناك، وقال لي: هناك جمهور كبير يتشوَّق إليك. فقلت: على بركة الله، لعل هذا يكون تعويضًا عن محاضرة جامعة القاهرة.
وتوكّلت على الله، وذهبت إلى مسجد آل عزام بحلوان، وألقيت محاضرتي التي شهدها جمٌّ غفير، وكانت المحاضرة عن الشورى والديمقراطية، وموقف الإسلام منها، وتحدثت عنها الصحف بعد ذلك، وبخاصة مجلة «منبر الإسلام» المصرية التي تصدرها وزارة الأوقاف المصرية، وقد نقلت معظم المحاضرة، ووضعت صورتي على غلاف المجلة.
من القاهرة إلى الدوحة:
وفي اليوم التالي، امتطيت طائرة الخليج إلى الدوحة، ففوجئت أسرتي بما أصبت به في رجلي ... لقد خرجت من الدوحة سليمًا نشيطًا لا أشكو من شيء، واليوم أعود وإحدى رجلي كما يرونها! ماذا جرى؟
فقصصت عليهم القصة، فقالوا: هذه نتيجة الأسفار التي لا تنتهي: مرة تصاب في ظهرك، وأنت في المشرق ولا أحد معك، ومرة تصاب في رجلك، وأنت في المغرب، ولا أحد معك.
قلت: هذا ليكفِّر الله من سيئاتنا وما أكثرها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب، ولا هم ولا غم، ولا أذى ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»(3)... وأنا أرجو أن يكون كل ما يصيبني من أوجاع في سفري أو في حضري كفارة لخطاياي، حتى يقيلني الله منها، وينقيني من آثارها، كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.
معالجة طبيب برازيلي:
وبعد أيام قليلة ذهبت إلى قسم العظام بالمستشفى، وبعد الكشف المعتاد طلبوا الكشف بطريقة الأشعة، وبعد ذلك قالوا لي: هنا طبيب برازيلي ممتاز، جيء به من أجل لاعبي الكرة، ومعالجتهم من إصاباتهم في الملاعب، ويمكنه أن يعمل لك عملية جراحية بالمنظار، تستريح بعدها كثيرًا. قلت: لا مانع، على بركة الله.
وفي الوقت الموعود، ذهبت إلى الطبيب المعهود، فرحّب بي، وقال: سنعمل لك العملية بالتخدير الموضعي، وستخرج بعدها تمشي بدون أي مساعدة.
وفعلًا أجرى العملية، وأنا أراه في أثناء إجرائها على التلفزيون، حتى أتمها بنجاح، وبعدها بقيت دقائق، ثم خرجت من المستشفى، وعدت إلى البيت، وكانت من أسرع العمليات التي أجريتها في حياتي، وأحمدها أثرًا، ولله الحمد والمنّة.
.................
(1) رواه أحمد (1462)، قال مخرجوه: إسناده حسن، عن سعد بن أبي وقاص.
(2) رواه أحمد في «المسند»(5365)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو داود في الزكاة (1672) عن ابن عمر.
(3) رواه البخاري في المرضى (5641) عن أبي هريرة.



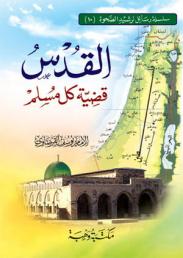 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






