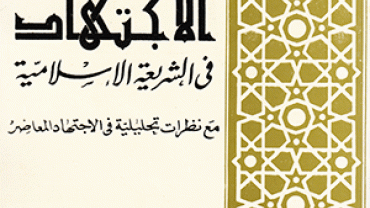د. يوسف القرضاوي
بينا في مقال سابق أن الدولة في الإسلام دولة مدنية كغيرها من دول العالم المتحضر، وتتميز بأن مرجعيتها الشريعة الإسلامية.
وفي هذا المقال نبين أن هذه الدولة المدنية تقوم على الشورى والبيعة واختيار الأمة لحاكمها بإرادتها الحرة، وعلى نصحه ومحاسبته، وإعانته على الطاعة، ورفض طاعته إذا أمر بمعصية، وتقويمه بالحسنى، وحقها في عزله إذا أصر على عوجه وانحرافه.
وهذا التوجه يجعل الدولة الإسلامية أقرب ما تكون إلى إلى جوهر الديمقراطية.
الديمقراطية المنشودة
ونعني بالديمقراطية في هذا المقام: الديمقراطية السياسية. أما الديمقراطية الاقتصادية، فتعني (الرأسمالية) بما لها من أنياب ومخالب، فإننا نتحفظ عليها. وكذلك الديمقراطية الاجتماعية التي تعني (الليبرالية) بما يُحمّلونها من حرية مطلقة، فإننا كذلك نتحفظ عليها.
إن الرأسمالية (القارونية) مرفوضة عندنا، لأنها تقوم على فكرة الرأسمالي الذي يقول عن ماله: {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص:78]، أو كما قال قوم شعيب له: {أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود:87]، والفكرة الإسلامية أن الإنسان مستخلف في مال الله، {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد:7]، وأن المالك الحقيقي للمال هو الله، والغني أمين على هذا المال، وكيل عن مالكه الحقيقي، فملكيته مقيدة، عليها تكاليف وواجبات، وتقيدها قيود في الاستهلاك والتنمية والتوزيع والتبادل. وتفرض عليها الزكاة التي عدت من أركان الإسلام، كما يُمنع المالك من الربا والاحتكار والغش والغبن والسرف والترف والكنز وغيرها[1].
وبهذه الوصايا والقوانين وأمثالها، نقلّم أظفار أخطار الرأسمالية، حتى نحقق العدالة الاجتماعية، ونرعى الفئات الضعيفة في المجتمع من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ونعمل على حسن توزيع المال {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر:7]. وبهذا يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى الحد من طغيان الأغنياء، والرفع من مستوى الفقراء، فيقرب الشقة بين الفريقين ما أمكن ذلك.
والليبرالية التي تعني (الحرية المطلقة) مرفوضة أيضا عندنا، فليس في الوجود كله حرية مطلقة، كل حرية في الدنيا لها قيود تحدها، من هذه القيود: حقوق الآخرين، ومنها: حق الفرد نفسه، ومنها: قيود دينية تتعلَّق بحق الله سبحانه، ومنها: قيود أخلاقية.
إن البواخر في المحيطات الواسعة مقيدة في سيرها بخطوط معروفة، تحددها الخارطة و(البوصلة). ومثل ذلك الطائرات في جو السماء، لا تذهب يمنة ويسرة، كما يشاء قائدها، بل له خط سير يجب أن يتبعه ولا يحيد عنه.
الذي يعنينا من الديمقراطية هو الجانب السياسي منها، وجوهره أن تختار الشعوب من يحكمها ويقود مسيرتها، ولا يفرض عليها حاكم يقودها رغم أنفها. وهو ما قرَّره الإسلام عن طريق الأمر بالشورى والبيعة، وذم الفراعنة والجبابرة، واختيار القوي الأمين، الحفيظ العليم، والأمر باتِّباع السواد الأعظم، وأن يد الله مع الجماعة، وقول الرسول لأبي بكر وعمر: "لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما"[2]، إذ سيكون صوتان أمام واحد.
ومن حق كل امرئ في الشعب أن ينصح للحاكم، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، مراعيا الأدب الواجب في ذلك. وأن يطيعه في المعروف، ويرفض الطاعة في المعصية المجمع عليها، أي المعصية الصريحة البينة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والذي يهمنا اقتباسه من الديمقراطية هو ضماناتها وآلياتها التي تمنع أن تزيف وتروج على الناس بالباطل. فكم من بلاد تحسب على الديمقراطية، والاستبداد يغمرها من قرنها إلى قدمها، وكم من رئيس يحصل على (99%) تسعة وتسعين في المائة، وهو مكروه كل الكراهية من شعبه.
إن أسلوب الانتخابات والترجيح بأغلبية الأصوات، الذي انتهت إليه الديمقراطية هو آلية صحيحة في الجملة، وإن لم تَخْل من عيوب، لكنها أسلم وأمثل من غيرها[3]. ويجب الحرص عليها وحراستها من الكذابين والمنافقين والمُدلِّسين.
أما دعوى بعض المتدينين: أن الديمقراطية تعارض حكم الله، لأنها حكم الشعب، فنقول لهم: إن المراد بحكم الشعب هنا: أنه ضد حكم الفرد المطلق، أي حكم الديكتاتور، وليس معناها أنها ضد حكم الله، لأن حديثنا عن الديمقراطية في المجتمع المسلم، وهو الذي يحتكم إلى شريعة الله[4].
الديمقراطية وصلتها بالإسلام
ويحسن بنا بمناسبة حديثنا عن الديمقراطية: أن نذكر هنا موقف الإسلام من الديمقراطية، فقد رأينا الذين يتحدثون عن الديمقراطية وصلتها بالإسلام عدة أصناف متباينة:
1- الرافضون للديمقراطية باسم الإسلام
صنف يرى أن الإسلام والديمقراطية ضدَّان لا يلتقيان، لعدة أسباب:
أ- أن الإسلام من الله والديمقراطية من البشر.
ب- وأن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب، والإسلام يعني حكم الله.
ت- وأن الديمقراطية تقوم على تحكيم الأكثرية في العدد، وليست الأكثرية دائما على صواب.
ث- وأن الديمقراطية أمر مُحدَث وابتداع في الدِّين، ليس له سلف من الأمة، وفي الحديث: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"[5]، و"مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"[6].
ج- وأن الديمقراطية مبدأ مستورد من الغرب النصراني أو العلماني الذي لا يؤمن بسلطان الدِّين على الحياة، أو الملحد الذي لا يؤمن بنبوة ولا ألوهية ولا جزاء، فكيف نتخذه لنا إماما؟
بناء على هذا يرفض هؤلاء الديمقراطية رفضا باتًا، وينكرون على مَن ينادي بها أو يدعو إليها في ديارنا، بل قد يتهمونه بالكفر والمروق من الإسلام. فقد صرَّح بعضهم بأن الديمقراطية كفر!
2- القائلون بالديمقراطية بلا قيود
على عكس هؤلاء، آخرون يرون أن الديمقراطية الغربية هي العلاج الشافي لأوطاننا ودولنا وشعوبنا، بكل ما تحمله من معاني الليبرالية الاجتماعية، والرأسمالية الاقتصادية، والحرية السياسية.
ولا يقيد هؤلاء هذه الديمقراطية بشيء، وهم يريدونها في بلادنا، كما هي في بلاد الغربيين، لا تستند إلى عقيدة، ولا تحثُّ على عبادة، ولا تستمد من شريعة، ولا تؤمن بقِيَم ثابتة، بل هي تفصل بين العلم والأخلاق، وبين الاقتصاد والأخلاق، وبين السياسة والأخلاق، وبين الحرب والأخلاق.
وهذا هو منطق (التغريبيين) الذين نادوا من قديم، بأن نسير مسيرة الغربيين، ونأخذ حضارتهم بخيرها وشرِّها، وحلوها ومرها[7]!
3- الوسطيون المتوازنون
وبين هؤلاء وأولئك: تقف فئة الوسط التي ترى أن خير ما في الديمقراطية -أو قل: جوهر الديمقراطية- متفق مع جوهر تعاليم الإسلام.
جوهر الديمقراطية: أن يختار الناس مَن يحكمهم، ولا يُفرض عليهم حاكم يكرهونه ويرفضونه يقودهم بعصاه أو سيفه. وأن يكون لديهم من الوسائل: ما يقوِّمون به عوجه، ويردونه إلى الصواب إذا أخطأ الطريق، وأن تكون لديهم القدرة على إنذاره إذا لم يرتدع، ثم عزله بعد ذلك سلميا.
وإذا اختلف معه أهل الحل والعقد - أو مجلس الأمة أو الشعب أو مجلس النواب، سمِّه ما شئت - فإن كان في أمر شرعي: رُدَّ التنازع إلى الله ورسوله كما أمر القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء:59]، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالرد إلى الله: الرد إلى كتابه. وبالرد إلى رسول الله: الرد إلى سنته.
والذين يرجع إليهم في هذا هم الراسخون في العلم، الخبراء وأهل الذكر في العلم الشرعي: علم الكتاب والسنة والفقه وأصوله، الذين يجمعون بين فقه النصوص الجزئية وفقه المقاصد الكلية، والذين يجمعون بين فقه الشرع وفقه الواقع، أعني فقه العصر الذي يعيشون فيه وما فيه من تيارات ومشكلات وعلاقات، كما قال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء:83].
وأما في أمور الحياة المختلفة: التي تدخل في دائرة المباحات، فعند الاختلاف في شأنها - كما هو شأن البشر في الأمور الاجتهادية - لا بد من مرجِّح بعد شرحها من أهل الاختصاص، والمرجِّح هو الأغلبية، فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الفرد. وهناك أدلة شرعية على ذلك، لا يتسع المقام لسردها. فلتراجع في كتابنا (من فقه الدولة في الإسلام).
ولا يعيب الديمقراطية أنها من اجتهادات البشر، فليس كل ما جاء عن البشر مذموما، كيف وقد أمرنا الله أن نُعمِل عقولنا، فنفكِّر وننظر، ونتدبَّر ونعتبر، ونجتهد ونستنبط؟ ولكن يُنظَر في هذا الاجتهاد: أهو مناقض لما جاء من عند الله أم لا يتعارض معه، بل يمشي في ضوئه؟ وقد رأينا الديمقراطية تجسِّد مبادئ الشورى، والنصيحة في الدِّين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والصبر، وإقامة العدل، ورفع الظلم، وتحقيق المصالح ودفع المفاسد ... وغيرها.
وما قيل من أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، فليس يعني: أنه في مقابلة حكم الله، بل حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد المطلق.
وما قيل: إنه مبدأ مستورد، فالاستيراد في ذاته ليس محظورا، إنما المحظور أن تستورد ما يضرك ولا ينفعك، وأن تستورد بضاعة عندك مثلها أو خير منها، ونحن نستورد من الديمقراطية: آلياتها وضماناتها، ولا نأخذ كل فلسفتها التي تغلو في تضخيم الفرد على حساب الجماعة، وتبالغ في تقرير الحرية ولو على حساب القِيَم والأخلاق، وتعطي الأكثرية الحق في تغيير كل شيء، حتى الديمقراطية ذاتها!!
نحن نريد ديمقراطية المجتمع المسلم، والأمة المسلمة، بحيث تراعي هذه الديمقراطية عقائد هذا المجتمع وقِيمه وأسسه الدِّينية والثقافية والأخلاقية، فهي من الثوابت التي لا تقبل التطور ولا التغيير بالتصويت عليها.
الشورى والديمقراطية[8]
وكثير من الذين يتحدثون عن الديمقراطية، وأن لها في أحكام الإسلام أصولا وجذورا: يركِّزون على قاعدة (الشورى) في الإسلام، ويعتبرون الشورى هي البديل الإسلامي للديمقراطية، وهي أيضا الدليل الشرعي للديمقراطية.
وكان بعض إخواننا في الجزائر يقولون: ( شورقراطية)، أي شورى متضمنة للديمقراطية.
وفي رأيي أننا نستطيع أن ندعم القضية بأكثر من ذلك، وأن الشورى وحدها قد لا تكفي هنا لسببين:
أولهما: أن هناك من الفقهاء من زعم أن الشورى ليست واجبة، وإنما هي من قبيل المندوبات والمستحبات، فهي من المكملات وليست من المؤسِّسات. خلافا لما قاله المحققون من أمثال العلاَّمة ابن عطية، وأقرَّه الإمام القرطبي في تفسيره: (الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومَن لا يستشير أهل العلم والدِّين، فعزله واجب، وهذا ما لا خلاف فيه)[9].
وثانيهما: أن هناك من الفقهاء أيضا من قالوا: إن الشورى معلمة وليست ملزمة. وحتى من سلَّم أن الشورى واجبة وفريضة دينية، يقول: أن الواجب على الحاكم أو الإمام أن يستشير أهل الرأي والبصيرة والخبرة، حتى إذا استنار له الطريق، مضى في سبيله بما يراه وتحمَّل المسؤولية وحده، وليس من الضروري أن ننزل على رأيهم، مستدلين بقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران:159].
ونحن لا نقر هذين الأمرين، ولنا رد على كل منهما مذكور في مواضعه من كتبنا[10]، ولكن مجرد إثارتهما قد يضعف لدى بعض الناس من الاعتماد على الشورى وحدها.
ورأيي أن الواجب علينا هنا: أن نضيف مبادئ أو مؤيدات أخرى تؤكذ شرعية الديمقراطية الحقيقية وقربها من جوهر الإسلام.
من هذه المؤيدات:
1- رفض سلطان الجبابرة والفراعنة
أول هذه المبادئ المؤيدة لشرعية الديمقراطية، وحكم الشعوب لنفسها، واختيارها مَن يحكمها ويقودها: أن القرآن الكريم ينكر أبلغ الإنكار، بل يذم أبلغ الذم: الجبابرة الذين يتسلطون على الشعوب، ويحكمونها رغم أنوفها، ويقودونها طوعا أو كرها - بل غالبا ما يقودونها كرها - إلى ما يريدون.
وفي هذا ذم القرآن مُلك صاحب إبراهيم -الذي يسمونه (نمروذ): {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ...} [البقرة:258].
وقد ذكر المفسرون: أنه جاء برجلين من عرض الطريق، فحكم عليهما بالإعدام، ثم نفذ الحكم في أحدهما وضربه بالسيف، وقال: ها أنا قد أمتُّه! وعفا عن الآخر، وقال: ها أنا ذا قد أحييته![11]
ومثل ذلك حكم فرعون الذي قال القرآن في شأنه: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [القصص:4].
كما ذم القرآن تسلط الجبابرة في الأرض بصفة عامة، فقال: {وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} [ابراهيم:15]، وقال: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} [غافر:35].
وذم كذلك الشعوب التي تسير في ركاب الجبابرة المستكبرين في الأرض وتنقاد لهم طائعة، كما قال عن فرعون: {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ} [الزخرف:54]، وقال عن ملأ فرعون أيضا: {فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ} [هود:98،97].
وذم القرآن عادا قوم هود لتفريطهم في حريتهم وكرامتهم واتباعهم الجبابرة المتسلطين، فقال: {وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} [هود:59].
وحكى القرآن نصيحة نبي الله صالح لقومه ثمود إذ قال لهم: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ} [الشعراء:152،151،150].
وبهذا نرى أن من مبادئ القرآن وأهدافه: أن يحرر الأقوام والشعوب من تسلط الفراعنة والجبابرة المتألهين في الأرض، وأن يرفع جباههم فلا تسجد إلا لله الذي خلقهم، ويعلي رؤوسهم فلا تنحني إلا له سبحانه. فلا يحكم الناس ولا يقودهم نمروذ ولا فرعون، وإنما يقودهم رجل منهم، هم الذين يختارونه، وهم الذين يراقبونه ويحاسبونه، وهم الذين يعزلونه -عند انحرافه- ويسقطونه. كما قال أبو بكر الخليفة الأول في أول خطبة له بعد تولية الخلافة: إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسدِّدوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم[12] اهـ.
2- اتباع الجماعة والسواد الأعظم
وهناك نصوص شرعية، وأحاديث نبوية، تأمر المسلمين أن يكونوا مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة، وأن يتبعوا السواد الأعظم[13]، أي جمهور الناس، وأن يهتموا برؤية المؤمنين للأشياء والوقائع والأشخاص، فإن رؤيتهم معتبرة عند الله وعند الناس، كما قال الله تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة:105]، فجعل رؤيتهم للعمل مقارنة لرؤية الله ورسوله.
وقال في آية أخرى: {كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا} [غافر:35]، فجعل مقت الذين آمنوا وسخطهم بجوار مقت الله تعالى.
ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند الله قبيح[14].
3- عدم قبول صلاة الإمام الذي يكرهه المأمومون
ثبت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا (وهذا كناية عن عدم قبولها عند الله): رجل أمَّ قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان"[15].
ومعنى هذا: أن الإمام في الصلاة يجب أن يكون ممن يحبهم المأمومون، وإذا أحسَّ بغير ذلك: يجب أن يتخلى عن هذه الإمامة، وإلا ارتدت صلاته عليه، أو بقيت معلقة لا تقبل عند الله.
فإذا كان هذا في الإمامة الصغرى، فكيف بالإمامة الكبرى! إمامة الأمة في شؤونها كلها، التي تشمل دينها ودنياها؟
وفي الحديث الصحيح: "خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم (أي يدعون لكم وتدعون لهم)، وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنونكم"[16]، فأساس الصلة بين الحاكم والمحكومين: هو الثقة والمحبة المتبادلة بينهم. لا التباغض ولا التلاعن، الملازم للحكم المستبد الذي يقوم على القهر والجبروت.
وأحيل القارئ الكريم إلى أن يقرأ ما كتبته عن الديمقراطية وصلتها بالإسلام في كتابي (من فقه الدولة في الإسلام)



 فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة