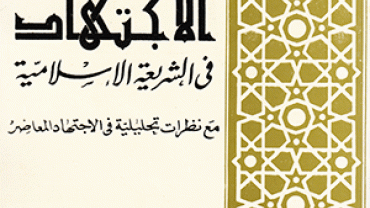السؤال: قرأتُ كتابكم " فوائد البنوك هي الربا الحرام"، واقتنعتُ بما جاء فيه من آراء، وما قام عليه من أدلَّة مستمدَّة من كتاب الله تعالي، ومن سنة رسوله صلي الله عليه وسلم، ومن أقوال فقهاء الأمة العظام، ونويتُ والحمد لله أن أستغني بالحلال عن الحرام، وبالطيب عن الخبيث، وأن أَدَعَ ما يَريبني إلي ما لا يَريبني، معتقدًا أن القليل من الحلال فيه البركة، وهو خير وأنفع في الدنيا والآخرة من الحرام وإن كان كثيرًا.
وسؤالي الآن عن الفوائد المتجمِّعة في بعض البنوك حاليا! ماذا أصنع فيها؟ هل أتركها للبنك يتصرَّف فيها كيف يشاء؟ أو آخذها لأدفعها في بعض المكوس والضرائب التي تفرضها عليَّ الحكومة، وكثيرًا ما تكون جائرة، أو أدفعها في المحروقات مثل بنزين السيارة، وغاز المطبخ ونحوها، كما قال لي بعض الناس، أو أدفعها للفقراء وللأعمال الخيرية، مع أن الحديث الشريف يقول: "إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبا"؟
أرجو من فضيلتكم بيان ما يجوز لي من ذلك، ولا سيما أن هذه المسألة تُهِمُّ كثيرين قد تتجمَّع لهم فوائد تحسب بالملايين في البنوك، كما تُهِمُّ كلَّ مَن اكتسب مالاً من حرام ويريد أن يتوب ويتطهَّر! ماذا يفعل في هذا المال الخبيث، حتي يلقي الله بريء الذمَّة مقبول التوبة. نصر الله بكم الدين، ونفع بكم المسلمين!!
جواب فضيلة الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أسأل الله للأخ السائل الكريم أن يثبِّت قدميه علي الحقِّ، وأن يكفيه بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمَّن سواه، وأحمد الله تعالي أن الكثيرين من أبناء أمتنا لا زالوا بخير، ولم ينخدعوا بالفتاوي المتسيِّبة التي لا زمام لها، والتي خرقت ما أجمعت عليه المجامع العلمية والمؤتمرات العالمية، والندوات المتخصِّصة، في عدد من عواصم الإسلام، والتي أجمعت كلُّها علي أن الفوائد هي الربا الحرام.
أما ما سأل عنه الأخ بالنسبة للفوائد البنكية التي تجمَّعت له، فشأنها شأن كلِّ مال مكتسب من حرام، لا يجوز لمَن اكتسبه أن ينتفع به، لأنه إذا انتفع به فقد أكل سحتًا، ويستوي في ذلك أن ينتفع به في الطعام والشراب أو اللباس أو المسكن، أو دفع مستحقَّات عليه لمسلم أو غير مسلم، عادلة أو جائرة ومن ذلك دفع الضرائب وإن كانت ظالمة للحكومات المختلفة، لأنه هو المنتفع بها لا محالة، فلا يجوز استخدامها في ذلك، وكذلك دفعها في (المحروقات)، بل هذا من باب أولي، وإن كنتُ سمعتُ عن بعض المشايخ في الخليج أنه أجاز استخدام الفوائد في مثل ذلك، وفي بناء مرحاض أو نحوه من الأشياء التي تفتقد الطهارة. وهي فتوي عجيبة لا تقوم علي فقه سليم، فالشخص في النهاية هو المنتفع بهذا المال الحرام في مصلحته الشخصية، فلا يجوز للشخص الاستفادة من المال الحرام لنفسه أو لأهله، إلا أن يكون فقيرًا أو غارمًا يحقُّ له الأخذ من الزكاة.
وأما ترك هذه الفوائد للبنوك، فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن البنك إذا أخذها لنفسه ففي ذلك تقوية للبنك الربوي، ومعاونة له علي المضي في خطَّته، فهذا يدخل في الإعانة علي المعصية، والإعانة علي الحرام حرام، كما بيَّنا ذلك في الباب الأول من كتابنا (الحلال والحرام في الإسلام).
ويزداد الإثم في ذلك بالنظر للبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا، والتي يودع فيها كثير من أغنياء المسلمين أموالهم للأسف الشديد، فإن ترك هذه الفوائد لها فيه خطر كبير. فهذه البنوك تتبرَّع بهذه الأموال عادة للجمعيات الخيرية، وهي في الأعمِّ الأغلب جمعيات كنسية تبشيرية، وكثيرًا ما تكون هذه الجمعيَات ممَّن يعمل في بلاد المسلمين. ومعني هذا أن أموال المسلمين تؤخذ لتنصير المسلمين، وفتنتهم عن دينهم، وسلخهم عن هويتهم!
والخلاصة
أن ترك الفوائد للبنوك وبخاصَّة الأجنبية حرام بيقين، وقد صدر ذلك عن أكثر من مجمع، وخصوصًا مؤتمر المصارف الإسلامية الثاني في الكويت.
أما الأمر المشروع في هذا المقام، فهو دفع هذه الفوائد ومثلها كلُّ مال من حرام في جهات الخير، كالفقراء والمساكين، واليتامي وابن السبيل، والجهاد في سبيل الله، ونشر الدعوة إلي الإسلام، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، وإعداد الدعاة الواعين، وطبع الكتب الإسلامية، وغير ذلك من ألوان البرِّ، وسُبُل الخير.
وقد نوقش هذا الموضوع في أحد المجامع الإسلامية، وكان لبعض الأخوة من العلماء تحفُّظ علي إعطاء هذه الفوائد للفقراء والمشروعات الخيرية، إذ كيف نطعم الفقراء الخبيث من المكاسب؟ وكيف نرضي للفقراء ونحوهم ما لا نرضاه لأنفسنا؟
والحقُّ أن هذا المال خبيث بالنسبة لمَن اكتسبه من غير حلِّه، ولكنه طيِّب بالنسبة للفقراء وجهات الخير.
هو حرام عليه، حلال لتلك الجهات. فالمال لا يخبث في ذاته، إنما يخبث بالنسبة لشخص معيَّن لسبب معيَّن. وهذا المال الحرام لا بد أن يتصرَّف فيه بأحد تصرُّفات أربعة، لا خامس لها بحسب القسمة العقلية:
الأول: أن يأخذ هذا الحرام لنفسه أو لمَن يعوله، وهذا لا يجوز، كما بيَّناه.
الثاني: أن يتركه للبنك الربوي، وهذا لا يجوز أيضًا، كما ذكرنا.
الثالث: أن يتخلَّص منه بالإتلاف والإهلاك، وهذا قد روي عن بعض المتورِّعين من السلف، وردَّ عليهم الإمام الغزالي في (الإحياء) فقد نهينا عن إضاعة المال.
الرابع: أن يُصرَف في مصارف الخير، أي للفقراء والمساكين واليتامي وابن السبيل، وللمؤسَّسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية، وهذا هو الوجه المتعيِّن.
وأودُّ أن أبيِّن هنا أن هذا ليس من باب الصدقة، حتي يقال: "إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبا" [1].
إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام في مصرفه الوحيد، فهو هنا ليس متصدِّقا، ولكنه وسيط في توصيل هذا المال لجهة الخير. ويمكن أن يقال: إنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه.
وقد سمعتُ بعض الناس يقول: إن هذه الفوائد البنكية، إنما هي ملك للمقترضين الذين اقترضوا ما يحتاجون إليه من البنك، والأصل أن تردَّ هذه الأموال إلي أصحابها.
والواقع أن هؤلاء المقترضين قد انقطعت صلتهم بهذه الفوائد، وفقًا للعقد الذي بينهم وبين البنك، ولهذا أصبحت معدودة في عداد المال الذي لا يعلم له مالك معيَّن.
وقد عرض الإمام أبو حامد الغزالي لهذا النوع من المال، وهو ما يكون لمالك غير معيَّن، وقع اليأس من الوقوف علي عينه. قال: فهذا لا يمكن الردُّ فيه للمالك، ويوقف حتي يتَّضح الأمر فيه، وربما لا يمكن الردُّ لكثرة الملاَّك، كغلول الغنيمة. فهذا ينبغي أن يُتصدَّق به. أي نيابة عن الملاَّك.
قال الغزالي: (فإن قيل: ما دليل جواز التصدُّق بما هو حرام؟ وكيف يتصدَّق بما لا يملك؟ وقد ذهب جماعة إلي أن ذلك غير جائز، لأنه حرام، وحُكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان، فلما علم أنهما من غير وجههما، رماهما بين الحجارة، وقال: لا أتصدق إلا بالطيِّب، ولا أرضي لغيري ما لا أرضاه لنفسي!
فنقول: نعم ذلك له وجه واحتمال. وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس.
أما الخبر
فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم، بالتصدُّق بالشاة المصلية التي قدِّمت إليه فكلَّمته بأنها حرام، إذ قال صلي الله عليه وسلم: "أطعموها الأساري" [2].
ولما نزل قوله تعالي: {ألم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [الروم:1-3]، كذبه المشركون وقالوا للصحابة: ألا ترون ما يقول صاحبكم، يزعم أن الروم ستَغلب. فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه، بإذن رسول الله صلي الله عليه وسلم، فلما حقَّق الله صدقه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه، بما قامرهم به، قال عليه الصلاة والسلام: "هذا سحت، فتصدَّق به". وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول الله صلي الله عليه وسلم له في المخاطرة مع الكفار [3].
وأما الأثر: فإن ابن مسعود رضي الله عنه، اشتري جارية، فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن فطلبه كثيرًا فلم يجده، فتصدَّق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي.
وسئل الحسن رضي الله عنه، عن توبة الغال (مَن يأخذ من مال الغنيمة قبل أن يقسم، وما يؤخذ منه بعد تفرُّق الجيش)، فقال: يتصدَّق به.
وروي أن رجلاً سوَّلت له نفسه، فغلَّ مائة دينار من الغنيمة، ثم أتي أميره ليردَّها عليه فأبي أن يقبضها، وقال له: تفرَّق الناس، فأتي معاوية فأبي أن يقبض، فأتي بعض النسَّاك فقال: ادفع خمسها إلي معاوية، وتصدَّق مما يبقي، فبلغ معاوية قوله، فتلهف إذ لم يخطر له ذلك.
وقد ذهب أحمد بن حنبل، والحارث المحاسبي، وجماعة من الورعين إلي ذلك.
فهو أن يقال: إن هذا المال متردِّد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلي خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلي خير أولي من إلقائه في البحر، فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتناه علي أنفسنا وعلي المالك، ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقير سدُّ حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدُّق لا ينبغي أن ينكر، فإن في الخبر الصحيح: أن للزارع والغارس أجرًا في كلِّ ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه [4].
وأما قول القائل: لا نتصدَّق إلا بالطيِّب، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وتردَّدنا بين التضييع وبين التصدُّق، ورجَّحنا جانب التصدُّق علي جانب التضييع.
وقول القائل: لا نرضي لغيرنا ما لا نرضاه لنفسنا، فهو كذلك، ولكنه علينا حرام؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلال إذ أحلَّه دليل الشرع، وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل، وإذا حلَّ فقد رضينا له الحلال.
ونقول: إن له أن يتصدَّق علي نفسه وعياله إذا كان فقيرًا. أما عياله وأهله فلا يخفي، لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله، بل هم أولي من يتصدَّق عليهم.
وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضًا فقير، ولو تصدَّق به علي فقير لجاز، وكذا إذا كان هو الفقير) [5] اهـ.
وهنا قد يسأل سائل: وهل يثاب مَن أخذ الفوائد من البنك الربوي وصرفها في مصرفها الخيري؟
والجواب: أنه لا يثاب ثواب الصدقة، ولكنه يثاب من ناحيتين أخريين:
الأولي: أنه تعفَّف عن هذا المال الحرام، وعن الانتفاع به لنفسه بأيِّ وجه، وهذا له ثوابه عند الله تعالي.
الثانية: أنه كان وسيط خير في إيصال هذا المال إلي الفقراء والجمعيات الإسلامية التي تستفيد منه. وهو مثاب علي هذا إن شاء الله.
[2] رواه أحمد في المسند (22509)، وقال مخرِّجوه: إسناده قوي رجاله رجال الصحيح، والدراقطني في السنن كتاب الأسارى (4/285)، عن رجل من الأنصار، وصححه الألباني في الصحيحية (754).
[3] قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس، وليس فيه أن ذلك كان بإذنه صلي الله عليه وسلم (2/110) ورواه دون قوله: "هذا سحت" فتصدق به: أحمد في المسند (2495)، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي في تفسير القرآن (3193)، وقال: حسن غريب، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (6/426)، والطبراني في الكبير (12/28)، والحاكم في التفسير (2/445)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2551).
[4] إشارة إلى حديث أنس: "وما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة". متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2320)، ومسلم في المساقاة (1553)، وأحمد في المسند (13389)، والترمذي في الأحكام (1382).
[5] إحياء علوم الدين (2/131، 132) ط دار المعرفة بيروت.



 فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين
الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة