وقع حدث آخر آكبر حجمًا، وأعظم خطرًا، وأشد هولًا، بآلاف المرات، بل ملايينها، من حادث التسمم؛ إنه الزلزال المدمر الذي وقع في المنطقة، فغير من حالها، وقلب موازينها رأسًا على عقب، وما زلنا نعاني آثاره المرة إلى اليوم.
إنه نكبة الخامس من حزيران «يونيو» (5/6/1967م) الذي عُرف بـ «حرب الأيام الستة». والذي هزمت فيه «إسرائيل» مصر وسوريا، هزيمة ثقيلة، واستولت على سيناء في مصر، والجولان في سوريا، بضربة خاطفة قاضية، حطمت بها الطيران المصري، بضرب الطيارات وهي رابضة في مطاراتها، فدمرت الطائرات، وخربت المطار، وشلت بذلك سلاح الجو المصري، شللًا كليًّا، لا شللًا نصفيًّا. وأضحت القوات المصرية في سيناء مكشوفة بلا غطاء جوي، يحميها ويحرسها من الضربات الجوية للعدو المتربص.
استيقظنا في الصباح على هذه القارعة الهائلة، وهذا النبأ المفزع، وأخذنا نتتبع الإذاعات والتلفازات، ونشرات الأخبار، لنعرف المزيد عما حدث.
ولم يكن لقطر في ذلك الوقت إذاعة ولا تليفزيون، فكنا نفتح إذاعة مصر، وتليفزيون مصر، فإذا هما يقولان كلامًا، وتقول إذاعة لندن وغيرها كلامًا آخر. ثم عرفنا بعد ذلك أن أكثر البيانات التي كانت تذيعها مصر إنما هي أكاذيب ملفقة، تحاول أن تمسك بها الناس أن يثوروا. فهي تخدعهم بمعسول القول، وأخبار النصر، وإسقاط طائرة في المكان الفلاني، وأخرى في مكان آخر، والناس تصدق هذا الهراء، وتركض من مكان إلى آخر لتبحث عن حطام الطائرة المسقطة، فلا تجد له أثرًا، ولا تسمع له خبرًا.
حتى قال لي الأستاذ صلاح جلال - محرر باب العلوم في «الأهرام» الذي اختير بعد ذلك نقيبًا للصحفيين - وكان يتردد على قطر بين الحين والحين؛ لأن له أصهارًا فيها: إننا كنا - ونحن صحفيون في أكبر جريدة في العالم العربي - نجهل الحقيقة، فكنا نجري مع عوام الناس في الشوارع نبحث عن الطائرات التي أسقطها جيشنا الباسل، لنكتب عنها شيئًا، فنعود بخفي حُنين، كما يقول العرب، أو بغير خف أصلًا.
وكنا نحن في الخارج أكثر فهمًا لما وقع، من أهلينا وإخوتنا في مصر؛ لأن لنا مصادر أخرى لمعرفة ما حدث غير الإذاعة والتليفزيون المصريين.
ومِن أول ما وقعت الحرب؛ ارتفع نبض الشارع العربي والإسلامي، واتقدت شعلة الحماسة للجهاد في صدور الناس من كل جنس ولون، ونادى جمهور الناس: أن حيّ على الجهاد، لمقاومة الصهاينة، والدفاع عن الأقصى والمقدسات.
واستقبلت منظمة التحرير الفلسطينية بالدوحة آلاف الناس يقفون في طوابير طويلة، يريدون تسجيل أسمائهم في المتطوعين لإنقاذ فلسطين. وكان أكثر هؤلاء حماسة: إخواننا من الباكستانيين والأفغانيين وغيرهم من أبناء البلاد الإسلامية، الذين يعيشون في قطر، قائلين: إن المسجد الأقصى ليس ملك الفلسطينيين ولا العرب وحدهم، بل هو ملك المسلمين جميعًا، فعلينا أن نسهم في تحريره وإبعاد العدو عنه.
وأذكر أننا أقمنا مهرجانًا في منظمة التحرير، وكان ممن تكلم فيه العالِم القطري الغيور المعروف الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، فكان مما قاله للشباب الفلسطيني: اعتصموا بحب الله، وتمسكوا بالدين ينصركم الله على عدوكم. فما كان من بعض الشباب الطائش، إلا أن صاحوا وهتفوا في وجه الشيخ: لا دين إلا السلاح!
وكان لهذا الهتاف الجاهل الأهوج: أثر سيء في جمهور الحاضرين، الذين استنكروا هذا القول كل الاستنكار، الذي يدل على غباء قائله، وفقدان وعيه، بحقيقة هذا الصراع بيننا وبين بني صهيون، وأن الدين هو المحرك الأول لهذه الأمة، وهو الذي يبعث هامدها، ويحرك جامدها، ويشعل خامدها، ويوحّد كلمتها، ويصنع بها العجائب، وروائع البطولات، ويعيد إليها أيام خالد وأبي عبيدة وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز.
ولقد قلنا مرارًا: إن إخراج الدين من المعركة هو الذي أضر بهذه القضية أبلغ الضرر؛ لأننا نجرد أنفسنا من أمضى سلاح يحاول عدونا أن يضربنا به. فهو يستغل الدين ويوظفه في تعبئة قواه، وتجنيد رجاله، وهو غير مؤمن به. فكثير من الصهاينة «علمانيون» لا دين لهم، ولكنهم - وإن لم يؤمنوا بالدين - يؤمنون بقوة الدين، وأهمية توظيف الدين في معركتهم.
وكم نادينا قومنا: إننا يجب أن نحاربهم بمثل السلاح الذي يحاربوننا به. فإذا حاربونا باليهودية، حاربناهم بالإسلام، وإذا قاتلونا بالتوراة، قاتلناهم بالقرآن، وإذا قالوا: التلمود، قلنا: السنة النبوية، وإذا قالوا: نعظم السبت، قلنا: نعظم الجمعة، وإذا قالوا: الهيكل، قلنا: المسجد الأقصى.
ولا يفل الحديد إلا الحديد، وحديدنا أقوى من حديدهم؛ لأن ديننا أقوى من دينهم، إذ كيف يكون المنسوخ في قوة الناسخ، وكيف يكون المحرف والمبدل في قوة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟!
كانت الهزيمة ثقيلة، وكان حجم الخسارة ضخمًا، من الناحية المادية، ومن الناحية المعنوية. وقد اعترف عبد الناصر بعد ذلك في (23) يوليو وفي نوفمبر من العام نفسه، بمقدار هول الخسارة وفداحتها، وذكر أعداد المقتولين والمأسورين والمفقودين من الضباط والجنود، وصرح: أن الطريق إلى القاهرة كان مفتوحًا أمام إسرائيل. ولم يكن هناك جندي واحد يعوق تقدم إسرائيل لو أرادت.
كما أعلن أرقامًا فادحة عن خسارة مصر في هذه المعركة المشئومة، فذكر: أن مصر خسرت في هذه الحرب (80%) من سلاحها، و (10.000) جندي، و (1500) ضابط، وأُسر (5000)، و (500) ضابط لم يعد أكثرهم! هذا حديث عبد الناصر، وقد سمعناه بآذاننا.
وتذكر المراجع أن ضحايا هذه الحرب يبلغون (35.000) جندي قُتل أكثرهم في ساعات، وخصوصًا في الممرات؛ لأن «شارون» مجرم الحرب الإسرائيلي كان يسحقهم بالدبابات في الممرات(1).
أما التدمير الذي حل بمدن القناة، فخسارته أعظم من أن تقدر! وأما التدمير النفسي والمعنوي، فحدّث ولا حرج.
هذا وقد أعلن عبد الناصر: أنه يتحمل كامل المسئولية عما وقع، ولكن هل هناك من سأله، ومن حاسبه؟
ما معنى المسئولية إذا لم يكن هناك سائل يسأل، ويحاسب ويعاقب؟!
إن الهزائم الكبرى كثيرًا ما تسقط دولًا، وتغير أنظمة، وهذا عندما تتوافر الحريات، ويملك الناس حق المساءلة والحساب.
حدثت هذه الخسائر كلها، ولكن الشعب المصري لم يكن يعرف شيئًا من ذلك، نتيجة التضليل الإعلامي، الذي استحل الكذب الصراح على الشعب، حتى بات غائبًا عما يجري على أرضه، وما يدور في ساحة وطنه.
وقد بان أثر ذلك حين فوجئ الشعب بقائد ثورته، ورئيس جمهوريته، في مساء يوم (9/6/1967م) يعلن عليهم بصوت حزين: أن مصر قد هزمت في الحرب، وأنه يتحمل كامل المسئولية، وأنه قرر التنحي عن منصبه بوصفه رئيسًا للجمهورية، وعن كل عمل سياسي، وأنه كلف زكريا محيي الدين أن يتولى مهامه.
كان بيانه يحمل نبرة الأسى والحزن والاعتذار والاستعطاف. ومثل هذه النبرة تؤثر في الشعب المصري العاطفي الطيب. فما أن انتهى من خطابه، حتى بدأت الجماهير تخرج إلى الشوارع هاتفة بحياة الرئيس المهزوم، ومنادية ببقائه على كرسيه!
وقد اختلف المحللون والمعقبون على هذا الحدث الذي سمَّاه الناصريون: هبّة الجماهير في (9) و (10) يونيو: أكانت هَبَّة عفوية أم هبة مدبرة من علي صبري وجماعة عبد الناصر في الاتحاد الاشتراكي؟
الأستاذ محمد حسنين هيكل يجزم بأنها هبّة جماهيرية تلقائية، ويدلل على ذلك بشواهد يذكرها. وآخرون من خصوم الناصرية يؤكدون: أن كل شيء كان معدًّا، وأن رجال المباحث والمخابرات وأعضاء التنظيم الطليعي في الاتحاد الاشتراكي، ومن معهم من مجموعات خاصة، كان عليهم أن يطلقوا الشرارة الأولى، ويرسلوا الصيحة الأولى، ويدعوا الجماهير الغافلة بعدها تزحف وتزعق.
وفئة ثالثة توفيقية، تريد أن تجمع بين الرأيين، وتقول: إن بعض هذا العمل كان مدبرًا، وبعضه كان تلقائيًّا، باندفاع ذاتي من الجماهير المصرية الطيبة، التي تتعاطف مع المغلوب، وتناصر المكلوم المحزون. وهكذا ظهر لهم عبد الناصر في بيانه.
بالإضافة إلى أن جمهور الشعب المصري لم يكن لديه أدنى معرفة بحجم الكارثة الهائلة، والهزيمة الساحقة والمذلة التي لحقت ببلده وجيشه. وربما لو عرف الأمر على حقيقته لكان له موقف آخر، وهو موقف الشعوب الحية حين تطالب بمعرفة من المسئول عن هذه النازلة أو القارعة؟ ولا بد أن يُسأل ويحاكم ويأخذ جزاءه أيًّا كان موقعه.
بين ناصر وعامر:
ما مدى مسئولية عبد الناصر عن هذه الكارثة؟ لقد قال في بيانه: إنه يتحمل المسئولية كاملة، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة من ناحية، ورئيس الجمهورية من ناحية أخرى.
وقال آخرون: إن المسئول عن هذه الهزيمة، هو: عبد الحكيم عامر، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الحربية شمس بدران أحد رجاله. وقال من قال: إن عبد الناصر لم يكن هو الحاكم الحقيقي لمصر، خلال تلك المدة، فقد كانت مقاليد الأمور كلها - عسكرية ومدنية - بيد المشير عامر. وأن «ناصر» أصبح «طرطورًا» يملك ولا يحكم! ومع هذا يرى أن عبد الناصر هو الذي يتحمل المسئولية؛ لأنه هو الذي مكّن عامر، وأرخى له العنان، مع أنه كان السبب الأول في ضياع الوحدة مع سوريا. وكان الأولى: أن يُحجَّم لا أن يُمكَّن.
ولقد انتهز عبد الناصر الفرصة، ليسترد سلطته المسروقة منه، وحاول أن يحمِّل عامرًا المسئولية. وأراد ناصر ألا يضيع الفرصة السانحة ليضرب ضربته، ويتخلص من صديقه القديم الذي أصبح غريمه اليوم. ووقعت وقائع لا أدخل في تفاصيلها، انتهت بأن قيل: عامر قد انتحر! وشكك في ذلك مشككون قائلين: إنه نُحِر، ولم ينتحر! ولا زال ذلك الجدل دائرًا إلى اليوم بين النحر والانتحار.
وأصبح من المشهور والمتداول إلى اليوم: أن الرجل دُس له نوع من السم السريع التأثير في كوب عصير الجوافة الذي شربه قبل أن يموت بقليل(2). ومن المعروف: أن دس السم للمعارضين وقتلهم به: أسلوب معهود ومجاز لدى الثورة ومخابراتها، كما صرح بذلك رئيس المخابرات صلاح نصر في استجواب له، أداره معه المستشار محمد عبد السلام النائب العام. ونصه:
النائب العام: أنتم عندكم سموم؟
صلاح نصر: نعم عندنا سموم.
النائب العام: في أي شيء تستعملونها؟
صلاح نصر: يعني بنستعملها في إيه؟ بنستعملها في قتل الخونة من أعداء البلاد في الداخل والخارج.
النائب العام: بأمر من تستعملونها؟
صلاح نصر: في المسائل المهمة بأمر رئيس الجمهورية، والمسائل الأقل أهمية بأمري أنا.
النائب العام: هل تتم الأوامر بإجراء شفوي أو مكتوب؟
صلاح نصر: فيه شفوي، وفيه مكتوب.
هذا الحوار العجيب كله بملف قضية المشير، ولكن هذا القدر هو ما نقله الأستاذ محمد شوكت التوني(3). ويعلق الدكتور أحمد شلبي: ولا نعرف عدد الذين قتلوا بالسم، ولا كيف ثبت جرمهم ليستحقوا هذا العقاب الذي لا تعرفه شريعة ولا قانون.
وعلى كل حال، فكل من النحر والانتحار عندنا جريمة ندينها، وكبيرة من كبائر الإثم ننكرها. وهي - أيًّا كان مرتكبها - جريمة محسوبة على نظام عبد الناصر، وثورة (23) يوليو، التي قادت البلاد إلى هذه المذلة وهذا الهوان.
من المسئول عن تجاوزات عامر وانحرافاته؟
وهنا نريد أن نسأل سؤالًا جوهريًّا، وهو: من المسئول عن تجاوزات عامر وانحرافاته الكثيرة والتي أصبحت على كل لسان، ووصلت إلى حد الفساد والطغيان؟ من الذي مكَّن لعامر، ومنحه من السلطات ما جعل مقدرات مصر العسكرية - بل والمدنية - بين أصابع يديه، يتحكم فيها كيف يشاء هو وأعوانه الذين لم يكن يختارهم على أساس القوة والأمانة، {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} (القصص:26)، بل على أساس الولاء له، والاندماج في شلته! وهو ما سبب خسارة الجيش سنة (1956م)، وضياع الوحدة السورية المصرية (1961م)، ووقوع النكبة الكبرى (1967م).
المسئول عن هذا كله - دستوريًّا وواقعيًّا - هو عبد الناصر، الذي أعطى عامرًا مسئولية أكبر منه ومن طاقاته بكثير، والتي أثبت فشله فيها، بالإضافة إلى تصرفاته القبَلية، وانحرافاته الأخلاقية التي زكمت رائحتها الأنوف في أنحاء مصر. وجعلت الناس يشكون إلى جمال من سوء أعمال صاحبه، ولكنه ظل يحميه إلى آخر الأيام.
يقول الكاتب المعروف الأستاذ أحمد أبو الفتح: «إن تعيين عبد الحكيم عامر «قائدًا عامًّا» نسف تقليدًا عسكريًّا هو احترام الأقدميات، وكان لهذا التعيين أعمق الآثار على النظام، ليس في الجيش وحده، بل في كل أجهزة الدولة»(4).
ومع ما مني به عامر وجيشه من هزيمة (1956م) - التي حُوِّلَتْ كذبًا إلى نصر يحتفل به كل عام! - توالت عليه الألقاب والرتب - كما يقول السادات - فعين قائدًا عامًّا للجيش السوري والمصري خلال الوحدة، ورُقّي إلى رتبة «مشير» وخلع عليه عبد الناصر لقب «نائب رئيس الجمهورية»، ثم أصبح بعد ذلك «النائب الأول لرئيس الجمهورية»(5).
يقول الرئيس أنور السادات: «كان لعبد الحكيم عامر أخطاؤه بطبيعة الحال، ولكن الأهم من ذلك أنه كان يسيء اختيار معاونيه بشكل فاضح، وكان من أبرز ملامح شخصيته روح القبيلة، فهو يساند معاونيه بالحق أو الباطل». ويقول أيضًا: عقب الانفصال قلنا لعبد الناصر: إن عزل عبد الحكيم عامر كان يجب أن يتم سنة (1956م)، لا في (1961م) فقط؛ لأنه لا يصلح من ناحية العمل العسكري(6).
ويقول محمد حسنين هيكل: إن عبد الحكيم عامر كان نصف فنان، ونصف بوهيمي، ولطيفًا جدًّا، ولكنه من الناحية العسكرية توقف عند رتبة صاغ، أي أنه يستطيع أن يقود كتيبة، لكنه لا يستطيع أن يقود جيشًا. لقد أصبح عبد الحكيم عامر ضابطًا سياسيًّا، ولكن الضابط السياسي لا يمكن أن يكون مسئولًا عن الجيش(7).
ويورد الضابط أحمد حمروش مجموعة من الصفات الدقيقة لعبد الحكيم عامر، فيقول: أحاط المشير نفسه بحاشية سرعان ما عرفت فيه أسوأ الصفات، فتمادت في سلوكها اللاأخلاقي، واستغلت أموال الدولة أسوأ استغلال. وكان الذين يقتربون من رجال مكتبه - الذين يقودهم الصاغ عليّ شفيق - تأخذهم الدهشة من الجموح الكاشف، في مجال اللهو والبذخ المبالغ فيه، الأمر الذي أثر تأثيرًا شديدًا على قمة القيادة العسكرية، وانعكس على بقية مستويات الضباط.
ويستطرد حمروش قائلًا: كانت المتعة الشخصية هي الفلك الذي يعيش فيه عامر، وأصبح ذلك معروفًا ومتداولًا، وكانت هذه المتعة تشمل: تدخين الحشيش، والاتصال ببعض الفنانات، والبذخ، الذي وصل إلى حد السفه. ونتيجة لعلاقة الضباط بالفنانات؛ تزوج المشير من برلنتي عبد الحميد، وعلي شفيق من مها صبري، وعبد المنعم أبو زيد من سهير فخري(8).
وكانت هناك عصابات في مكتب المشير تشتغل بالتهريب، وبخاصة في الأجهزة والآلات والدخان التي كانت تُستورد من اليمن، وكانت تلك العصابة بقيادة الصاغ عبد المنعم أبو زيد، وقد أدانتهم المحكمة العسكرية(9). فكيف سمح عبد الناصر لنفسه أن يحمي رجلًا مثل هذا ويسانده، ويجعله الرجل الثاني في الدولة، بل وصل إلى أن أصبح الرجل الأول الحقيقي في الدولة؟
إن كل ما يُنسب إلى عامر من فساد وانحراف وطغيان وعبث بالجيش وبالوطن؛ إنما المسئول الأول عنه هو عبد الناصر، فلولا سكوت عبد الناصر ما كان طغيان عامر!!

نكسة أم نكبة؟
لقد سمى ناصر وإعلامه هذه الهزيمة المذلة، التي خسرنا فيها القدس، والضفة الغربية، وغزة، وسينا، والجولان: «النكسة»! كأنهم كانوا في انتصار دائم، ثم انتكسوا هذه المرة!
والواقع أن هذه تسمية خاطئة، وإنما هي «نكبة كبرى» توازي «النكبة الأولى» سنة (1948م)، التي قامت فيها دولة بني صهيون، وشرد الفلسطينيون من ديارهم، وغُرس هذا الكيان المعتدي في قلب بلاد العروبة والإسلام؛ ليكون خنجرًا مسمومًا في صدورهم.
ولذا سميتها: «النكبة الثانية» أي بعد نكبة (1948م) في كتابي: «درس النكبة الثانية: لماذا انهزمنا؟ وكيف ننتصر؟» الذي أصدرته في سنة (1968م)، أناقش فيه أسباب النكبة الحقيقية، وطريق النصر الذي يجب أن نسلكه.
بل أقول: إن أثر هذه النكبة كان أعظم خطرًا من النكبة الأولى. فقد ظل العرب - بعد النكبة الأولى - متمسكين بأن فلسطين كلها من النهر إلى البحر: وطنهم المغتصب، وبلدهم المسلوب، وحقهم فيه ثابت لا مراء فيه، وأنهم سيظلون يجاهدون بكل ما لديهم من قوة، لطرد العدو الغاصب، واسترداد الوطن الضائع، وإن طال عليهم الأمد، فإن مُضِيَّ الزمن لا يسقط الحقوق الثابتة، ولا يبطل حق المواطنين في المطالبة بوطنهم المغصوب.
هكذا كان العرب جميعًا في مشارقهم ومغاربهم، ثوريهم وليبراليوهم، حتى وقعت هذه النكبة، فتغيرت فلسفة العرب، وتغيرت سياستهم، وتغير منطقهم، وتبنى عبد الناصر بعد ذلك سياسة «إزالة آثار العدوان»، يعني بذلك: عدوان (1967م)، وإعادة الأوضاع إلى ما كان عليه الحال قبل (5) يونيو (1967م).
ومعنى هذا: أن العدوان الجديد ألغى العدوان القديم، بل أضفى الشرعية عليه، أي عدوان (1967م) أضفى الشرعية على عدوان (1948م)!!
فما أعظم الهول! وما أعظم الفارق بين موقف العرب قبل هذه النكبة المخزية، وبعد هذه النكبة المهينة!
موقف عموم الناس من الهزيمة:
وكان من أعقد المواقف، وأصعب المشكلات: موقف كثير من المواطنين من هذه الهزيمة المنكرة، فقد رأينا بعضهم فرح بهذه الهزيمة - برغم مرارتها وقسوتها على النفس - لأنهم وجدوا فيها باب خلاص لما كانوا يعانونه من ظلم الحكام، وحكم الظُّلام، ومن تسلط الطغاة على الشعب حتى قهروه ومرغوا أنفه في التراب.
وحسبك أنهم أركبوا الشيوعيين ظهور الناس، ومكنوهم من ناصية الإعلام والثقافة والتوجيه في البلد، وأنهم أذلوا علماء الدين والدعاة إلى الله، ويكفي مذبحة (1965م)، وشنق سيد قطب وإخوانه، وسوق عشرات الألوف إلى السجون بغير جرم اقترفوه.
وقف الناس من هذه الهزيمة مواقف شتى. فبعضهم عَدَّها منحة من الله تعالى، ليرجع الناس إلى ربهم، ويعتصموا بحبله، ويعرفوا أنه وحده الناصر، بعد طغيان الثقافة المادية اللادينية، التي أنست الناس الله، فأنساهم أنفسهم.
رأى بعضهم في هذه الهزيمة أو النكسة درءًا لفتنة عارمة، كادت تخلع الناس من إيمانهم، وتفسد عليهم دينهم، حين استسلموا للطاغوت، وأعرضوا عن الله.
كان الداعية الكبير، والمفسر الشهير: الشيخ محمد متولي الشعراوي من هؤلاء، الذي نشرت عنه الصحف: أنه سجد لله شكرًا، عندما وقعت الهزيمة!
ولم يكن ذلك؛ لأنه يؤيد الصهيونية، ويكره وطنه مصر، أو يتمنى له الخذلان، ولكن يبدو أنه رأى الهزيمة المؤقتة - لإيقاذ الأمة وردّها إلى دينها ومرجعيتها وأصولها - خير من نصر كاذب يؤدي في النهاية إلى دمار الأمة وهلاكها؛ فرأى الشيخ في هذه المصيبة نعمة من وجهة أخرى. وهي إذلال الطاغية المفتون بسلطانه، المغرور بقوته، الذي أصبح صنمًا معبودًا لدى الكثيرين. فعرفته هذه الهزيمة قدره، وألزمته حده، فوقف عنده.
رأى الشيخ الشعراوي أن تحرير الشعب من الفتنة بالطاغوت: أهم من نصر سريع يتحقق في معركة، ثم تعقبه مآس لا تنتهي، وويلات تجر ويلات إلى ما شاء الله.
وهذا الكلام الصريح من الشيخ الشعراوي: هيج عليه أعشاش «الدبابير»، فهاجمته الأقلام المبهورة، والأقلام المأمورة، والأقلام المأجورة. وإن كان الشيخ لم يقل هذا إلا بعد وفاة عبد الناصر، وبعد حرب العاشر من رمضان، وفي فترة حكم السادات.
على أن الشيخ الشعراوي لم يكن شاذًّا من بين الناس، فقد كان هذا موقف الكثيرين ممن عانوا ظلم عبد الناصر وزبانيته، وشربوا من كئوسهم المرة ما شربوا، فعدُّوا هذه الهزيمة ضربة قاصمة لهم، تذلهم كما أذلوا عباد الله، وتقهرهم كما قهروا المستضعفين.
وكم كانت فرحة المسجونين والمعتقلين الذين عذبهم شمس بدران ورجاله، حينما رأوهم يساقون إلى السجن، ويدخلون الزنازين بجوارهم، غير أنهم كانوا يبكون بكاء الأطفال، ويستجدون العطف استجداء الأنذال، على حين استقبل الإخوان محنتهم استقبال الرجال، وصبروا على الأذى صبر الأبطال، فسبحان مغير الأحوال!
إن شر ما تصاب به الأوطان والمجتمعات: أن تتسع الفجوة، ويتعمق الانفصال بين الشعوب وحكامها، وأن يشتد الضغط والقهر على الجماهير، حتى تتمنى الخلاص منهم، ولو على يد أعداء الوطن!
وهذا ما رأيناه أخيرًا عند بعض الفئات من أبناء الشعب العراقي، الذين رحبوا - للأسف - بالغزو الأمريكي للعراق، من أجل الخلاص من جبروت صدام وطغيانه، والتحرر من نير هذا الحكم الداعر الفاجر القاهر، الذي أفسد البلاد، وأذل العباد، وسفك الدماء، وانتهك الحرمات، ولم يرقب في مؤمن إلّا ولا ذمة.
أنا لا أؤيد هذا الموقف، ولا أبرره، ولا أرى أن يستبدل الناس بالوطني الفاجر: المحتل الكافر، إذ لا يستبدل شر بشر، ولا ظلم بظلم، فكيف نستبدل شرًّا بما هو أشر، وظلمًا بما هو أظلم؟ ولكني أحاول أن أفسر وأعلل ما وقع.
ربما كانت حجة بعض الناس أو عذرهم: أن الظلم الجديد ظلم عارض ولن يستمر، بخلاف الظلم القديم، فهو ظلم طال عمره، ورسخت أقدامه، وأمسى من المتعذر - بل ربما من المستحيل - اقتلاعه من جذوره، التي امتدت بطول الزمان في أغوار الأرض. وهذا المنطق غير مسلّم مع إطلاقه، فقد يصبح الظلم الجديد، أكثر توغلًا، وأشد خطرًا!
ومهما يكن من التعليلات والتبريرات، فإن من المصائب الكبيرة في الأمة: أن توجد فيها هذه الظاهرة المؤسفة: الترحيب بهزيمة الوطن سبيلًا للخلاص من جبروت الطاغين، وطغيان الجبارين، والترحيب بحكم المحتل - ولو إلى حين - بديلًا لحكم وطني غشوم ظلوم، كثرت جرائمه، وتتابعت مظالمه، واتسعت بطول الأيام ويلاته ومآثمه.
ولقد ذكرت هذا المعنى - انفصال الشعوب عن الحكام - في كتابي: «درس النكبة الثانية: لماذا انهزمنا؟ وكيف ننتصر؟» فكان مما قلته: «فقد أصبح الحكام في واد والشعوب العربية المسلمة في واد، فالحكام يؤمنون بمذاهب وضعية، وفلسفات علمانية، ويحكمون بقوانين أجنبية عن شريعة الله، وهي شريعة الأمة. أما جماهير الشعوب فما زالت مؤمنة بربها ودينها وقرآنها، ومحمدها. وأن كل شر وخسران في الانحراف عن صراط الله، وعن هدي رسول الله.
والحكام مشغولون بتوطيد سلطانهم، وتثبيت كراسي حكمهم، باضطهاد كل فرد أو جماعة أو حركة تعارضهم، أو تحاسبهم، أو تقول لهم: لِمَ؟ وكيف؟ فضلًا عن أن تقول: لا. ومن تجرأ وقال: «لا» فمآله السجن أو النفي أو حبل المشنقة. والشعوب مشغولة بهَمِّ لقمة العيش، وطلب الحرية والأمن، فإن الأنظمة التي تحكمهم لم تطعمهم من جوع، ولم تؤمنهم من خوف.
فلما سمعت جماهير هذه الشعوب أن هؤلاء الحكام سيحاربون: لم تصدق عقولهم ما سمعته آذانهم، فقد عرفوا بفطرتهم وتجربتهم: أن هؤلاء الحكام لا يعنيهم حرب اليهود بقدر ما يعنيهم القضاء على المعارضين للحكم. ولما بدأ اليهود بالضرب، وتورط هؤلاء في الحرب، كانت ضمائر هذه الشعوب في حيرة، وألسنتها تتلعثم في الدعاء لهم بالنصر والتمكين. فقد ذاقت على أيديهم من المظالم ما جعلها تخاف من انتصارهم مثل ما تكره من هزيمتهم. ولقد قال وكيل الأزهر «د. محمد عبد الله ماضي» في مؤتمر علماء المسلمين الذي انعقد في رجب الماضي (1388هـ) في كلمته نيابة عن الأزهر: «إننا لو انتصرنا - على ما كان بنا من عيوب وانحراف - لازددنا جرأة على محارم الله».
وهذا هو الشعور الذي كان يسود جماهيرنا المسلمة، قبيل وفي أثناء الحرب. وكفى بهذه الحال تعبيرًا عن الفجوة الفسيحة، والهوة العميقة، التي حفرها هؤلاء الحكام بينهم وبين جماهير شعوبهم. وصدق الشاعر:
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيًا ** وحسب المنايا أن يكن أمانيا!!(10)
تحليل لأسباب النكبة:
وقوع هذه النكبة الكبرى مجالًا رحبًا لتحليلات المحللين لأسبابها وعواملها، وقد رأينا في ذلك شطحات وعجائب من التحليلات ينبغي أن نرصد أهمها هنا.
الدين هو السبب:
وأعجب ما قرأنا في تعليل الهزيمة: أن سببها هو الدين! نعم، الدين!!
هكذا كتب الأديب المهجري المعروف «ميخائيل نعيمة» في استفتاء أجرته مجلة «الآداب» البيروتية بعد نكبة حزيران، وسكتت عليه المجلة سكوت المقر المؤيد.
قالت المجلة: ما هو في رأيكم الدرس الأكبر الذي يحسن بالعرب أن يتعلموه من الهزيمة؟
وقال الكاتب الشاعر: «في رأيي أن الدرس الأكبر الذي يجب أن يتعلمه العرب من هزيمتهم النكراء: أن الدنيا لا تُساس بالدين! فالدين موطنه السماء التي لا يعرفها أحد، والدنيا موطنها الأرض التي لا يجهلها أحد...».
إلى أن قال: «فإذا كان العرب ممن يعتقدون أن حقوقهم لا تُصان ولا تسترد إلا بالحرب، وأن الحرب لا يكسبها إلا السلاح، وأن السلاح لا يخلقه إلا العلم والمال، فما عليهم إلا أن يتعبدوا للعلم والمال: لعل العلم والمال لا يخذلهم حيث خذلهم ربهم»(11)!!
وهذه الكلمات إنما هي خيال شاعر، لا فكرة حكيم. وهو مع هذا خيال متهافت سقيم. والخطورة - كما قال الأستاذ محمد المبارك(12)- أن يُظن كل أديب كبير، مفكرًا كبيرًا! وليس الأمر كذلك. إن الشاعر الذي يعيش هناك وراء البحار، يظن العرب هنا يقيمون في زوايا العبادة، بين ليل قائم، ونهار صائم، ناءت رءوسهم بحمل العمائم، وأيديهم بحمل المسابح. فلما شبّت نار الحرب دخلوها، وسلاحهم التمائم والتعاويذ.
وهذا الخيال كله باطل، فالحكومات التي اشتركت في الحرب حكومات عصرية، تعتمد على أحدث الأساليب، في الأسلحة والتدريب، وهي كلها حكومات علمانية تفصل الدين عن الدولة، إن لم يقم بعضها بالفعل باضطهاد الدين والتضييق عليه، وعلى دعاته، وقد كان الدعاة إلى الدين - عندما حلت النكبة - في سجونها ومعتقلاتها بالألوف وعشرات الألوف.
ولو أن الشاعر المهَجريّ قال: «إن سبب النكبة هو التدين المدخول أو الزائف» لكان له وجه.
ولقد كان الشاعر نزار قباني الذي لم يُعرف باتجاه روحي - كميخائيل نعيمة - أدنى إلى السداد في تعقيبه على النكبة بقصيدته الشهيرة: «هوامش على دفتر النكسة» فقد جاء فيها:
لا تلعنوا السماء إذا تخلت عنكم، لا تلعنوا الظروفْ
فالله يؤتي النصر من يشاء... وليس حدادًا لديكم يصنع السيوفْ.
وصوَّر الفراغ الروحي والأخلاقي للأمة، فقال:
جلودنا ميّتة الإحساسِ.
أرواحنا تشكو من الإفلاسِ.
أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس.
هل نحن خير أمة قد أخرجت للناس؟!
والجواب بداهة: لا. فالله قد خاطب هذه الأمة بقوله: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران: 110)، فأين منا هذه الخصائص والنعوت؟
ويصف «نزار» التدين الكاذب المنحرف فيقول:
نقعد في الجوامع.
تنابلًا كُسالى.
نشطِّر الأبيات أو نؤلف الأمثالا.
ونشحذ النصر على عدونا ... من عنده تعالى!
وعلى أي حال، قد كان الدين معزولًا - تمامًا - عن المعركة، ولم يكن له فيها دور إيجابي ولا سلبي. لا قبل المعركة ولا في أثناء المعركة. كان هناك حرص شديد من أكثر المسئولين على إبعاد العنصر الديني عن الحرب؛ لأسباب واعتبارات لا محل لها هنا.
بل الذي يذكره الشعب العربي - قبل المعركة بأيام - أن الدين كان عرضة للهجوم والسخرية والقذف بالحصى والحجارة، حتى اجترأ مجترئ من الثوريين، أن يكتب في صحيفة علنية رسمية -تصدر في سوريا- هذه العبارات: « ... والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي، هي: خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد، الذي يؤمن أن الله والأديان والإقطاع والرأسمال والاستعمار والمتخمين وكل القيم - التي سادت المجتمع السابق - ليست إلا دُمى محنطة في متاحف التاريخ»(13)!!
ولقد ذكرت ما شهدته بنفسي في قطر في الساعات الأولى؛ اجتماعًا في مقر «منظمة التحرير» ضم المئات، بل الألوف من الناس من الفلسطينيين والقطريين والمصريين وغيرهم، ووقف رجل عالم فاضل من أهل البلاد يخطب في هذا الجمع، وكان مما دعا إليه في كلمته: أن ارجعوا إلى الله وتمسكوا بدينه ينصركم على عدوكم... فما كان من بعض الشباب المفتونين بعبادة الأوثان البشرية إلا أن قالوا: لا دين إلا السلاح؟
هذه هي الروح التي كانت سائدة هنا وهناك. فكيف يزعم زاعم أن الدين سبب الهزيمة؟!! وأن علينا أن نتخلى عن الدين لننتزع النصر من أحشاء الهزيمة؟
ثم أي دين يعنيه الكاتب؟ إنه لا شك يعني الدين على وجه العموم، والإسلام على وجه الخصوص. فهو الدين الذي تعتنقه أغلبية الأمة، وتنص دساتير دولها على أنه دين الدولة الرسمي. فهل يمكن أن يكون الإسلام سبب الهزيمة، أي هزيمة؟ كلا.
وكيف يكون ذلك؟ وهو الذي يقول في كتابه: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ} (الأنفال:60)، ويقول: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً} (النساء: 102)، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا} (النساء:71).
بل أقول: إن التحليل الدقيق والعميق لأسباب الهزيمة يقول بصراحة: إن سببها الحقيقي يكمن في تخلّينا عن حقيقة الدين، عن الإسلام الصحيح، الإسلام الحق الذي يعد الأمة للجهاد، ويطهر الأمة من الميوعة والتحلل وأسباب الخذلان.
لقد كان لتخلينا عن الإسلام - مصدر قوتنا ومددنا الروحي والنفسي - نتائج كثيرة لمسنا آثارها، حين دخلنا المعركة دون أن نتسلح بالإيمان، لمواجهة أمة تحاربنا باسم الدين.
دخلنا المعركة والغرور حشو رءوسنا، والرياء ملء نفوسنا، والكبر ملء أنوفنا. لم ندخلها في تواضع المؤمنين، وزهد المخلصين، وصدق التائبين، وتوبة الصادقين.
لم يقل قائد لزملائه أو لجنوده يوم الحرب ما قاله خالد يوم «اليرموك»: إن هذا اليوم من أيام الله، فلا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، فأخلصوا لله جهادكم، وتوجهوا لله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده.
وهكذا خضنا الحرب بلا عقيدة، وقاتلنا بلا إيمان... خضناها متوكلين على الروس، فخذلنا الروس، معتمدين على السلاح فلم ينفعنا السلاح.
الحق: أن هؤلاء الثوريين الاشتراكيين - إن افترضنا إخلاصهم - لم يفهموا أمتهم، ولم يعرفوا حقيقتها... كما أنهم لم يعرفوا عدوهم الذي يتحدى بقلته كثرتهم، وبرقعته الضيقة أقطارهم الواسعة!
لقد ادعوا أن إسرائيل مجرد دولة عنصرية، وأن الصهيونية حركة قومية سياسية فحسب، وأغفلوا الجانب الديني في قيام الصهيونية وفي تكوين إسرائيل، كما أغفلوا هذا العامل الديني في توجيه شعوبهم وجيوشهم، على حين عنيت به إسرائيل كل العناية، فربحت وخسروا، وانتصرت وانهزموا.
كتب بن جوريون في رسالته إلى الرئيس ديجول في مطلع عام (1968م) يقول: «إن سر بقائنا بعد التدمير البابلي والروماني، وحقد المسيحيين الذين أحاطوا بنا ألف عام؛ يكمن في صلاتنا الروحية بالكتاب المقدس! وعندما جاءت اللجنة الملكية البريطانية إلى القدس في آخر سنة (1936م) لتدريس مستقبل الانتداب قلت لها: الانتداب الخاص بنا هو التوراة! لقد استخرجنا منه قوتنا؛ لنقاوم عالمًا عاديًا، ولنستمر في الإيمان بعودتنا إلى بلادنا»(14).
وفي الصفحات الأخيرة من مذكرات «وايزمان» ما يُعَدّ وصية وتوجيهًا عامًّا لإسرائيل: «هدفنا هو بناء حضارة تقوم على المثل الصارمة للآداب اليهودية. عن تلك المثل يجب ألا نحيد، كما فعلت بعض العناصر في حياة الوطن القومي القصيرة، بإحناء الركب أمام آلهة غرباء. لقد كان الأنبياء دائمًا يؤنبون الشعب اليهودي بأشد القسوة من أجل هذه النزعة. وكلما عاد الشعب إلى الوثنية وكلما ارتد: كان يعاقب من قبل إله إسرائيل الشديد. وإنه من الصعب القول فيما إذا كان سيظهر أنبياء بين اليهود في المستقبل القريب. ولكنهم إذا اختاروا الحياة الصادقة الصعبة النقية على الأرض في منازل مبنية على المبادئ القديمة، وإذا استهدفوا في نشاطهم قيمًا حقيقية، في الصناعة والزراعة والعلم والأدب والفن، عندها يطل الله بعطف على أبنائه الذين عادوا بعد تيهٍ طويل إلى بيتهم ليخدموه، وعلى شفاههم مزمور، وفي أيديهم مجرفة، محيين بلادهم القديمة، وجاعليها مركز حضارة إنسانية».
هذا هو اتجاه إسرائيل، وصنّاع أمجادها وانتصاراتها. أما في أرض الثورية العربية، فكل دعوة إلى الإسلام «رجعية» وكل ذي فكر وقلم يدعو إلى الإسلام الصحيح يجب أن يكون مصيره حبل المشنقة، أو زنزانة السجن، أو العزلة الخانقة تحت الإقامة الجبرية!
يقول الكاتب المسيحي السوري الدكتور أديب نصُّور: «استطاعت إسرائيل أن تعبئ لمصلحتها العاطفة الدينية عند اليهود في العالم، وتتلقى منهم العون والمزيد من العون، بينما كانت السياسة العربية الثورية تعادي الدولة الإسلامية غير العربية، وتخاصم الدولة الإسلامية العربية، وتصمها بالرجعية والتخلف لتمسكها بالدين، وتعتبر كل تقارب بين المسلمين تحالفًا استعماريًّا، وتهمل الجانب المسيحي في العالم العربي، وتجرد إنسانها الثوري من قوة روحية هائلة، وتجرد سياستها الخارجية من بُعْد هو الأساس من أبعادها.
إن الخطر الأكبر لم يداهمنا من انقضاض طيران العدو، وغزو ألويته ودباباته، وإنما جاء من انهيار داخلي سبق المعركة بأعوام، ومن محاولة الانتحار الأدبي. والتخلي عن الحقيقة والفضائل والقيم قضى على أمم كثيرة من قبل في التاريخ. إن ما حدث داخل المجتمعات الثورية كان وحده سببًا كافيًا ليجلب لنا الدمار الروحي، والدمار المادي جميعًا»(15).
.....
(1) محمد شوكت التوني: «قضية التعذيب الكبرى» (ص: 70).
(2) نشر خبير السموم الدكتور عليّ محمد دياب، في صحيفة «أخبار اليوم» في (27 / 9 / 1975م): أن المشير لم ينتحر، وإنما دُس له سم «لاكونتثن» في كوب عصير الجوافة الذي قدم إليه.
(3) انظر: «قضية التعذيب الكبرى» (ص: 37، 38)، وانظر: «موسوعة التاريخ الإسلامي» (9/754).
(4) «التحدي» (ص: 252).
(5) «البحث عن الذات» (ص: 404، 405).
(6) «البحث عن الذات» (ص: 305 و307).
(7) «بصراحة عن جمال عبد الناصر» (ص: 101).
(8) «مجتمع عبد الناصر» (233).
(9) نفسه. وانظر: «موسوعة التاريخ الإسلامي» لأحمد شلبي (9 / 184 - 191).
(10) «درس النكبة الثانية» (ص: 38، 39)، نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.
(11) مجلة «الآداب» - عدد تموز «يوليو» (1967م).
(12) في كتابه: «جذور الأزمة في المجتمع العربي».
(13) من مقال المدعو: «إبراهيم خلاص» في مجلة «جيش الشعب» السورية.
(14) «جريدة لوموند الفرنسية» (10 / 1 / 1968م).
(15) انظر: «النكسة والخطأ» لأديب نصّور (ص: 159)، وراجع كتابنا: «الحلول المستوردة، وكيف جنت على أمتنا؟» فصل: «لماذا فشلوا في حرب فلسطين؟» (ص: 307 - 315).



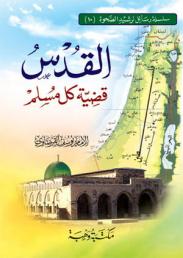 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد
فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟
كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟ 






